-
بين بازوليني وبيسوا: في السلطة فقط تَكمُن الفوضويّة الحقيقيّة


“أيّها السادة، نحنُ الفاشيّون، الفوضويّون الحقيقيّون الوحيدون!”
قد يبدو التناقُض صَارِخًا في الاقتباس أعلاه، والذي جاء على لسان “الدوق” أحد الفاشيين الأربعة في فيلم الإيطالي بيير باولو بازوليني “سالو أو أيام سادوم المائة والعشرون” (1975)؛ فالفوضوي/اللاسُلطَوي، وكما يَفترِض الاسم بداهةً: هو مُعادٍ للسُلطة أيًا كانَ شكلُها ورافضٌ لأيّ أيديولوجيا تُنتِجها أو تُعيد إنتاجها على هيئة أنساقٍ تَزعُم أنّها تَحرّرية، تُمكّن الإنسان من استعباد جموع البشر تحت مظلّة راياتٍ ثورية وشعاراتٍ برّاقة تَعِدُ الناس بغدٍ أجمل (بِصدَد هذه الجزئية يُمكن مراجعة كتابي “الإله والدولة” و”السلطة والحرية” للفوضوي الروسي ميخائيل باكونين).
لكن، ماذا لو كانت روح الفوضويّة الحقّة مُتمثّلةً في السلطة؟ في أن تكون أنتَ في موقعها وعلى رأسها ومُمسكًا بزمام قوّتها، ولا سُلطان لأحدٍ عليك إلّا أنت، وتفعل ما تُريد وما يحلو لك. وفي هذه الحريّة المطلقة لفعل كل المُمكِن، يَتمظهَر التَحقُّق المثالي للفوضويّة؛ فأنتَ لاسُلطوي تَرفُض سُلطة أيّ أحد/كيان/فكرة عليك! وبعد هذا الإقرار والتصالُح مع الذات، تُمارِس تَسلُّطك على الآخرين وتفعل بهم ما تشاء وتلهو بحياواتهم وتُعَربِد بأجسادهم وتُقامِر بأوراحهم كما يحلو لك!
من كان شاهدًا على عشاء بازوليني الأخير، الذي أُقيم في صالات الجمهورية الإيطالية الدُمية المتحكّم بها من قبل ألمانيا النازية “سالو”، سيفهم تمامًا مقصد الدوق -الذي يُكمِل مُؤكّدًا “أنّ الفوضويّة الحقيقية الوحيدة تكمن في امتلاك السُلطة”- وسيرى بعينيه الممارسة العمليّة لهذا التنظير على يد الدوق ورفاقه “الفوضويين الحقيقيين” الذين يُكثرون من التَفلسُف واقتباس فلاسفة وشعراء من طراز نيتشه وبودلير، أثناء ممارستهم أنشطة عنف وإذلال وإهانة وخلاعة وعربدة على طريقة الماركيز دو ساد، على مجموعةٍ من لحمٍ بشري خاضِع يختبرون بواسطته لا محدوديّة هذه اللاسُلطويّة على الذات – السُلطويّة على الآخر.
أنْ يكونَ المرء في السلطة -وبالتالي وبالضرورة سُلطويًا- يعني أنّ الحرية المُطلقة التي يطمح الفوضويون إليها هي الآن ملك يديه، مُمثلّةً بحريّة أن يستبدّ وهو المُعادي الحقيقي والوحيد لاستبداد السُلطة. وإن فشلت كثيرٌ من التجارب الفوضويّة، أو بقي معظمها عالقًا في عالم المُثُل، فتجربة “فوضوية السلطة” -التعبير لبازوليني نفسه- تنجح دوماً، وينطلق السُلطوي ذلك الفوضوي الحقيقي بفكره ونظرياته بسرعةٍ صاروخيةٍ من أرض الأفكار والمُثاليات إلى فضاء العالم المادي، صَوبَ الواقع الذي كل شيء فيه مُمكِن، حيث لا سيّد إلّا السُلطوي، والكل عبيدٌ له.
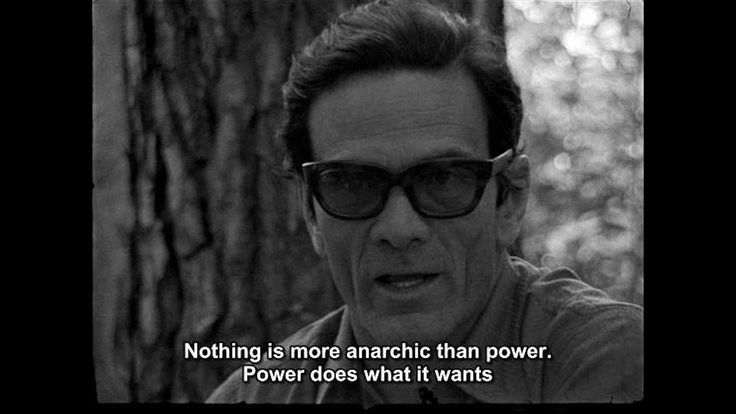
بيير باولو بازوليني، من الفيلم الوثائقي “بازوليني جارنا” (2006) مصرفي.. وفوضوي؟!
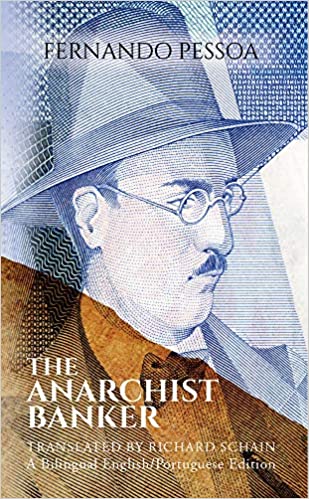
قصّة المصرفي الفوضوي – فرناندو بيسوا لنقطع هُنا تذكرة سفر، حاملين معنا شيئًا واحدًا هو الفوضويّة. ولننطلق من إيطاليا بازوليني إلى برتغال فرناندو بيسوا، لنؤدّي زيارةً خاطفةً إلى إحدى وجهاته القصصيَّة القصيرة: “المصرفي الفوضوي”. يُلاحَظ للوهلة الأولى ومن العنوان مَعلمٌ بارزٌ: التناقض الصارخ -كما في عبارة دوق بازوليني- لكنه (إنذار بحرق الأحداث!) ليس تناقضًا بالفعل، فهناك فوضويات/أناركيات كثيرة، إحداها الفوضويّة الرأسمالية Anarcho-Capitalism، التي يمكن للمرء في ظلّها أن يكون مصرفيًا وفوضويًا دون أيّ تَعارُض.

عَلمُ اللاسُلطويّة الرأسمالية القصّة التي هي عبارة عن حوارٍ بين شخصين أحدهما فوضوي ووظيفته مصرفي، لا تتناول سلطة الدولة أو السلطة السياسية، بل سلطة المال وأيضًا سلطة الفرد/الأنا. وبناءً على ذلك يمكن القول أنّها حمّالةٌ لمضامين فوضوية رأسمالية، وأُخرى فوضوية أنانية تتمثّلُ في شخصية المصرفي الذي يَنعتُ الدولة والعائلة والدين والمال بـ“الأوهام الاجتماعية”. وهُنا يبدو وكأنّ بيسوا متأثّرٌ بالفوضوي الأناني الألماني ماكس شتيرنر أو يحيلنا إلى فلسفته التي ترفض كل هذه المؤسسات؛ حيث يصفها شتيرنر في عمله “الأنا وملكيّتها” بـ”الأشباح” (Spooks) التي تتطايَر أمام سُلطة الأنانية. لكن شتيرنر لا يكتفي بالمؤسّسات التي ذُكِرَت في قصة بيسوا؛ فلائحته للأشباح تتضمّن: الأخلاق، الخير العام، القانون، المجتمع، الحب، الحقوق الطبيعية، الحقيقة والإله نفسه… وتطول قائمة الكيانات الشبحيّة التي يرفض منظّر الفوضويّة الأنانيّة نفوذها على الإنسان.
من سياق القصّة والحديث المطوّل لذلك المصرفي الذي كان فوضويًا -وما زال- أثناء تدخينه السيجار، نفهم أنّه كان فوضويًا جماعيًا/اجتماعيًا قبل أن ينتابُه الكفر، فيرتدّ إلى فوضويٍ فردي وأناني، رافض للاستبداد الجديد، الذي يُدمّر استبداد الأوهام الاجتماعية أو الأشباح -بتعبير شتيرنر- ليؤسس محلّه استبدادًا اجتماعيًا أكثر رداءة، أو استبداد المعاونة -كما يسمّيه المصرفي- ويُؤمن بأنّ الطريقة الفوضويّة الوحيدة هي أن يحرّر المرء نفسه، ويؤدّي واجبه نحو نفسه والحريّة في آنٍ واحد، ولكن كيف؟

ماكس شتيرنر هذا الفوضوي الفردي/الأناني، وجدَ طريقةً لمحاربة أشرس الأوهام الاجتماعية وأعظم السلطات: سلطة المال، بأن يحصل على المال! ولا يكتفي بذلك، فيحصل عليه بكميات كافية لكي لا يشعر بتأثيره، وكلّما زادت الكميات التي سَيجنيها كلما كان تحرُّره من تأثير سلطة المال أكثر. ليدخل فيما بعد في “فوضويّته التجارية والبنكية” وهُنا تتشكّل فوضويةٌ أُخرى هي الفوضويّة الرأسمالية.
وليس هذا المصرفي بعيدًا كثيرًا عن فوضويي بازوليني الفاشيين؛ فهو الفوضوي الحقيقي الوحيد وسط فوضويي عصره، الذين لا يتحرّرون أبدًا وهم يقاتلون الرأسماليين عوضًا عن الذهاب مباشرةً إلى رأس الأفعى وقتال رأس المال، بل يَخلقون بتعاونهم واشتراكيتهم وعنفهم “الغبي” -كما يصفه- استبداداتٍ جديدة أشدّ عنفًا من تلك القائمة ويصبحون خاضعين لسلطتها. أمّا هو فعثرَ على الفوضويّة الحقّة في سلطة المال وسُلطويّة رأس المال. تلك السلطة لا تُحارَب بالهروب منها أو السمو عليها، بل بامتلاكها وبإرادة المزيد منه، لينعم الفوضوي الحقيقي بحريةٍ لا تعرف حدودًا، بحرية السوق الحرّة! وليفعل ما يحلو له وقد أخضع وهم المال.. بالاغتناء (ألا يُذكّر هذا الكلام بشخصية مستطاع الطعزي في فيلم البيضة والحجر 1990؟) ولنقُم بإعادة صياغة جملة دوق “سالو” لكن على لسان هذا المصرفي: نحنُ الرأسماليون، الفوضويون الوحيدون الحقيقيون.
تبدو قصّة “المصرفي البنكي” بيانًا مُؤازرًا للأنساق الفوضويّة الفردية/الأنانية وتلك الرأسمالية، أكثر من كونها قصّةً بالمعنى التقليدي؛ حيث تتجلّى فيها السخرية من مُثُل الفوضويين الذين يعملون بشكلٍ تعاوني من أجل المجتمع ويهمّهم الخير العام. ويُنهي بيسوا بيانه المظفّر حول فوضوية سُلطة المال المُتنكّر بزيّ قصة، بعبارةٍ على لسان المصرفي:
“إنهم فوضويون نظريون، وأنا فوضوي على مستوى النظرية والممارسة. هم فوضويون مثاليون وأنا علميّ.. باختصار إنهم فوضويون مزيّفون وأنا الفوضوي الحقيقي.”
إن استحضار موضوع فوضوية السلطة، أمرٌ راهن مع تواصل صعود “الفاشيين” على اختلاف أعراقهم وقومياتهم ولغاتهم ورموزهم ونعومتهم وخشونتهم و”ألوانهم ” في كل مكان؛ حيث هؤلاء “الفاشيون” هم الفوضويون الحقيقيون، الذين يحكمون الجماهير التي تريدهم في أغلب الأوقات، بوصفهم ترياقًا لفاشياتٍ أخرى، لتؤسّس معهم استبدادًا جديدًا في “عصر التطرّفات” هذا. وهُم بعكس شتيرنر لا يمقتون الأشباح، بل يَهيمون بها حُبًّا ويُؤسّسون فوضى سلطتهم عليها وإن لم تُوجد هذه الأشباح فهُم مستعدّون لخلقها من العدم.
لكن، هذه “الفاشيات” على تنوّعها وبكلّ عنفها اللاعقلاني يُمكن تفهّم صعودها المتواصِل، كضريبةٍ طبيعية لعصرنا، عصر “ما بعد السياسة” -كما يسميّه سلاڤوي چيچيك– الذي يرى في كتابه مرحبًا في صحراء الواقع، (ترجمة أحمد حسّان)، أنّ هذا العصر الذي نعيشه اليوم يتم فيه بشكلٍ مضطّرد استبدال السياسة بالمعنى المحدّد، بالإدارة الاجتماعية الخبيرة، ليكون المصدر المشروع الوحيد الباقي للنزاعات هو التوتّر الثقافي بأشكاله العرقية والدينية.
يبدو أنّ كل واحدٍ منّا في أعماقه هذا الفوضوي الحقيقي، الذي يعرف أنّ لاسُلطويّته الفعليّة في ممارسة حريّته عبر استبداده بالآخر. وفي الوقت نفسه، في كل واحدٍ منا تلك الذات التي تكون موضوعًا لاستبداد الآخر السُلطوي. ويبدو أنّنا بعكس ما ذهب إليه ألبير كامو: كلّنا ضحايا.. وكلّنا جلادون. المهم، أنتَ من تختار أن تكون؟ أو هل بيدك الخيار.. حقًا؟!
-
بين تولستوي و«أبو كرش التركي»: كم نصيب الإنسان من إهانة نفسه؟


على الأرجَح، سيتعجَّب قارئ العنوان ويتساءل: ما الذي قد يَجمع بين الروسي صاحب “البعث” والتُركي صاحب “الكرش”؟! الأوّل قدّم قبل أكثر من قرن فلسفةً فريدةً وبدائع في عالم الأدب، تَركَت أثرًا عميقًا على الّذين جاؤُوا من بعده من فلاسفة وأدباء، كما خَلقَ نَسَقًا دينيًا من اللاسُلطويّة هي “اللاسُلطويّة المسيحيّة”. والثاني يُقدِّم اليوم مقاطع ڤيديو يهزّ فيها “كرشه” الكبير ويُحرّك جسده بحركاتٍ بهلوانيةٍ وعلى وجهه ترتسم ابتسامة عريضة وفي الخلفيّة تَصدَح موسيقى تليق بهذا الأداء “السيركي” الذي يُقدَّم على أرض المنصّة العابرة للقوميّات والثقافات، التي لا تعرف حدودًا للعرض المُفرِط.. تيك توك (TikTok).
الجَامِعُ بين هذان النقيضان قصّة قصيرة كتبها ليو تولستوي عام 1886، وعنوانها “كم هو نصيب الإنسان من الأرض؟” وهي طَاغِية الشُهرة وغنيّةٌ عن التعريف، ومن لم يقرأها فغالبًا شاهد نسخةً عنها، تغيّرت فيها الكثير من التفاصيل، مع الاحتفاظ بالفكرة الرئيسية، في إحدى لوحات الفنّان السوري ياسر العظمة في مسلسل “حكايا المرايا” (إخراج مأمون البنّي) عام 2001، وقد حملت عنوان “الخنجر”.
تسرد هذه القصّة حكاية رجلٍ قرويٍ يُدعى باهوم، يَحلُم باِمتلاك قطعةٍ من الأرض، وفعلًا يتحوّل حُلمه إلى حقيقة، فيملك أكثر من قطعةٍ لكنّه لا يرضى عنها ولا يصل لمرحلة الإشباع معها، ليُصبح مهووسًا بامتلاك الكثير منها. وفي ديارٍ بعيدة عنه، حيث تَسكُن قبيلةٌ تَعيشُ نمطٍ حياةٍ بِدائي لكنّه بسيط وهادئ تغمره روح الهناء وغير مُتَمركزٍ حول المال والثراء، يُمنَحُ باهوم أخيرًا فرصةً لامتلاك ما يشاء من الأرض!
عَرضٌ مغرٍ وغير معقول: كل الأرض التي يُريدها مقابل 1000 روبل، لكن الشيطان -وهو صاحبُ دورٍ محوريٍ في القصّة- يكمُن في التفاصيل: عليه أن يمشي أرضًا واسعةً على أقدامه بدءًا من طلوع الشمس، وليس مطلوبًا منه أن يقطعها كاملة، بل له مطلق الحرية في السير فيها وتحديد نصيبه والنقطة التي يتوقّف عندها يقوم بوضع علامةٍ عليها، فتصبح مِلكه وحقًا شرعيًا له، على أن يعود لنقطة البداية قبل غروب الشمس.. وهو ما لم يحدث؛ إذ غلبه شيطان طمعه الذي زيَّن له أنّ بمقدوره حيازة المزيد من الأرض ومضاعفة نصيبه منها، ليكون نصيبه من الأرض قبرًا طوله ستّة أقدام!

هذا مُختصَر قصّة تولستوي، التي يمكن ربطها بقصّة الشاب التركي ياسين جنكيز (المعروف بين مستخدمي وسائط الميديا من العرب بـ”أبو كرش”) حيث الإنسان طمّاع ولا يعرف حدودًا لرغبته وحاجاتِه. وإن كان مسعى باهوم إنسان القرن التاسع عشر، ذي الأصول القروية البسيطة -التي تشبه أصول جنكيز- طبيعيًا ومشروعًا لولا أنّ شيطان الطمع أغواه؛ إلّا أنّ ما يفعله جنكيز من إهانةٍ لنفسه واعتماده على قطعةٍ من جسده لمضاعفة نصيبه من الإهانة الجالبة للمال والشهرة، لا يبدو طبيعيًا أو مفهومًا إلّا إذا تمّ النظر إليه في سياق “التداول السريع لرأس المال والمعلومات والتواصل، الذي لا تُدمَج فيه المساحة الخاصة والخجل”، بحسب الفيلسوف الألماني من أصل كوري جنوبي بيونچ-شول هان.
وليست هذه محاولة لشيطنة هذا الشاب التركي بطبيعة الحال؛ فالمسألة أكبر منه والأزمة تتجاوزه لما هو أكثر تعقيدًا وتركيبًا، وهو في النهاية إحدى الأثار الطبيعية لـ”سيولة” هذا الزمن، كما كان تولستوي ثمرةً لروح عصرٍ فيه الكثير من الصلابة. والأهم أنّ هذا الشاب مجرّد قطرة ماءٍ في بحر ما يسمّيه شول هان بـ“مجتمع العرض”، الذي يرى أنّه “معادلٌ لمجتمع البورنوچرافيا، حيث كل شيءٍ فيه يتم تحويله إلى الخارج، تجريده وكشفه وتعريَتُه ووضعه في غرفة العرض، وعليه أن يكون معروضًا ليكتسب صفة الوجود، وهذا الإفراط في العرض يُحوِّل كل شيءٍ إلى سلعة” وفي حالة ياسين جنكيز، فإنّ “كرشه” المعروض بطريقةٍ فاحشة تحوَّل إلى سلعة.
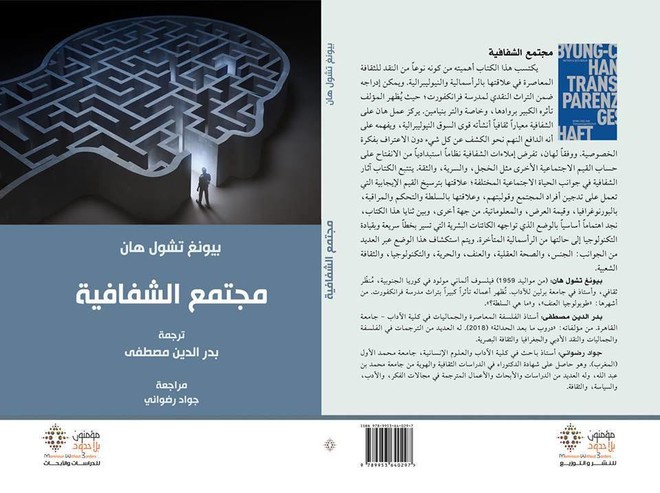
هذا المجتمع يُسلِّع أفراده أنفسهم من خلال عرض حياتهم عبر “وسائل التواصل الاجتماعي” -ويا للمفارقة يَغيبُ عن هذه الوسائل البُعد الاجتماعي بكل صلاته الحقيقية- بمنتهى الشفافية.. لا شيء محجوب مطلقًا وكل شيء مستباح، إنّه عالمٌ وقحٌ وعارٍ تُسيطِر عليه كما يقول شول هان أيديولوجيا ما بعد الخصوصية؛ حيث باسم الشفافية يتمّ الدعوة إلى القضاء بشكلٍ تام على المجال الخاص.
قد يتم الاِعتراض هُنا، والقول بأنّه كان -وما زال- يُعرَض على شاشات التلفزيون والسينما بمفهومها التقليدي أو الحديث (خدمات البث/المنصّات)، ما هو أسوأ ممّا يفعله ياسين جنكيز! ولا شكّ في صوابِ ذلك، لكن ثمّة فرقٌ جوهري: العلاقة في العمل التلفزيوني أو السينمائي “عمودية”؛ أيّ من أعلى (صُنّاع الفيلم) إلى أسفل (المتلقّي/المشاهد)، وبالتالي ففيها نوعٌ من الوضوح والتماسُك والصلابة حتى لو كانت رسائل ومضامين الأفلام والمسلسلات عكس ذلك تمامًا. كذلك فإنّ أفعال وحركات المؤدّيين في هذه الأعمال -حتى لو أرداد البعض إخضاعها للمحاكمة الأخلاقية- تأتي في سياق سرديةٍ فنّيةٍ مُحكَمَةٍ ومُنظّمة.
أما في ما يُعرَض على تيك توك و إنستچرام وسناب شات وغيرها، فالعلاقة فيه تأخذ شكلًا “أُفقيًا”، من (الناس) وإلى (الناس)، حيث لا تكون هناك أيّ رسالة أو مضمون -حتى لو رسالة هدّامة أو عدمية أو مضمونًا “مُبتذلًا”- مجرّد عرضٍ والمزيد من العرض وفائضٌ من استعراض بعضنا أمام بعض. وإن كان صنّاع الأفلام يسوّقون بضاعتهم للربح، ويَحشونَ بطانتها بأفكارهم ويُحمّلون مَبانيهَا مَعانيهُم، فنحنُ عبر هذه التطبيقات والمنصّات نُسوّق أنفسنا لبعضنا ونبيعُ الآخرين تفاصيل حياتنا وما كان متعارف عليه يومًا ما بالأسرار.
كذلك، فإنّ تفاعل الناس مع التلفزيون ومع السينما -والتركيز هُنا على الأشكال التقليدية لها- يتّسم بالجماعية وفيه تواصلية ونوعٌ من الحميميّة؛ حيث كان يتجمّع الناس لمشاهدة مسلسلات ربما لا تخلو من ابتذال مثل “باب الحارة” أو يذهبون للسينما أو يلتقون في بيتٍ لمشاهدة فيلم أو مسلسل كوميدي قد ترى في تصرّفات بطله امتهانًا لنفسه. لكن في هذه المنصّات والتطبيقات، التفاعل مُتَشظٍّ وفردي والتواصُلية مُهمَلة والحميميّة منزوعة؛ فكل واحد قابع في زاوية يُبَحلِق مُطأطَأ الرأس في “دمية الدب الرقمية” (الوصف لبيونچ-شول هان) ذات الستّة إنشات أو أكثر.. التي يحتضنها بيديه.
ما يقوم به هذا “المؤثّر التركي”، ليس الأكثر إثارةً للدهشة والاستغراب؛ ثمّة الكثير ممّا هو أسوأ! سيركٌ افتراضي أو Freak show مُعولَم -بعكس السيرك ذي الهوية أو الخصوصية المحلّية- تُعرَض فيه أكثر الأشياء غرابة: بشرٌ أشكالهم ليست كالبشر، مُسوخٌ يفتخرون بذلك، أشخاصٌ مصابون بعيوبٍ خَلقية يسخرون منها ويدعون الآخرين إلى حفلة اِمتهانٍ لكرامتهم الإنسانية، علاقاتٌ للبيع وخصوصياتٌ مُشاعَة، نوعٌ جديد من البرونوغرافيا نؤديها ونصوّرها نحنُ لا نجومها وصنّاعها، تمركزٌ حول الجسد واِستمدادٌ للهوية والوجود من أعضائه، أباءٌ وأُمّهات يُحوّلون أبناءهم لسِلَع فيستغلّونهم أو يتسوّلون عليهم لمضاعفة خانة المتابعين وربما خانة رصيد البنك.. من يدري؟! إذْ أنّ الأسوأ في هذا “السيرك السُريالي” و”معرض الموتى بحياتهم” لم يأتي بعد، ويبدو أنّ نصيب الإنسان من إهانة نفسه قبرٌ لِمَا تبقّى من خصوصيةٍ وسريةٍ وخَجَل!
مراجع:
بدائع الخيال: عشر قصص ممتعة للفيلسوف الروسي ليو تولستوي، ترجمة عبد العزيز أمين الخانجي، مؤسسة مؤمنون بلا حدود.
مجتمع الشفافية – بيونغ تشول هان، ترجمة بدر الدين مصطفى، مؤسسة مؤمنون بلا حدود.
-
بيت الديناميت: تنبّؤ بكارثة نووية أم إعادة إنتاج للقلق؟وهل هو فيلم “أوبامي” في زمن ترامب؟


«كان يجب على منصّة تلفزيون جيّد في هذه الحقبة أن تُنتِج القلق!»
صنع العدو أو كيف تقتل بضميرٍ مرتاح – بيار كونيسا
الآن وبعد أن شاهدنا القاذفة الشبح بي-٢ في الحرب الإسرائيلية-الإيرانية أو حرب الـ١٢ يومًا، حانَ وقت مشاهدتها في فيلم أميركي جديد، إلى جانب مجموعة أسلحة يبدو وكأنّه يتم التسويق لها في السينما بعد التسويق لها في “الواقع” أو استعراض فحولة التفوّق الأميركي من خلالها، لكن هذا الأخير في خطر هذه المرة -أي في عالم هذا الفيلم- ويواجه تهديدًا وجوديًا، وقائمة المرشّحين لتشكيل هذا التهديد هم الأعداء التقليديون: الروس، الصينيون، الكوريون الشماليون وبدرجة أقل الإيرانيون وأذرعهم.
وهذه المرّة، الإسلاميون الجهاديون ليسوا ضمن قائمة الأعداء، فيما يبدو أنّه انعكاسٌ لطبيعة العلاقة بين الإمبراطورية الأميركية بقيادة صانع السلام ومُنهي الحروب دونالد ترامب، وبين مجاميع الجهاديين الذين ساهمت أميركا بخلقهم ثم حاربتهم ثم ها هي بقيادة العَمَلي صاحب “فن الصفقة” تُروّضهم ولا مانع عندها أن يَحكموا بلدًا بـ”شروط وأحكام” ودون إحكام! أو ربمّا لأنّهم لم يكونوا يومًا -ولن يكونوا- إلّا أعداءً مضخّمين؛ فكما يقول الفيلسوف الفرنسي البلغاري تزڤيتان تودوروڤ في كتابه “أعداء الديمقراطية الحميمون”1 ، إنّ خطر الأصولية الدولية أي القاعدة وأخواتها، يُعيد إلى الأذهان أعمال الفصائل اليسارية المتطرّفة مثل الجيش الأحمر في ألمانيا والألوية الحمراء في إيطاليا، بدلًا من الجيش الأحمر لستالين، وبالتالي يتطلّب تدخّل الشرطة والأمن بدلًا من اللجوء إلى جيوش ضخمة وقوية.

بعد ظهورها في سماء إيران.. القاذفة الشبح بي-2 تتألّق على منصّة نتفليكس بيت من الديناميت.. أم من الكليشيهات الهوليوودية؟
فيلم بيت الديناميت الخارج قبل أيام من أفران نتفليكس، لا يبدو محشوًّا بالكثير من الأشياء الطازجة، ولا يبدو أنّه يفكّر خارج الصندوق الهوليوودي التقليدي؛ إذ يُعيد إنتاج الكثير من الأحداث والقصص والأجواء التي سبق وشاهدناها في كثير من الأعمال ذات النزعة “البطولية الوطنية” إن جاز الوصف، مثلًا لا حصرًا: الصخرة (1996)، اختطاف طائرة الرئيس (1997)، سلسلة أفلام صَعبُ الموت (1988-2013)، وسلسلة الأفلام المستوحاة من روايات جاك رايان التي كتبها توم كلانسي (1990-2014)، سقوط البيت الأبيض (2013)، سقوط أوليمبوس (2013)، والعملان الأخيران متشابهان وكأنّهما توأمان، والفرق الأبرز في لون بشرة الرئيس الأميركي الافتراضي! والقائمة تطول.
منذ لحظات الفيلم الأولى، نرى غرف عمليات في البيت الأبيض والبنتاغون فيها جنرالات وضباط وخبراء يُحاولون إنقاذ العالم أو للدقّة مركز هذا العالم أي “أميركا” من خطر صاروخٍ باليستيٍ عابرٍ للقارات لا نعرف مصدره ولا نقطة ووقت إنطلاقه في إشارةٍ واضحة إلى تقصير القوّة العكسرية الأميركية. تأهّبٌ عسكري وقلقٌ لا تنطفئ ناره وتوتّر متصاعِد وارتفاعٌ لمنسوب الوطنية الأميركية ووداعٌ للأحباب وحديثٌ مُكرّرٌ عن الأعداء المذكورين أعلاه، ورئيس أميركي، عارٍ من الخيارات وماثلٌ أمام معضلة وعليه أن يتخذ قرارًا قد يذهب ضحيته الملايين في سبيل إنقاذ البشرية جمعاء، في ما يشبه استدعاءً للدعوى المبرّرة لضرب هيروشيما وناچازاكي، حيث الملايين الذين قضوا كانوا ثمنًا لا بد منه لإنهاء الحرب وإنقاذ العالم وضررًا جانبيًا لمنع حدوث ضررٍ أكبر.

هذه الروح الأميركية وذلك “الديجاڤو“، ليسوا محلّ استغراب حينَ تُعرَف هُويّة صانعته، صاحبة الأفلام الحربية المثيرة للجدل مثل خزانة الألم (2008) الذي يدور حول حرب العراق و30 دقيقة بعد منتصف الليل (2012) الذي يتتبّع “الجهود” الأميركية لاعتقال “الجهادي” أسامة بن لادن؛ فالمخرجة الأميركية والزوجة السابقة لـ“جيمس كاميرون” كاثرين بيچلو رائدة في استعراض البطولة الأميركية والتفاخر بها والتسويق لـ”النزعة العسكرية الإنسانية الجديدة” -كما يسمّيها نعوم تشومسكي– والتي يبدو أن ترامب لا يحبّها حتى الآن، وإن كانت بيچلو تَنفي ذلك وتُصرّ أنّها تقدّم “توصيفًا” للحرب لا تسويقًا لها، لكن المتأمّل في مُجمَل أفلامها وخاصةً العملان المذكوران يستطيع بسهولة أن يَنفي نفيها.
البيت أيضًا مدجّجٌ بذخائر الصوابية السياسية
لكن، بالرغم من اكتظاظه بالكليشيهات والمشاهد المألوفة والمواقف التي سبق رؤيتها، ما زال في بيت الديناميت متّسعٌ لترسانة من تعاليم الصوابية السياسية وأيديولوجيا “الووك” أو “الووكيزم” التي قد تبدو ظاهريًا غير تقليدية وتتحدّى السائد والمُهيمِن، لكن كثرة استخدامها منذ “طوفان المنصّات” وتسيُّد نتفليكس، وحشرها في كل عمل جعلها سائدةً ورائجة حتّى أخذت شكل الصَيحة/التقليعة وأصبح من الواضح أنّها مُقحَمَة في كثير الأعمال البعيدة عنها وباتت هذه الأخيرة مغصوبة عليها، خاصةً حين تكون معروضةً على منصّة “صائبة سياسيًا” أو تُروّج للأيديولوجيا السائدة أو الأكثر رواجًا، أو يحبّها الناشطون ومُموّلوهم. عدا عن ذلك ما قيمة السينما وهي مسيّجة ومحاكمة وعليها أن تلتزم بتعاليم دينية؟ فتُخبِرُك وتُجبِرُك بأن تقول كذا وأن لا تقول كذا -كما يقول المؤّرخ والكاتب المصري الدكتور شريف يونس بتصرُّف- وفي ذلك مقال آخر في مقامٍ ثانٍ.
تَتَمظهَر هذه الصوابية السياسية في التعدّد/التنوّع العرقي للشخصيات، الذي بدا لي تعدّدًا/تنوّعًا قهريًا أو في أحسن الأحوال مصطنعًا ومُتكلّفًا ولا أراه في سياق الفيلم ضروريًا لولا أن اقتضته شروط وأحكام الأيديولوجيا المذكورة أعلاه والتزام المنصّات بها. وتُتوّج هذا البوليتيكال كوركتنس، بالرئيس الأميركي أسود البشر! بالطبع هذا ليس أوّل عمل يظهر فيه رئيس من الأميركيين الأفارقة، لقد سبقته أفلام كثيرة مثل الرجل (1972)، تأثير عميق (1998)، سقوط البيت الأبيض (2013)، لعبة كبيرة (2014)، سقوط الملاك (2019)، أو حتى عمل كوميدي بديع مثل حكم البلهاء (2006)، حيث أدّى الممثل الأميركي ضخم البُنية، ثقيل الوزن وخفيف الظل تيري كروز دور رئيس أميركي مستقبلي أسود البشرة، كان سابقًا مصارعًا ونجم أفلام بورنو!
وأين المشكلة في أن يكون الرئيس الأميركي أسود البشرة؟ أليس أميركيًا بالنهاية؟! وقد كان على كذلك لفترتين رئاسيتين! لكن حين يُؤخذ هذا العمل في سياقه الزمني والمرحلي، أي عندنا يُصنَع في الفترة الرئاسية لدونالد ترامب، الممقوت من الصائبين سياسيًا والذي جرت/تجري محاولات لـ”كنسَلَته”/إلغائه من ثقافة الإلغاء Cancel Culture. وحين يتحدّث عن فشل منظومة الدفاع الصاروخي الأميركية في التصدّي لصاروخٍ باليستي نووي عابرٍ للقارات في هذا الوقت تحديدًا، فالموضوع يبدو بعيدًا عن الصدفة، خاصةً وأنّ الرئيس الأميركي الحالي/الواقعي يسعى لتطوير مشروع دفاعي جديد اسمه “القبّة الذهبية”. كما أنّ ردّ البنتاغون ووزارة الحرب الأميركية ووزارة الدفاع الصاروخي على الفيلم ومهاجمته ورفض ما جاء فيه باعتباره خياليًا ومُضلِلًا، يَدعَم ذلك.
تعدّدية عفوية أم حنينٌ لأوباما؟
الرئيس الأميركي يؤدّي دوره إدريس إلبا ببراعة غير غريبة عنه، حتى إنّي أشك في أن إظهاره في النهاية متعمّد، لكي لا ينقطع حبل التشويق ويبقى المشاهد مشدودًا إلى الفيلم! هذا الرئيس كاريزمي -بحكم أن إلبا يؤدّي دوره!- حكيم وهادئ، عقلاني لكن دون أن يتخلّى عن عواطفه، وطني وليبرالي. وهذه صفات يبدو من الصعب جمعها في رئيس أميركي، لكن كاثرين بيچلو ونوح أوبنهايم -كاتب السيناريو- خلقوا رئيسًا أميركيًا على صورة خيالاتهم ورغباتهم، أو ربما على صورة الرئيس الأسبق باراك أوباما، في حنينٍ جارفٍ له ولعهده “الذهبي” مع أنّه من الصعب الادّعاء بأنّ بيچلو ليبرالية، هي لم تقُم بوَسم نفسها بذلك، وحتّى المتأمّل في مُجمَل أفلامها قد يرى أفلامًا يغلب عليها التبشير بـ”النزعة الإنسانية العسكرية” ودعم رجال الجيش، وأُخرى تَنَتقِد “عنصرية النظام الأميركي” و”عنف الأجهزة الأمنية.

أحنُّ إلى أوباما.. ومسيّرات أوباما وحروب أوباما جورج بوش الأسود؟
لكن، أليس هذا التناقض أو الازدواجية صفة مشتركة مع أوباما؟ رئيس أميركي من أصولٍ أفريقية، ميوله وشعاراته خليط ما بين الليبرالية واليسار، مُهتمٌ بحماية البيئة وتوفير الرعاية الصحية وفرض السلام. أمّا أفعاله فهي استكمالٌ لسَلَفِه: حروبٌ على عدّة جبهات وتدخّلات عسكرية بذرائع إنسانية وقتلٌ جماعي بالمسيّرات، أو ذبحٌ بقفازات ناعمة! وعلى سيرة سلفه، أي بوش الابن، رائد “الحروب الصليبية” الجديدة كما سمّاها، والعدوّ الحميم لرائد الغزوات المعاصرة ابن لادن الذي أنجز مهمّة اصطياده بعد 10 سنين من 11 أيلول خَلَفُه أي أوباما، هناك مشهدٌ في السيناريو/أو وجهة النظر الخاصة بالرئيس الأميركي من القصة، حيث يأتيه خبر “الكارثة النووية” المقبلة على شيكاغو وهو يشارك في دوري كرة السلّة للفتيات! في استدعاء/إحالة واضح للحظة إخبار جورج دبليو بوش بهجمات بُرجي التجارة العالميين والبنتاغون قبل 24 عامًا، أثناء مشاركته في نشاطٍ مدرسي لقراءة القصص مع الأطفال!

الحق يقال: تمثيل إدريس إلبا مقنع أكثر من تمثيل جورج بوش الابن هل هو تنبّؤٌ سينمائي بالمستقبل، أم إنتاجٌ للقلق؟.. وأين تنتهي الأَسطَرَة ويبدأ الواقع؟
في كتابه “صنع العدو أو كيف تقتل بضميرٍ مرتاح”2 يرى الباحث الفرنسي بيار كونيسا أنّ السينما اهتمّت كثيرًا بما يسمّيه “سوق القلق”، حيث استخدمت البلدان كافة “الفن السابع”، ولكن يبقى الأميركيون، من دون منازع، الأقوى في البروباجندا السينمائية. ويذكر مجموعةً من الإنتاجات الهوليوودية التي اعتبرها تبنؤية بشكلٍ ما بهجمات الحادي 11 من أيلول، ومنها: الجحيم المرتفع (1974)، صَعبُ الموت (1988)، تفشّي (1995)، ذيل الكلب (1997)، الحصار (1998)، وفيلم نزيف الأنف الذي لم يرَ النور حيث تمّ إلغاؤه بعد هجمات 11 أيلول، لأنّه كان يتحدّث عن هجومٍ إرهابي على برجي التجارة العالميين! وفي سياق هذا التداخل بين ما هو خيالي وما هو واقعي يتساءل كونيسا: أين تنتهي الأسطَرَة، وأين يبدأ الواقع؟!
فهل هذا الفيلم يقوم بنفس الشيء؟ يتنبّأ بكارثة نووية ويستبقها بسيناريو يبدو قابلًا للتحقّق؟ وإن كان العدو الذي أطلق الصاروخ النووي على أميركا في بيت الديناميت مجهولًا، فالأعداء في “بيت الواقع” كُثُر ومعروفون، والمرشّحون الأوائل: الصين وروسيا بوتين. ولا يبدو هذا التنبّؤ نابعًا من هوسٍ بنهاية العالم وهلاوس مسيحانية، حين يُعلن ترامب في 30 تشرين الأوّل من هذا العام -بعد تفاخره بامتلاك بلاده لأكبر ترسانة نووية بالعالم الذي تملك 9 دول فيه أسلحةً نووية- عن إعادة تجارب الأسلحة النووية للولايات المتحدة لأول مرة منذ 33 عامًا! وهل يقوم فيلم أليكس جارلاند الحرب الأهلية الصادر قبل أقل من عامين، بالتنبّؤ بحربٍ أهلية في أميركا وإعدام ترامب؟ خاصةً وأنّ الرئيس الأميركي في الفيلم المذكور يشبه بطريقةٍ تبدو مقصودة الرئيس ترامب. مِنَ المُستَبعَد ذلك، لكن من يدري!
أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرّد حلقة جديدة في سيرورة إنتاج القلق أو إنعاش سوقه؟ ومَن أفضل من هوليوود للاضطلاع بهذه المهمّة؟ ومن أكثر قدرةً على الانتشار بسرعة والوصول إلى الجميع بكل سهولة من منصّة مثل نتفليكس! وفي هذا الصدد يقول بيار كونيسا: “إنّ خطر الاعتداءات بالوسائل الكيميائية أو النووية أو الجرثومية، التي أصبحت تهديدًا يعتبر وشيكًا، يُشكّل موضوعًا يرفع نسبة المبيعات. وكان يجب على منصّة تلفزيون جيّد في تلك الحقبة (يتحدّث هُنا عن ما بعد 11 أيلول)، أن تُنتِج القلق!” وها نحنُ اليوم لحسن حظّنا، لدينا منصّة “ترفيه” جيّدة لحقبتنا هذه.

كوبريك ضد بيچلو: قلق أقل، حب للقنبلة أكثر
في نهاية الفيلم أو السيناريو الأخير، يبلغ القلق ذروته وتقترب الكارثة النووية من شيكاجو وعلى الرئيس الأميركي اتّخاذ القرار الحاسم. وقبل لحظة القرار الصعب، تُملي عليه حكمته أن يردّد بعد الكلمات الوعظية والدرامية -المُقنعة والمؤثّرة بفضل أداء ألبا- فيُشبّه عيش البشر في أميركا نووية وعالمٍ نووي، ببناء منزلٍ مليء بالمتفجرات، تتم فيه صناعة القنابل ووضع الخطط وهو بأكمله على وشك الانفجار، لكنّنا واصلنا العيش فيه! من الممكن إعادة صياغة كلام الرئيس الأميركي المتخيّل باقتباس خالٍ من الصور الفنية، لتودوروف من كتابه المذكور أعلاه، حيث يقول: “إنّ ما تعلّمناه في القرن الحادي والعشرين أن الإنسان أصبح يشكّل تهديدًا لبقائه بالذات”.

في البحث عن نقيضٍ لهذا القلق الذي يعجُّ به بيت الديناميت، وتُضاعِف مخزونه موسيقى الملحّن الألماني فولكر بيرتلمان، علينا أن نعود 61 عامًا إلى الوراء، حيث كانت الحرب الباردة حامية -يا للمفارقة- وقدّم الراحل ستانلي كوبريك للبشرية جمعاء هديةً تُخفّف من القَلَق تجاه القنبلة النووية وتزيد الشَبَق تجاهها.
لا مكان في دكتور سترينجلوڤ (1964) للخوف من الكارثة النووية، لا فائدة من الدراما ولا وقت للوعظ، لكن هناك متّسعٌ للكوميديا السوداء في عالمٍ على وشك أن يتحوّل إلى سواد. وهناك مساحة واسعة للسخرية من العالم بشرقه وغربه وبمعسكريه الاشتراكي والرأسمالي، من الجنرالات الذين سرّعوا نهايته، من القادة الذين يجتمعون في “غرفة الحرب” في البنتاغون ويقاتلون بعضهم جسديًا ولفظيًا، كأنّهم في سيرك بشري أو هُم التطوّر الطبيعي للقرود الذين سيظهرون بعد أربع سنوات في فيلمٍ آخر لكوبريك مُعادٍ للإنسان.
وإن كان الرئيس الأميركي المتخيّل في بيت الديناميت أمام خيارٍ صعب ومعضلة، فإنّ إحدى شخصيات فيلم كوبريك، الجنرال “باك” تورجيدسون، يطرح بكل برود خيار هجومٍ نووي استباقي على السوڤييت، فيردّ الرئيس الأميركي رافضًا اقتراحه، إذْ يراه دعوةً لقتل جماعي، لاحرب! فيَرُد بلامبالاة: “سيّدي الرئيس، أنا لا أقول إنّ أيدينا لن تتلطّخ بالدماء، ولكنّني أقول أنّه لن يسقط أكثر من عشرة إلى عشرين مليون قتيلًا كحد أقصى ويعتمد ذلك على الظروف والصُدَف!”. وبحسب كتاب “موجز تاريخ الحرب”3 للمؤرّخ العسكري البريطاني الكندي چوين داير، فإنّ كوبريك تعمّد أن يكون الجنرال توردجيدسون صورة كاريكاتورية للجنرال الأميركي كورتيس إ. ليماي الذي خدم فترة طويلة رئيسًا لقيادة القوّات الجوية الاستراتيجية الأميركية والذي أراد بالفعل وقوع حربٍ نووية!

I’m not saying we wouldn’t get our hair mussed. But I do say no more than ten to twenty million killed, tops في نهاية بيت الديناميت يصل الصاروخ شيكاجو ولا نعرف قرار الرئيس ويتركنا العمل قلقين ومتوتّرين وربّما غير راضين عن نهاية غير تقليدية لا يُنقِذ فيها “البطل الأميركي” العالم. بينما في دكتور سترينجلوڤ نرى انفجارًا على وقع أنغام أغنية “سنلتقي مجددًا“ للمغنّية البريطانية ڤيرا لين! وحين تقوم قيامة العالم، يقوم النازي السابق وخبير الحرب النووية، المسمّى الفيلم على اسمه، عن كُرسيه المتحرّك، منتصبًا ومُنتَشيًا بنهاية الأرض وإبادة البشرية ومردّدًا “التحيّة الهِتلَريّة”، وكأنّ النازية لم تنتهي، بل زرَعت نفسها في “العالم الحُر” وهاي هي من قلب هذا العالم -الحُر في فنائه- تَشمَت بالبشر وهي تشاهدهم وهم يُهلِكون أنفسهم بأيديهم.

“Mein Führer, I can walk” التاريخ الطويل لعمليات صنع العدو وإنتاج القلق
بالرغم من اكتظاظه بالكليشيهات وامتلائه بما سبق وشاهدناه، إلّا أنّ بيت الديناميت مهم جدًا ومن الضروري مشاهدته، لا لقيمته الفنية، فهو ليس ساحرًا بصريًا أو تقنيًا ولا يُحدث أي ثورة في فئته. واعتماده الأكبر على تَسَلسُلِه غير الزمني وعرضه نفس القصّة من عدّة وجهات نظر/زوايا، وأيضًا على القلق اللامنقطع الذي تداعبه وتُهيّجه ألحان فولكر بيرتلمان، وبالطبع يستند بالمقام الأوّل إلى طاقمه المتمكّن وعلى رأسهم إدريس إلبا، ريبيكا ڤيرغسون، جارِد هارِس. إذًا، بعد كل هذا لماذا هو مهم؟ لراهنيته؛ لأنّه يُطرَح الآن، في زمن أميركا الترامبية وروسيا البوتينية وأوروبا الحائرة والجيوش التي ينحسر وينحصر فيها تأثير المقاتل/القاتل البشري لصالح المقاتلات والمسيّرات والأسلحة الإبادية التي تُشغَّل عن بُعد، وكذلك للتفاعلات المستمرة معه والجدل القائم حوله والهجوم الأميركي الرسمي عليه.
والأهم، أنّه مُهِمٌ لـ”قيمة ما بعد العرض” الخاصة به. صحيح أنّ الناس غالبًا ستنساه بعد أسابيع كما هو حال أغلب الأعمال المعروضة على نتفليكس، لكن حين يأتي أحدهم ويقوم بالتأريخ للأعمال السينمائية التي تَضطَلِع بمهمّة صناعة العدو وإنتاج القلق وإعادة إنتاجه بأشكالٍ مختلفة، فغالبًا سيكون هذا أحدها. وربما سيُشار إليه بالفيلم الذي صدر في فترة رئاسة ترامب وهاجم المؤسّسة العسكرية وتنبّأ بكارثة نووية، إن لم تكن قد حدثت هذه الكارثة مستقبلًا! باختصار: إنّ قيمة الإنتاج السينمائي هذا تطورية لا ثورية.
هل هو من أفلام “الحرب الأهلية الأميركية الباردة”؟
إن كانت أفلام فترة الحرب الباردة، تلك الحرب التي اعتبرها عالم الاجتماع والفيلسوف الفرنسي جان بودريار4 حربًا عالمية ثالثة وضعت حدًا للشيوعية كما وضعت الثانية حدًا للنازية.. أقول: إن كانت هذه الأعمال قد هاجمت الأيديولوجيا الشيوعية والإمبراطورية التي تبنّتها، عبر الوسيط السينمائي الذي بات هو الرسالة وأصبح ساحةً للصراع الأيديولوجي -بتعبير سلاڤوي چيچيك– فإنّ بيت الديناميت يهاجم “أعداءً داخليين” دون أن يُسمّيهم وكلام الرئيس الأميركي عن العيش في بيت من المتفجّرات يُمكِن قراءته كإشارة مبطّنة إلى ذلك. فهل يكون هذا الفيلم وأفلام أخرى ستأتي من بعده من ضمن “سينما الحرب الأهلية الأميركية الباردة” مستقبلًا؟ وهل ستعقب هذه الحرب، حرب عالمية رابعة والتي ستكون وحدها بالفعل حربًا عالمية كما يتنبّأ بودريار؟ ربما، وغالبًا هي مجرّد خيالات، ومن هُنا يبدأ الإغواء.. من واحات الخيال لا صحراء الواقع.


This is the end
Beautiful friend
This is the end
My only friend, the end
Of our elaborate plans, the end
Of everything that stands, the endهوامش:
- أعداء الديمقراطية الحميمون – تزفيتان ترودوف، ترجمة غازي برو، نشر: دار الربيع، توزيع: دار الفارابي، ٢٠١٥.
- صنع العدو أو كيف تقتل بضميرً مرتاح، بيار كونيسا، ترجمة: نبيل عجان، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ٢٠١٥.
- موجز تاريخ الحرب – غوين داير، ترجمة: آراكة مشوّح، الشبكة العربية للأبحاث، ٢٠٢٥.
- العولمة والإرهاب – جان بودريار، من مقال في جريدة لوموند ديبلومانيك الفرنسية، ١٨ نوفمبر ٢٠٠٢، من كتاب “العنف” الصادر ضمن سلسلة دفاتر فلسفية عن دار توبقال للنشر، ترجمة وإعداد محمد الهلالي وعزيز لزرق، ٢٠٠٩.
-
عن المُهَلوِسين باستعادة الماضي والعالقين في المستقبل


«إنّ تقاليد جميع الأجيال الغابرة تجثم كالكابوس على أدمغة الأحياء»
كارل ماركس
أين يعيش المُهلوِسون بالماضي؟ في بيتٍ من الجثث! أمّا أولئك الّذين يحاولون إحياء الموتى، فلن يعيشوا.. إلّا كجثث متحرّكة.
لا يعني ما سبق إلقاء الماضي بسلّة المهملات؛ فأحيانًا يكون ملهمًا للحاضر ومحفّزًا على المُضيّ قُدُمًا صوب المستقبل. لكن يجب التعامل معه بوصفه رافدًا للهوية ودعامةً من دعامات الحضارة، لا كمقدّس؛ فحينَ يُقدَّس يتحوّل إلى مادة للهلوسة، فيصبح مقدّسوه مُهلوِسين باستعادة ماضٍ «ذهبي» ومدمنين على تعاطي خيالات تفصلهم عن الواقع وتجعلهم يعيشون في ذُهانٍ جماعي.
أمّا المستقبل، فهناك مُهلوِسون به أيضًا! يقتطعونه من علاقته الجدلية بالماضي والحاضر، فيصبحون عالقين بما لم يأتي بعد، ينتظرون الموعود وكل مخطّطاتهم ليست في سبيل مستقبلٍ ممكن التحقّق، بل من أجل مستقبلٍ متخيّل لكنه حتمي التحقّق ومحسومٌ أمره بإرادة الماضي والأزل والماوراء وما قبل التاريخ، لا بإرادة المادة والقوّة والعنف الضروري والتخطيط بعيد الأمد ومكر التاريخ.القوّة والمادة ومكر التاريخ.
وبين الهلوسة باستعادة الماضي والهوس بانتظار المستقبل الموعود يضيع الحاضر؛ فهو الذي سيصير ماضيًا وسيصنع مستقبلًا. ومن يملك الحاضر: كل شيءٍ له.. حاضر.
استعادة الماضي اليوم ليست عفوية بالضرورة، ربما هي كذلك على مستوى الجماهير و«الوعي الجمعي» وإن كانت هذه العفوية ليست مرادفةً للبراءة بالضرورة. لكن على مستوى النخب والقادة وواضعي السياسات وموجّهي الجماهير ومهندسي الدعاية ومروّجي الحروب، تتم استعادة ماضٍ بصيغة الحاضر، نسخة رثّة عمّا مضى وانتهى تخدم غاياتهم في الحاضر. وهؤلاء لا يُلامون؛ فمسؤوليات عملهم تقتضي استغلال المثل والقيم من أجل أشياء أبعد ما تكون عنها، ومن هواياتهم المفضّلة سلخ الأشياء عن سياقاتها التاريخية.
هنا عليّ أن أعود شخصيًا إلى الماضي أيضًا، إلى كتاب ماركس «الثامن عشر من برومير لويس بونابرت»، الذي يقول فيه: «في فترات الأزمات على وجه التحديد، نرى الناس تلجأ إلى استحضار أرواح الماضي لتخدم مقاصدها وتستعير منها الأسماء والشعارات القتالية والأزياء، لكي يمثّلوا مسرحية جديدة على مـسرح التاريخ العالمي في رداءٍ تنكّري يكتسي بوقارٍ ولغةٍ مُستعارة».
اليوم، يبدو هذا الماضي المتخيّل -الذي تنبهر به جموعٌ منتمية إلى جماعات متخيّلة- كرتونيًا وكوميديًا، مجرّد حاضرٍ له غاياته ومقاصده يتنكّر في رداء الماضي بوقارٍ مصطنع ولغةٍ ممسوخة بفعل المحاكاة والمشابهة.
وكما قال ماركس -مجدَّدًا- في مقولته الشهيرة جدًا من نفس الكتاب: «إنّ جميع الأحداث والشخصيات العظيمة في تاريخ العالم تظهر مرتين: المرة الأولى كمأساة والمرة الثانية كمسخرة/مهزلة».
في المرّة الأولى (الماضي)، كانت الأحداث والشخصيات تاريخًا بمآسيه وانتصاراته، وفي المرّة الثانية (اليوم/الآن) في عالم مزدهر بالأزمات والقادة المأزومين -ترامب مثلًا لا حصرًا- والشعوب المتأزّمة، فإنّ هذه الشخصيات والأحداث التي مَضَت تتكرّر على شكل مسخرة/مهزلة.

-
الإعلام إذْ يُبَالِغ ولا يُبلِّغ أو: الصحف الصفراء في الأمس، القنوات الحمراء اليوم


«إذا عضّ كلب رجلًا فهذا ليس خبرًا، لكن إذا عضّ رجلٌ كلبًا فهذا هو الخبر!»
العبارة السابقة ربما أصبحت كليشيه اليوم، والغالبية غالبًا تعرفها، وفيما مضى كان دارس “الإعلام” بتخصُّصاته الفرعية المختلفة: تحرير/إذاعة وتلفزيون/علاقات عامة/إعلان وغيرها، يعرفها منذ أوّل محاضرة له في الكلية. وبعد قرابة 18 عامًا من دراسة التحرير الصحفي، ما زلت أذكر أوّل شرحٍ لهذه المقولة في سياق مساق “مدخل إلى الاتصال”.
المهم وبعد هذا المدخل، أستَحضِر هذه العبارة وأنا أتساءل: هل الإعلام* يُبلِّغ الناس بما حَدَث ويَحدُث؟ هل يُخبِرُهُم بالخبر كما هو، كما خَبِرَهُ الشهود وناقلوه من المراسلين؟ هل يكتفي بوظيفة التبليغ؟ أم أنّه يُضيف عليها ويتجاوزها ويجعلها ثانويةً لتصبح الوظيفة الرئيسية هي المبالغة لا التبليغ؟ المبالغة بما حدث والوصول للتنبّؤ بما سيحدث أو تهميش الواقعة التي وقعت فعلًا وقتلها دون إخبار الناس بـ”عملية القتل” هذه، وزرع مُصْطَنَع مكان جثّة الواقعة، ليُصبح بدوره هو الواقعة؛ فطالما نراه على الشاشات -على اختلاف أحجامها- فقد وَقَع! وطالما تُغرينا قراءته ومعرفة تفاصيله والضغط على الرابط ورؤية الصورة ومتابعة القناة للمزيد من التفاصيل فهو الواقع الآن، هو أمرٌ واقع، حتى إن كان خاليًا من أي وقائع.
هذه المبالغة تتمّ ببلاغة، لا بلاغة اللغة فحسب من خلال المُحلّلين والمفكّرين والشُعراء والمُستَشعرين وحتى المذيعين والمُقدّمين الذين يتحدّثون بخلاف ما تقتضي وظيفتهم -أي الإعلام- بلغة الأحلام والأوهام لا الواقع، بل أيضًا بلاغة الصورة/المشهد على نحوٍ سينمائي وترفيهي.
وتتواصل هذه المبالغة عبر المزج بين البلاغتين، خاصةً حين لا تكون قناتك مجرّد قناة حكومية رسمية، بل شبكة ضخمة تمويلها غير محدود وتُرضي جميع الأذواق: قناة للأجانب تتحدّث إلى دُوَلِهِم بلغةٍ مُعتَدِلَة وعقلانية، وواحدة أخرى للتقدميين والناشطين ولتقليعات هذا الزمان التي يتم الإقلاع عنها وتبديلها بحسب أهواء المُموّلين والمانحين والمُخطّطين.
وبالطبع والأهم هُناك القناة الموجّهة للعامة/العوام، والتي تُقدّم لهم ما يحبّون مشاهدته حتى وإن كان متطرّفًا ولا معقولًا ومجنونًا ومحشوًا بأكاذيب وأوهام أكثر من حشو مكدوس الباذنجان بالجوز! وقد قُمتَ أنت شخصيًا بصياغة رؤيتهم لما يُحبّون أن يروا وصَنعتَ ثقافة وتوجّهات هذه الطبقة المُهيمَن عليها -بالاستئذان من غرامشي– التي تَعرِف -هي- أنّه مُهيمَنٌ عليها، لكنها تَجهَل بفعل الثقافة التي تَصنَعُها/تَصطَنِعُها شكبتك والوعي الذي تُشكّله قنواتك، أنّك أنتَ المُسَيطِر والمُهَيمِن عليها قبل أنظمتها وحكوماتها؛ فأنتَ تُسَيطِر على الوعي والأدمغة، القلوب والعقول.. وهذه الأنظمة والحكومات بالكاد تُسيطِر على الأجساد.
في الأمس كانت الصحف الفاضحة التي تَقتاتُ على الأكاذيب والمبالغات الواضحة، تُسمّى “الصحف الصفراء”. اليوم أغلب الصحف تحوّلت إلى شيء من الماضي، إلى ما يُشبه التُحَف أو النُصُب التذكارية التي تقول لنا: كان هنُاك يومًا ما أخبار ومقالات وتقارير وتحقيقات تُكتَب وتُنشَر على ورق، والحق يُقال: كان فيها جماليات لم تَعُد موجودة اليوم؛ مثل البُطء الذي كان شرطًا للاستمتاع بتجربة قراءة هذه الصحف. ومع ذلك هناك ورثة طبيعيون لهذه الصحف اليوم، يُقال لهم: “المواقع الإلكترونية” لكن لونها ليس مُوحّد؛ فمنها من يأتي باللون البرتقالي أو الأزرق أو الأخضر وغيرها.. وأتحدّث هُنا عن مواقع محلّية أتمنّى أنْ تحل عنا.
لكن الوريث الأكثر شرعية والتطوّر الطبيعي لهذه الصحف هي القنوات والفضائيات -هل ما زال أحد يستخدم هذه التسمية “فضائيات” مع تراجعها لصالح الإنترنت والمنصّات؟- وهذه القنوات لها لون مميّز، لون كان فيما مضى مرتبطًا بالثورة والحرية والتمرّد، و”الخطر الأحمر”؛ أي اليسار أو الشيوعية الذي كان يخشاه بالأمس من يتم التهليل والتطبيل لَهُم اليوم بوصفهم رأس حربة في مقارعة استكبار/طغيان “الشيطان الأكبر” أو “الغرب الكافر”! هذا اللون الأحمر نَجِدُه في شريط الأخبار العاجلة، وفي رموزٍ أخرى تَستَخدِمُها هذه القنوات في سياق هندسة هذا الوعي الجَمْعِي الناطق والمُفكِّر باللغة العربية.
هذا “اللون الثوري”، باتَ اليوم مرتَبِطًا بالإذعان والخضوع لثقافة طبقة مُهَيمِنَة تَحرِص أنْ لا تُشعِرَك أبدًا بأنّها تُهَيمِن على وعيك الذي تُشكّله وثقافتك التي تَصنعُها ورؤيتك للعالم الذي تَخلِقُه.. لكنّها ليست رؤيتك، فهي لا تُريك إلّا ما تَرَى! وهل يا تُرى أنتَ حقًا تَرَى؟!
ربما اللون الأحمر يرمز لبعدٍ آخر مُفتَرَض لكّنه خطير، وهو تحويل المُتلقّي لهذه القنوات إلى “هندي أحمر” آخر، إلى إنسان سيُصبِحُ هو وشعبه مع سيرورة الإبادة والتهجير، مجرّد ذكرى إنسان، أو “فلكلور”، إن بقي الناس يُصدّقون أوهام هذه القنوات الحمراء ويقعون كل مرة فريسةً وصيدًا سهلًا في شباك شبكتها.
في ترجمته لكتاب جان بودريار الصادر بنسخته الأصلية “الفرنسية” قبل 44 عامًا -والذي أُعيد الاقتباس منه مجدّدًا وسأعيد ذلك مرةً بعد مرّة- “المصطنع والاصطناع”، يُورِد الدكتور جوزيف عبدالله اقتباسًا للكاتب الفرنسي فرانسوا-رينيه دو شاتوبريان، معبّرًا عن جوهر الكتاب وأَجِدُ فيه أصدق تعبير عن فحوى هذه السطور وخاصةً الأخيرة منها:
«القطيعة مع ما هو واقعي أمرٌ سهل. لكن الأمر ليس كذلك مع الذكريات؛ فالقلب يتقطّع لهجرة الأوهام، لقلّة ما في الإنسان من حقيقة!».

THEY LIVE (1988) – John Carpenter ___________________________________________________________________
*هامش:
ربما من المنطقي استبدال حرف العين بالظاء، ليصبح الإظلام بدلًا من الإعلام؛ الإظلام على الحقائق والوقائع لا الإعلام بها. أو استبدال حرف اللام بالدال، ليكون إعدام بدلًا من إعلام؛ إعدام الحقيقة، تعليقها على مشنقة الاصطناع والمحاكاة وصعقها بكهرباء التزييف والتهويل حتى الموت.
الصورة أعلاه من فيلم “قتلة بالفطرة” (1994) من إخراج أوليفر ستون وكتابة كوينتن تارانتينو.
-
عن الحرب المُحتواة بعناية


وأخيرًا توقّفت الحرب الإسرائيلية الإيرانية بعد 12 يومًا -وإن لم تنتهي- ومع ذلك لم ينتهي العالم في حرب نووية هرمجدونية الطابع، كما كان يتمنّى -بل ويؤمِن- أصحاب الخطابات المسيانية/الخلاصية/القيامية/الملحمية الّذين ينتظرون مُخلّصهم ويُسرّعون بتدخلاتهم البشرية “تدخلًا إلهيًا” سيُنهي الزمان ويأتي بالآخرة. ولم تتوسّع الحرب لتكون إقليمية ولم تَكبُر -على طريقة أبو شهاب “إن ما كِبرِت ما بتِصغَر”- لتصبح عالمية. لقد تمّ احتواؤها والسيطرة عليها، وبالتأكيد هذا الاحتواء تطلّب عدّة عوامل:
أولًا: قوّة تَضبِط الإيقاع، وهي بالتأكيد الولايات المتّحدة الأميركية تحت رئاسة رئيسٍ لا يُفضّل الحروب المُنفَلِتَة من عقالها بعكس أسلافه. رئيس استعراضي من خلفية بزنس-ترفيه تُهمّه أكثر مشهدية الحرب واللقطة التي سيظهر فيها صانعًا للسلام. المفارقة هُنا أن من ضَبَط إيقاع هذه الحرب واحتواها كان مشاركًا فيها منذ اللحظة الأولى وراعيًا لها، كما أصبح راعيًا لـ”السلام” بعدها! مفارقة أخرى: ربما لو لم تكن أميركا هي الضابط والراعي والمُحْتَوي، وكانت قوّة كبرى أخرى لم نُجرّبها بعد، أقول ربما خرجت الأمور فعلًا عن السيطرة، لكن ليس ثمّة شيء مؤكّد بخصوص هذه النقطة، إنّما هو شعور شخصي بأنّ الآخرين ليسوا أفضل من “الشيطان الأكبر” وربما كانوا أشيطَن، ونحنُ لا نعرف شكل الشيطان حتّى الآن ولا نعرف إن كان موجودًا أصلًا أم هو مجرّد شمّاعةً يعلّق عليها البشر غريزتهم التدميرية وميلهم التطوّري نحو “الشر”.
ثانيًا: عقلانية أحد الطرفين، وهي إيران. بالرغم من أن القسط الأكبر من خطابتها ودعايتها الموجّهة لجمهورها الداخلي ولجمهورها الناطق بالعربية غير عقلاني ولا معقول وشعبوي وقائم على المبالغات بإفراط. لكن في جانب الممارسة والتعامل مع الواقع، يميل نهج طهران إلى الواقعية والعقلانية والبراجماتية وهو نهجٌ تُحمَد عليه، بعكس أنصارها الأيديولوجيين والمُشجّعين بحماس لفريقها خاصةً في المنطقة العربية. أمّا الكيان، فهو بقوّته الغاشمة وجبروته ليس مُحتاجًا لأي عقلانية، فقط على أميركا وبالنيابة عن الغرب الذي وجد “الحل النهائي” لـ”المسألة اليهو-دية” على حساب الشرق وأرضه وأهله أن تُروّضه. وفي أحيانٍ كثيرة تُطلِق لهذه القاعدة العسكرية العنان لممارسة رياضتها المفضّلة: الوحشيّة، التي يبدو أنها تُبدع فيها أكثر على المدنيين العُزّل كما في غزّة.
مفارقة أخرى -ويا لها من حربٍ ملأى بالمفارقات وعالمٍ يَغصّ بالسُخرية والكوميديا السوداء- تكمن في أنّ لا إيران ولا “إسرائىل” كانتا مُتحمّستان للأجواء القيامية ولا تنتظران المخلّص وصراعهما مادي، إلّا أن الأنصار والمشجّعين ومحبّي هُوشات وطوشات حارة الضبع وحارة أبو النار، استبشروا بالحرب ورأوا فيها فرصةً لتعجيل قدوم المخلّص.. على اختلاف أصل وفصل واسم هذا المُخلّص عند جميع الأطراف، ولم أقل الطرفين؛ فهُناك من يشجّعون الحرب ويدفعون بها لتكون نووية إبادية وتقوم “القيامة” ويأتي مُخلّصٌ من طرفٍ ثالث لا يؤمن به الطرفان، الإنجيليون الصهاينة في أميركا مثلًا لا حصرًا.
قبل بضع سنين، كنت أقول ردًا على أصحاب الخطابات القيامية والسوداوية -في فترة كانت أيضًا مُشبّعة بالكوميديا السوداء بالإضافة إلى الأجواء البيروقراطية على الطريقة الكافكاوية وعبادة الأخ الكبير/الإخوة الكبار الأورويلية هي أزمة فيروس كورونا-: “إنّها ليست نهايتنا” وأتبعها بـ”للأسف”. اليوم أقول: “إنّها ليست نهايتنا، والحمد لله رب العالمين أنّه نجّانا -حتى الآن- من المجانين”.
إنّ الحرب بين الكيان وإيران لم تنتهي، هي لم تبدأ أصلًا في الثالث عشر من حزيران الحالي، أو في السابع من تشرين الأوّل 2023 (كون الدولة الفارسية أعلنت مباركتها للعملية ضد الكيان العبري ودعمها لها وقالت: إنها جاءت ردًا على اغتيال قاسم سليماني قبل أن تسحب كلامها) هي سيرورة إن جاز الوصف. ربما بدأت في عام 1979 أو حتى قبل، منذ أن تأكّدت دولة هرتزل أنّها لا تستطيع العيش بدون أعداء وأنّها تحيا من أجل الحرب و”تزدهر” بالقتال وتنتعش بمزيد من النعوش لخصومها المستعدّة لخلقهم على الدوام إن انقطعوا من سوق الحرب. لكن الأكيد ومع توقّف هذه الحرب المُحتواة، أنّ كثيرًا من المُشجّعين والأنصار العاشقين للخطابة والثرثرة لن يتوقّفوا عن التشجيع وصناعة انتصارات وهمية ومكاسب نصف مطبوخة، ولا شيء قادر على كبح جماح الغريزة التدميرية التي تُغذّيها خرافات وفانتازيا دينية توراتية وغير توراتية أو على احتواء “ليبيدو” القياميين التوّاق لمزيد من الخراب.
أمّا الكيان، فَمِن الجميل بل من الضروري، الشماتة به والفرح بما تلقاه من ضربات حطّمت كثيرًا من أساطيره، لكن على المرء الحذر من الاكتفاء بهذه الشماتة أو العيش عليها وتذكير نفسه على الدوام بأنّ هذا الكيان محترفٌ في الابتزاز -ابتزاز مُضطَهِد الىهود بالأمس أي الغرب وتذكيره بالهولوكوست وإعادة إنتاجه في سياق تضخيم أي هجوم ضده- وأنّه كذلك بارعٌ في إيهام أعدائه بأنّهم مُمسكون بزمام القوة، في اللحظة التي يُحكم خناقه على رقابهم. الأهم من كل هذا، أن المأساة بحق ما تبقّى من الشعب الفلسطيني في غزّة، لم تتوقّف بعد، ويبدو أن المسؤولين عن الاحتواء غير مهتمّين بمهمّة احتوائها؛ فاختصاصهم الحروب، وما جرى ويجري في غزّة من صنفٍ آخر، يُطلَق عليه: إبادة.
ختامًا سأُورد اقتباسًا لعالم الاجتماع والفيلسوف الفرنسي الراحل جان بودريار من كتابه المهم والأهم “المصطنع والاصطناع”، قد يساعد في فهم هذه الحرب، وبعض محطّاتها المهمّة مثل ضرب أميركا لمنشآت إيران النووية بواسطة القاذفة الشبح بي-2 وقصف إيران أمس لقاعدة العديد الجوية في قطر والتي غلبت عليه الرمزية والمشهدية والاصطناع و”الاحتواء” بشكلٍ واضح وفاضح، يقول بودريار: “لم يعُد هناك مكان لأي استراتيجية، وتصعيد الأمور ليس غير لعبة أطفال متروكة للعسكريين. لقد مات الرهان السياسي، لتبقى فقط عمليات اصطناع النزاعات والرهانات التي تُحتَوى بعناية.”

-
أيُّ شبحٍ يَنتابُ العالَم؟


سامح الله ماركس وإنجلز، فقد اعتقدا في بيانهما أن الشيوعية هي ذاك الشبح، لكنّه كان النقيض! وكونه كذلك -أي نقيض- لا يعني أنّه “شبح الرأسمالية”؛ فهذا الشبح يبدو معقّدًا ومُركّبًا وفي ثناياه طبقات داخل طبقات وظلمات فوق ظلمات. إنه هجين أو مسخ، وإجحافٌ بحق هذا المَسخ الأبشع من مَسخ فيلم The Substance أن يُختزَل إلى تجريدات مثل الرأسمالية، مع أن رأس المال مشكلة بذاته ولذاته، لكن هل هو لوحدِه المُقيم في جسد هذا الشبح/المسخ؟
حسنًا، ماذا عن شبح الهلوسات/الخرافات التي غُصِبَت على التحوّل إلى حقائق (كما في حالة “دولة الـيهود” و”داعش” وأخواتها “النواعم”) في مزجٍ سُريالي بين ما هو دِيني ودُنيوي، بين ما هو فانٍ وسرمدي؟
ماذا عن شبح المُصطَنَع وقد انقضَّ على الواقع وشبح الصورة/النُسخة وقد سَرَقَ الأوراق الرسمية للأصل وقتله وانتحل شخصيته؟ وشبح المشهديّة وهو يَخنِق الحَدَث كما حَدَث أو يَخلِق من العدم حَدَثًا ما حَدَث؟ وشبح الأخ الكبير وقد نجح في تحويل من كان أخًا لهم -أي الناس العاديين/المواطنين/العوام (أو “رعيّة” الأخ الكبير “الراعي” بالصيغة التُراثية) إلى إخوةٍ كبار ورُعاة، يُراقبون بعضهم بعضًا ويتنافسون باجتهاد في لعبة الضحية والجلّاد.
وماذا عن البيروقراطية التي تُعيد إنتاج نفسها في القطاع الخاص في مشاهد كوميديا سوداء تتفوّق على مسلسل The Office ممزوجًا بأفلام الأخوين كوين؟ وماذا عن المانحين المموّلين لمُعارضيهم من خلال مساحات ومنظّمات وشبكات بلا حدود وبحدود؟
وماذا عن جبل الجليد الغائر من النُخبة الحاكمة والطبقة المُهيمِنَة واللامرئي من الاقتصاد السياسي والعدوّ المُتنكّر في زيّ صديق، وسط عجزٍ جَمعي عن التمييز بين الاثنين. وماذا عن شبح الفاشيات المُتعدّدة المُزدَهِر بالتوازي -والتواطؤ- مع ازدهار النيوليبراليات المختلفة؟ وماذا عن البروباچندا المُنفَق عليها مليارات وتُخفي حقيقة أنّها بروباچندا ولا يَرى الناس ما هو مكتوب بين عَينيّ «مسيحها الدجّال»؟!
هل كل ما سبق أعراض لمرض “الرأسمالية”؟ أما كلها -مع رأس المال/الرأسمال- أمراض ينضح بها هذا الشبح/المَسخ.. الذي انتاب وينتاب العالم من الجنوب إلى الشمال؟ في الحقيقة أو ما يُشبَّه لنا أنّه حقيقة: لا جواب واضح، قاطع أو حاسم! ربما الشيء الوحيد شبه الأكيد أن الطبقة التي كان يُفترَض أن تُسبّب الارتعادات لكل الطبقات -كما جاء في البيان- هي الآن تَرتَعِد وعن أحلامها تَبتَعِد وهي تُشاهِد هذا السيرك الترامبي الماسكي (أو صِفهُ بما شئت إلّا أورويلي؛ فهذا وصفٌ قد عفا عليه الزمن!).
ويبدو أنّ الطبقات الأخرى هي التي ليس لديها ما تخسره، بل أمامها الكثير لتكسبه (المليارات، التريليونات والأراضي الواسعة والمساحات الشاسعة من القلوب والعقول… إلخ)! أما تلك الطبقة، فمُطبَقٌ على أنفاسها بأنواع جديدة من الأغلال والاستغلال والاستغفال وليس أمامها إلا الخسارة تلو الخسارة، وليس في الخسارة أيّ جسارة.
———————————————————-
*الصورة من فيلم Cosmopolis أو المدينة العالمية (2012)، للمخرج الكندي ديڤيد كرونِنبِرج، رائد صناعة أعمالٍ عن المسوخ والوحوش بأشكالها الفعلية والمعنوية والمهووس بتحلّل الأجساد والواقع كذلك.
-
رأس المِمحاة: عن تأويلٍ آخَر لأوّل كوابيس ديڤيد لينش


لا أدري كيف يمكن وصف مشاعر المرء تجاه هذا الفيلم، ولا أدري إنْ كان يمكن إدراج “رأس الممحاة” تحت بند “فيلم”1؟! أو تصنيف أوّل أفلام الراحل ديڤيد لينش كفيلم رعب! في الحقيقة -وهذه الأخيرة ليست متوفّرة بكثرة في عوالم لينش- هناك الكثير من “لا أدري” ومن “اللاأدرية”. إنّه ليس فيلمًا، مع أنّه سينمائيًا وبطبيعة الحال فائق ولوقته سابق، ويبدو عملًا مصنوعًا اليوم بالأسود والأبيض لكنّه متفوّقٌ على أفلام عصره.. عصره الحقيقي في السبعينيّات، وعصره اليوم، فهو عملٌ ينتمي إلى كل العصور.
إذًا هل هو تجربة؟ تجربة مجرّدة من المنطق والمألوف والمفهوم ومتحرّرة من الزمن، أراد فيها لينش أن يُجرّب ويُجرّد بلا حدود؛ لأنّ هذه هي السينما بالنهاية ومن يُكبّلها بالأصفاد يمسخها حين يجعلها عاديةً مملّةً ذات بعد واحد، أو “واقعية” فقط وتعكس هموم الجماهير والطبقات الكادحة… إلخ، أو كما يريدها شرطة الفنّ الراقي وهيئة مكافحة الفن الهابط، أخلاقية وملتزمة، أو على مزاج الذين يُلزِمون أي وسائط أو وسائل فنية بحمل رسالة، غافلين عن حقيقة أن الوسيلة/الوسيط نفسها هي الرسالة كما رأى فيلسوف الاتصال الجماهيري مارشال ماكلوهان منذ عقود.
حسنًا، هو إذًا كابوس؟.. أم هلاوس؟ أم مخاوف مدفونة ودوافع مكبوتة للينش وللإنسان بشكلٍ عام؟ أم هي مجرّد إسقاطات ورمزيات بقالبٍ سُريالي وعلى طريقة “أفلام رعب الجسد” التي أبدَع فيها ديڤيد لينش وديڤيد آخر هو ديڤيد كروننبرج؟ الجواب -الذي ليس حتميًا بالضرورة- على كل هذه الأسئلة: هو كل هذا وذاك، هو كابوس إن شئت الاختزال، يبدأ على الفور، منذ النقر على زر التشغيل.. فلينش لا يُحبّ الانتظار وإن استغرق 5 سنوات في إنتاج “رأس الممحاة” وإن كان في هذا الأخير مساحات مخصّصة للانتظار، للسكون المُرعِب، للهدوء.. المُقلِق، لفترات صمت مريبة بين شخصيات غريبة.
هو كذلك يبدو تجربة مزعجة ومقلقة: تكوينات بصرية فائضة بالجماليات، لكنّها بنفس المقدار تفيضُ إزعاجًا وتشاؤمًا. شعور كريه يتولّد مع كل مشهد وينبجس في كل لقطة ومع ذلك يستمر المرء في المشاهدة! شيء أشبه بجلسة تعذيب طوعية بأدوات الصوت والصورة، بمازوخية عَرِف لينش منذ أن كان في سن الحادية والثلاثين وخَلَق هذا الفيلم للعالمين، أنّ الناس تحبّها.. وأنّ الجمهور وإنْ ادّعى التحضّر، فإنّ الجذور البدائية المترسّبة فيه تغويه بما هو مرعب وكريه ومقزّز.
السؤال الأهم: هل يمكن تأويل هذا العمل؟ وهل ستكون عملية التأويل بريئةً من التحيّزات الذاتية والإسقاطات الشخصية؟ نعم جوابًا على الشطر الأوّل، لا جوابًا على الثاني. صحيح أنّه لا يعلم تأويل العمل إلّا مؤلّفه، لكن المؤلّف قد مات، مات بالمعنى البارتي -نسبةً إلى الناقد والفيلسوف الفرنسي رولان بارت– قبل أن يموت فعلًا بانتهاء عمره لا فنّه. مات لحظة صناعته لهذا العمل كما مات لحظة تكوين أي عملٍ آخر؛ فكما في النص حيث لا تعود سُلطة لمؤلّفه وتنتقل كلّها للقارئ/الناقد ليصبح هو المؤلّف، في هذا العمل السينمائي، تُسحَب السُلطة من لينش أو يسحبها برغبته وينسحب طوعًا ليترك للمشاهدين/النقّاد مهمّة التأليف من خلال فعل قراءة العمل وتأويله، كما يفعل إلهٌ انسحب من العالم وترك الناس يصنعون المعاني ويتقاتلون عليها.. لكن في النهاية لا يعلم تأوّيله إلّا هُو.
وكما يقول بارت في كتابة “النقد والحقيقة”2: “الرمز ثابت ولا يمكن أن يتغيّر سوى وعي المجتمع به.” وما أراده لينش -إن أرادَ شيئًا فعلًا- من رمزيات هذا العمل هو ثابت، ولا يتغيّر شيء سوى وعينا به وقراءتنا وتأويلنا ونقدنا له. وهذا بالإمكان إسقاطه على كل أعمال لينش وربما على كل عمل سينمائي وتلفزيوني خاصةً إن كان غارقًا في الرمزية والغموض والإبهام. وفي النهاية التأويل، وبمصطلحات فيها شيء من الاقتصاد: سوق مفتوحة، خاصة لسينما متحرّرة من رقابة الحزب الواحد ومنعتقة من أغلال الأيديولوجيا الخاصة بِه وخطابته المُملّة.

وُلوجًا إلى هذا العمل اللينشي الغرائبي واستئنافًأ لتأويله، ليس هناك عالم واضح المعالم! كل ما نراه كأنّه يحدث على أرضٍ يباب، في عالم جحيمي وكونٍ كابوسي، وربما الجحيم الحقيقي ليس في عالمٍ آخر، بل هذه الأرض، وكل إنسان يستطيع أنْ يصنع جحيمه الخاص بضعفه وجبنه، كما يستطيع أن يصنع الجنّة على الأرض بالقوّة. وهنا يبدو لينش متأثّرًا بمُلهِمه السويدي إنچمار بيرچمان، وثمّة الكثير من المشاهد واللقطات التي تذكّر بفيلمي التوت البرّي والختم السابع الذين أخرجهما في عام 1957، بالإضافة لفيلمٍ تشاؤمي بيرغماني سبقهما بثمانِ سنوات يتحدّث عن الجحيم على الأرض وحكم “الشيطان” لها، هو سجن.
كثيرٌ من التكوينات البصرية والكادرات بدت وكأنّها لصانع الأفلام الأميركي ويس أندرسون، لكن الألوان الزاهية تنسحب من اللعبة البصرية لصالح الأبيض والأسود الباهت، وأفضّل أن أرى لون الفيلم بالرمادي.. لأنه اللون المناسب له، لعالمه الذي يقع في منطقة رمادية بين الواقع والخيال، بين الحقائق والهلاوس، بين ما تبقّى من الواقع وما فوق الواقع أو الواقع الفائق. وكل لقطة بكل تشاؤميتها وسوداويتها تصلح لتكون غلافًا لألبومٍ لفرقة “ميتال أسود” (Black Metal) مثل المشروع الموسيقي الذي أسّسه النرويجي فارچ فيكرنس Burzum مثلًا لا حصرًا، ويمكن بكل سهولة تركيب بعض مشاهد الفيلم عليها، وسيكون مزيجًا مثاليًا.

عالم الفيلم صناعي وبيروقراطي، مُظلِم وكافكاوي3، حيث الكثير من الماكينات والمصانع والكهرباء والأضواء التي تلتهم البشر وكل ما يتعلّق فيها يبدو شيطانيًا وكل ما هو صِناعي ينهش الحقيقة أو ما تبقّى منها. والموسيقى التصويرية من خلال الضجيج الصناعي والموسيقى المُحيطة المظلمة والأصداء الشبحية،تنجح في إيصال هذا الشعور وبإحساسنا بتلك الأجواء، وكأنّ شخصية الفيلم الرئيسة ابتلعها حوتٌ صِناعي وهي الآن في بطنه، أو كأنّ الجحيم هو عبارةٌ عن مصنع لا تتوقّف آلاته عن إحداث الضجيج البشع الذي يرافق عملية تحويل الإنسان إلى آلة مُهلوِسة بحياة فائتة، بعالمٍ كان يجب أن توجَد فيه.
أمّا البيروقراطية، وهي ليست تلك الحكومية فقط أو بيروقراطية العمل بل بيروقراطية الوجود، فتقود إلى الجنون ويبدو البطل (هنري سبنسر) ضحيّتها.. لكن هل هو بطل وهل هو ضحية؟ لا، ليس بطلًا أبدًا، هو ليس حتى شخصية رئيسة، ذَكرٌ بتسريحة شعر غريبة يبدو بمشيته ولغة جسده وملابسة أقرب إلى تشارلي تشابلن، لكن النسخة القلقة والأكثر غرابة وإثارة للريبة منه. إنّه رجلٌ بلا خصال الرجال، بليد، مُسالِم على نحوٍ مَرَضي، إيجابي على نحوٍ سلبي، لا يقول “لا”، ولا يصدر منه أي اعتراض، ممتَثِل ومِطواع حتى لو كان الامتثال على حساب تحويل حياته إلى جحيم وحرمانه من أن يحيا أو يشعر بتلك “اللسعة” المرافقة لأن يكون حيًا وموجودًا في العالم.
كل هذه الخصال ستقوده حتمًا إلى مصيره النهائي. وهذا الابن المسخ هو نتيجة طبيعية ومنطقية للإنسان المِطواع المُسالِم العاجز عن المواجهة، المرتاح لسجنِ نفسه في شقّة أقرب لزريبة حيوانات، منزويًا بعيدًا عن العالم. هذا الابن ربما ليس حتى ابنه، هو حتى لا يناقش “صديقته”/”حبيبته” المشكوك أنّها حبيبته والتي يبدو أنّها وأهلها ينتمون لعائلة تتوارث المرض العقلي وتتعاطى الهلاوس الدينية. سيصبح هذا المسخ الكريه ابنه وعليه تحمّل مسؤوليته وحده، مع إنه لم يُجِب على سؤال والدة صديقته/حبيبته المضطربة عمّا إذا كان قد مارس الجنس معها؟ إنه يتطوّع لأن يكون مجبورًا على كل شيء ويرتاح لعدم المواجهة حتى لو كانت النتيجة كائنًا مسخًا أقرب لكائن فضائي من فيلم فضائي (1979) لريدلي سكوت أو لحشرة من فيلم الذبابة (1986) لديڤيد كروننبرج أو زاحف من الذي يؤمن بوجوده مروّجو ومتعاطو نظريات المؤامرة. إنّ هنري سبنسر هو الضحية المفضّلة للبيروقراطية، والفريسة التي تحبّ العفاريت والأشباح المجتمعية (العائلة، الدين، التقاليد…) ركوبها.

إذًا هذا المولود المسخ، يمكن أن يكون رمزًا لعدّة أشياء: لمولودٍ غير مرغوبٍ به، حيث الطفل غير المخطّط له وغير المرغوب به، هو فضائي، وكما من الصعب أن تتعامل مع فضائي لو صادفت واحدًا في الشارع، من الصعب أن تتعامل مع طفلٍ لا تريده وتجده صار واقعًا في قلب بيتك. أو هو بيانٌ ضد الإنجاب والتكاثر بشكلٍ عام، يقول إن الإنجاب ليس فقط إعادة إنتاج لنفسك، هو إعادة إنتاج للخطأ في سياق عودٍ أبَدِي، وتكاثرٌ للبؤس وميلاد للتراجيديا.
أو قد يرمز للعبء الذي على الشخص المُمتَثِل والمُسالِم تحمّله، أو لمصيبة وورطة لا يعرف الإنسان كيف وجد نفسه بها، وعليه أن يستسلم لها وأن لا يفكّر أبدًا بالخروج.. فليس هناك أي مَخرَج. هنري جثّة في القبر، جثّة ما زالت حيّة، والقبر هو شقّته القذرة التي يختنق كل شيءٍ فيها: الحياة، الجنس وسائر الغرائز، البهجة والطمأنينة. وهذا المسخ ربما في النهاية حياته المُتعفّنة التي ترك تُربتها دون أن يسقيها بماء التجريب والمغامرة والحب والجنس والعنف وغيرها من الأشياء التي تجعل الحياة تستحقّ العيش. أو ببساطة هو من الممكن أن يكون استعارة للعلاقات السامّة بين الأزواج، كما في فيلم امتلاك (1981) ومسخه المُريع للبولندي الراحل أندريه زولاڤسكي.
لكن مجددًا، إنّ أحدًا لن يعرف إلى ماذا يرمز هذا الطفل المسخ إلّا لينش نفسه الذي مات ومات سِرّه معه، والذي كان يرفض في أكثر من مناسبة إفشاؤه، كما في مقابلاته مع صانع الأفلام كريس رودلي4، حيث حاول هذا الأخير في أكثر من مناسبة صيد تفسيرٍ أو تأوّيلٍ لهذا الطفل ولمُجمَل أحداث الفيلم.. وكانت أغلب ردود لينش من قبيل: “لا أعرف، لن أصرّح”.
أكثر مشاهد العمل إزعاجًا، هو مشهد زيارة هنري لعائلة “حبيبته”. هذا المشهد أرى فيه كره العائلة وجنونها وتناولها كسيرك يُخرّج مسوخ ومشوّهين أو مهرّجين في أحسان الأحوال. حركات غريبة تصدر عن الأم والابنة وأبٌ مشوّش، ومتقلّب بين العصبية والبلادة. كل شيء في هذا المشهد كريه ومقرف، الأشخاص وأشكالهم، العجوز التي لا تتحرّك وفي فهمها سيجارة في المطبخ، الدجاجة المشوية التي تتحرّك على الطاولة وينفجر منها الدم. إنّ كل شيء هُنا ضد “عفاريت” الزواج والارتباط والعائلة النووية تحديدًا والتي تظهر في العادة بصورةٍ حميمية دافئة، لكن ليس في عالم لينش، المضاد لما هو مُعتاد.

ماذا عن الجارة الجميلة والفاتنة؟ من الممكن أن تكون رمزًا للمكبوت في حياة هنري، لما لم يحصل عليه ويشتهيه، والمثير للاهتمام أنّ هذه المرأة المثيرة هي أوّل أنثى تظهر في الفيلم قبل “حبيبته” المزعجة، وربما هي حسرة من حسراته التي لا يستطيع التعبير عنها إلّا بمخيلته الواسعة، حسرة رجل كان بإمكانه الظفر بامرأة كهذه، لكن إيجابيته السبية رمته في أحضان امرأة أخرى لا يريدها، لكنّ الممتثل والمِطواع والمسالم بلا إرادة.
هذه المرأة تُحيل إلى الأنثى الفاتنة/اللعوب (Femme fatale)، في “الفيلم الأسود/فيلم النوار“، ونراها في أفلام أخرى للينش مثل رينيه ماديسون / أليس ويكفيلد في فيلم النيو-نوار الطريق السريع المفقود (1997)، ودوروثي فالنز في مُخمَل أزرق (1986). دون أن يحتكّ بها كثيرًا ومن خلال لقاءات قليلة وعابرة وأحدها تكون فيه مع رجلٍ آخر، تتلاعب فيه هذه الجارة بطريقة سحرية، كأفعى سفر التكوين في العهد القديم، لكنها لا تُخرجه من الجنّة، بل تُذكّره بأنّ هناك جنة فائتة وجحيم واقع.

من الشخصيات الأكثر إثارة للقلق والقرف، هي تلك المرأة صاحبة الوجه المشوّه ومساحيق التجميل التي تزيد هذا التشوّه: المرأة في المشعاع5. هل هي –إذا اضطررنا تقديم قراءة فرويدية6 كما فعل وسيفعل الكثيرون- الأم؟ وهل الرجل المشوّه في الكوكب هو الأب؟ يبدو ذلك تأويلًا منطقيًا؛ فهذه المرأة تخرج من المشعاع، الأداة التي تنتج الدفء في غرفة هنري، والأم هي مصدر الدفء لرضيعها/طفلها. كما أنّ شخصًا بمواصفات وخصال هنري غالبًا متعلّقٌ بأمّه التي من المرجّح أن تكون متلاعبة به وقاسية معه ومُعنّفة له، والتشوّهات الجسدية في طفله ما هي إلّا استعارة لتشوّهات نفسية وعقلية أورثتها هذه الأم. وفي تعاملاته مع مشاكل حياته ومع الإناث يُطلّ دائمًا ظلّ أمّه الذي يذكّره بأنّه رجلٌ طفل، بالغٌ غير ناضج.
أمّا الرجل في الكوكب، فهو الأب الذي يرمز تحريكه للروافع في بداية ونهاية الفيلم إلى العملية الجنسية نفسها، ويرافق هذه الحركات الكائنات التي تشبه الحيوانات المنوية، مؤذنةً ببداية تكوين مسخ جديد، مسخ أبيه وأمه والمجتمع والمدينة الصناعية، والمسخ هُنا ليس هذا الكائن الكافكاوي، بل هنري سبنسر نفسه.

أو يمكننا الذهاب بعيدًا في التأويل والقول إنّ القصة سياسية بالكامل! حيث هنري مجرّد مواطن مثالي في دولة توتاليتارية، عاجزٌ عن الرفض والمعارضة ويعيش حالةً دائمة من القلق والخوف مسلوب الحرية ومستلبًا وعليه أن يعيش بصمت داخل غرفته التي تشبه السجن وإن خرج منها فليس في الخارج أي مظاهر للحياة والأجواء كلّها ملوّثة بسموم المصانع. أمّا الناس، فيتقاسمون البؤس بعدالة ويحصلون على حصّة متساوية من القمع، والكبت الجنسي في ترابطٍ عضوي مع الميول الفاشية، وكلّما تعاظم أحدهما يتعاظم الآخر بنفس المقدار. والطفل المسخ في النهاية هو كل إنسانٍ جديد يُولد في هذا المجتمع، هو الإنسان المثالي لهذا المجتمع ودولته التي خلقت “آدم” الخاص بها على صورتها.
هل النظام التوتاليتاري في هذا التأويل هو اشتراكي أم رأسمالي؟ إذا أخذنا السياق الزماني للفيلم، يبدو هذا النظام اشتراكيًا وأقرب لدولة كانت تابعة للمعسكر الشرقي.. أو ربما إذا ذهبنا أبعد في التأويل هو الاتحاد السوڤييتي نفسه، أو هجين من دولة عالم ثانٍ وثالث. لكن لا فرق، فعجلة الإنتاج والتصنيع والقمع تدور رحاها وتمسخ البشر، والمسوخ تختلف في طبيعة السيرك الذي تتواجد به، واحدٌ ملوّن ومُبهرَج، وآخر ذو لون واحد كئيب.

في النهاية وفي تحليل -ليس أخير- يمكن تجميع كل ما سبق، وتركيبه على بعضه ولن يكون هناك أي خلل، على العكس قد تصبح الصورة متكتملة ولوحة البازل مكتملة القطع، حين تُكمّل كل الأشياء بعضها. الدولة التوتاليتارية والمجتمع الصناعي والعائلة المفكّكة والعلاقات السامة والكبت الجنسي والهلاوس الفردية والجمعية، كلّها تتعاضد لتكونَ أركانًا لهذا الكابوس، الذي ربما كان كابوس لينش، أو إذا أردنا تقديم تأويل آخر داخل التأويل، هو كابوس داخل كابوس آخر لا نعرفه لهنري، أو كابوس يعيشه أحدنا أو نعيشه بدون إدارك لحقيقته. وللأسف الكوابيس الحقيقية المُعاشة لا تبدو عامرةً بهذه الجماليات، إذ لا يصنعها ديڤيد لينش، الذي ينصحنا “بأن نشعر بهذا الفيلم لا أن نفكّر به”7، وقد التزمت بنصيحته بشكلٍ جزئي، فشعرتُ ثم فكّرت وحاولت النبش عن معانٍ في قلب هذا الغموض. وربما هذا الفيلم بالنهاية تجربة حسية، تُفهَم، لكن من الصعب شرحها وهذا حال الأشياء المُتقَنَة في الوجود.

هوامش:
1.معلومة شخصية عن علاقتي بهذا الفيلم: هو من أوائل أعمال لينش التي عرفت عنها، لكني لم أشاهدها. لقد هناك على الدوام خوف، توجّس، وباعثه ليس أنّي شاهدت إعلانه أو مشاهد ولقطات منه أو قرأت شيئًا عنه، حرفيًا لم أرى منه شيء إلّا صورة واحدة: صورة الملصق الرسمي للفيلم الذي يظهر فيها “البطل” هنري بشعره الغريب ونظراته القلقلة المفزعة.. فقط لا غير، وكانت هذه الصورة كفيلة لإثارة الريبة والابتعاد عن الفيلم وتجنّب معرفة شيء عنه، وما عزّز هذا الشعور أنّ أوّل عمل شاهدته للينش قبل أكثر من 12 عامًا كان الطريق السريع المفقود (1997)، وبعده لم أستطع النوم جيدًا لمدّة أسبوع تقريبًا! لكن هذا الأخير ومع كل الارتياب والقلق والغرابة التي فيه، يبدو مجرّد تسالي.. مقارنةً بـ”رأس الممحاة”.
2.النقد والحقيقة، رولان بارت، ترجمة: إبراهيم الخطيب، منشورات الجمل.
3.يقول كريس رودلي في حواراته مع لينش: إنّ كافكا دائماً ما يحضرنا عندما ذكر “رأس الممحاة”، ويسأل لينش: هل تحب ما قدّمه كافكا؟ فيجيبه: “نعم! هو الفنان الذي أشعر أنه أخي. لا أحب قول ذلك لأن أول ردة فعل دائماً ما تكون: “نعم أنت والجميع إخوتي مثل كافكا”، لكنني فعلاً أكن له الكثير، فبعض كلماته سحر لا مثيل لها. ولو كتب “كافكا” صورة عن جريمة ما، لوددت بالتأكيد أن أخرجها.
4.مذكّرات ديڤيد لينش، ترجمة عبد الله ميزر، سلسة الفن السابع، العدد 192، منشورات وزارة الثقافة السورية – المؤسّسة العامة للسينما
5.في الحوارات مع كريس رودلي، لا يبدو لينش معارضًا للقراءات التي تنتهي بشكلٍ حتمي إلى نقطة فرويدية، ويقول إنّه يتفّهم هذه الأشياء السيكولوجية.
6.يقول لينش، إنّه كن جالسًا في أحد الأيام في غرفة الطعام ورسم صورة المرأة في المشعاع دون أي يعرف من أين جاءت، لكنه يؤكّد أن كانت تحمل معنىً كبيرًا عندما رآها أخيرًا مرسومة.
7.في مقدّمته للحوار الذي سيدور حول “رأس الممحاة” يقول رودلي: هذا الفيلم يُعاش أكثر مما يُشرَح. المرجع السابق.
-
محرّكات الإبادة: دينية أم دُنيوية؟


ثمّة اقتباسٌ للمؤرّخ “الإسرائيلي” إيلان بابيه، شاعَ تداوله مؤخرًا، يقول فيه: “معظم الصهاينة لا يؤمنون بوجود الإله، لكنهم يؤمنون بأنّه وعدهم بأرض فلسطين”. بصرف النظر عن سياقات الاقتباس، إلّا أنّ كلام بابيه يبدو قريبًا من المنطق، بعيدًا عن التناقض؛ إذْ بِقدَرِ ما تبدو “إسرائيل” دينية وبالرغم من الثيمات التوراتية/التلمودية لحرب الإبادة والتهجير المستمرّة ضدّ قطاع غزة، إلّا أنّ هناك شيئًا لا دينيًا في جرائم أفراد عصاباتها. ولا يَعني هذا أنّ الدين اليهودي -أو غيره- بريءٌ من الإجرام؛ ففي النُصوص الدينية مَقاطعٌ تَدعو إلى الخير وأخرى إلى الشر، مَزيجٌ من الرحمن والشيطان يحَتارُ المرء بخُصوصه. لكن، لا تعود الحقيقة مُهمّة، فالمؤلّف -بالاستعارة من قاموس رولان بارت– قد مات، وقُرّاءُ أعماله “الكاملة” في اللحظة التي يُفسّرون أعماله يَقتلُونَهُ ويُصبِحُون هُم: المؤلّف.. والإله.

إيلان بابيه منذ أيام الأب الشرعي للصهيونية وصاحب فكرة “دولة اليهود” ثيودور هرتزل، “اليَهودي المُلحِد”، مرورًا بـزئيف جابوتنسكي،مؤسّس الحركة التصحيحية الصهيونية -اليهودي المُلحد أيضًا- كان هناك سعي دؤوب لإجبار الخرافات -أو النبوءات سَمِّها ما شئت- على التحوّل إلى حقائق، وغَصْبٌ لما هو سَرْمَدي على الذوبان في الزمن، واستدعاءٌ للحوادث المُنتَظَرَة قبل ميعادها. وكأنّ الصهاينة بل الحركة الصهيونية منذ بداياتها، كان لسانُ حالِها: لماذا ننتظِرُ اليد الإلهية لكي تتدخّل؟ لماذا علينا كيهود قوميًا وعرقيًا (وهم قومية مصطنعة وعرق متوهّم، وفي ذلك حديثٌ آخر) أن ننتظر المسيح الخاص بنا؟ وكأنّ هناك عدم إيمان بكل هذه “النُبوءات الدينيّة” و”الوعود الإلهية” ويقينٌ لا يُخالِطُهُ شكٌّ بأنّ مملكة “إسرائيل” لن تقوم بالتدخل الإلهي، ربّما لأنّ إلهَهُم الخاص بِهِم ليس موجودًا إلّا في عقول المُتديّنين مِنهُم، وإنْ كان هذا لا يعني أنّ “الصهاينة المُتدينين” لا يؤمنون بحتمية مجيء المسيح من نسل “الملك داود”، ويُثيرون الرُعب ويُمارسون الإرهاب لتعجيل مَجيئه كما تفعل ديانات وطوائف أخرى.

يهوديان مُلحِدان وللصهيونية مُتحمّسان هُنا يتجلّى منظورٌ ماديٌ بحت، علماني بالمُطلق، إلحادي بدون هوادة، “دارويني اجتماعي” متطرّف، في الرؤية الصهيونية، مفاده أنّ دولة اليهود ستقوم بأيدٍ بشرية ولن تَنتَظِر يهوه ولا مَسيحَهُ. ستقوم بـ”دَهاءٍ يهودي” وبدعمٍ غربي، وبأي طريقة حتى لو كانت دعم المسيحيين الإنجيليين لـ”إسرائيل”، لتعجيل قدوم مسيحٍ -أي يسوع- لا يؤمن به اليهود!
كذلك، إنّ ممارسات هذه “الدولة”، تعكس رؤيةً “نيتشوية” –نسبةً إلى الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه- مهووسة بالقوّة وترى فيها الطاقة المُحرّكة للأشياء والتي يَتمحوَر التاريخ البشري حولها وتبدأ كل الأشياء منها وتنتهي عندها؛ فَكرنَفالُ المجازر اليومية المُتنقّل ما بين شمال وجنوب قطاع غزة ورفح، والذي يَستعير بواعث التعبير عن نفسه من نصوصٍ توارتية وتلمودية ويُشارك فيه مرتزقة و”نَازيون جُدُد” -يا للمفارقة-، يبعَثُ برسالة مفادُها: “نحنُ نتحدّى الإله.. لا، نحنُ الإله نفسه، نحنُ تجسيدٌ مثالي للإنسان الفائق/الإنسان الأعلى الذي لا يحتاج إلهًا؛ إذ نقوم بأعمال هذا الأخير وقُدُرَاتُنا تُضاهي قُدُرَاتِه: نقبض الأرواح، نُشيّد جحيمًا على الأرض ونُقيم عروضًا يومية لأهوال يوم القيامة. وبما أنّه لا جنّة ولا نار هُناك، سنُقيمُ على هذه الأرض جَنّةً للشعب المُختار ونارًا لـ”الأغيار”.
وفي إحالةٍ إلى الكليشيه الدوستوفسكي من رواية “الإخوة كارمازوڤ”: “إنْ كانَ الإله غير موجود.. فكل شيء مُباح!”، تبدو “إسرائيل” مقتنعةً تمامًا به؛ فالإله غير موجود، وإذًا كل شيءٍ مُباح.. لكن لي فقط، فأنا الإله والآلهة الأخرى غير موجودة، أنّا الكيان الفوضوي/اللاسُلطوي الحقيقي الوحيد، الذي لا سُلطة تعلو فوق سُلطة عنفي المادي اللامحدود.
كل ما ذُكِر، لا يعني هُجومًا على المنظور المادي أو العلمانية أو شيطنتهما، إنّما الافتراض بأنّ “الدولة اليهودية” أخذت هذا المنظور والنهج وذهبت به لأقصى مدى وطبّقته بتطرّف، مع إلباسه لبوسًا دينيًا وتطريزه بثيمات تلمودية وإعطائه شيئًا من الإثارة برشّة من قصص العهد القديم، تمامًا كشخصيّة أليكس في فيلم “المُرشِد الأعلى للسينمائيين” الراحل ستانلي كوبريك “برتقالة آلية” (1971)، الشاب المادي حتى النخاع -أي أليكس- الحيوان البشري، الهوموسابيان أو العاقل (وحقيقة أنّه عاقل لا تعني أنّه عقلاني أو دوافعه عقلانية) الذي يعتنق الداروينية الاجتماعية بالفطرة، حتى دون أنْ يعرف ما هي. ويُحافِظ على بقائه بخليطٍ لائق من العنف المُتطرّف والاغتصاب وإدمان الجنس. حين يقرأ أليكس الكتاب المقدّس لا تَستهويه إنسانية المسيح ودَعوتُه للمحبّة والسلام في “العهد الجديد”، بل قصص “العهد القديم” عن الحرب والعنف والإبادة والجنس، ويجدُ فيها ضَالَتَهُ! لمَسةٌ جمالية وفنيّة و”تُراثية” يحتاجها أليكس كما تحتاجها “إسرائيل” لتُزيّن الوحشيّة وتُضفي تنويعًا وطَيفًا من الألوان على اللون الأحمر الطاغي للدم.

A bit of the old ultraviolence أيضًا، يُذكّر الصهاينة وتذكّر أفعالهم المجرمة ووجودهم “الشاذّ” بشخصيّة علي الحفني في فيلم الجزيرة – الجزء الأوّل (2007) (التي أدّاها بروعة غير مُستغرَبَة الراحل الكبير محمود ياسين) حين يقول لخليفته منصور الحفني (أحمد السقّا): “الناس اللي زيّنا الدُنيا ديه جنّتهم!” فهذه الدُنيا جَنّة الصهاينة ومن أجلها يفعلون ما يحلو لهم. لذلك، وانطلاقًا من تَصوّرنا هذا، ليسَ مُستغرَبًا أن ترى مُخرِجًا سينمائيًا بارعًا مثل كوينتن تارانتينو مؤيّدًا لـ”إسرائيل”؛ ففي أعماله البشر حقيرون وتافهون ولا قيمة لحياة الإنسان، وحِينَ يُقتَل شاب بالخطأ -كما في فيلم خيال رخيص (1994)– ليس الحدث الأهم هو مقتله، بل كيف سنُنظّف جثّته وأشلاءه والفوضى التي افتعلها قاتل حين ارتكب “القتل بالخطأ”! وهذه ليست مُحاكَمة أخلاقية أو “أخلاقوية” للسينمائي؛ فباعتقادي وبوصفي مُحِبًا مُخلِصًا للسينما، ليسَ لهذا الفنّ العظيم حدود وضوابط أخلاقية وصانع الأفلام ومُوجّهُها المُبدِع والأصيل عليه أنْ يكون لاسُلطويًا، فيرفُض أيّ سُلطة تعلو على سُلطة إبداعه ويتمرّد على كل من يحاول الحدّ من إطلاق العنان لخياله، وفي ذلك حديثٌ آخر في مقالٍ آخر في مقامٍ يَليقُ به.

الناس اللي زيّنا الدُنيا ديه جنّتهم! 
Lots of cream, Lots of sugar إنّ هذا الكيان -باختصارٍ ربّما يبدو مُخِلًا- هو مزيجٌ من إلحاد “عاقل” يوڤال نوح هراري، و”لاعقلانية” إلَه التوراة. وليسَ في هذا المقال أي تأكيدات أو حتميّات حول دينية أو لادينية “إسرائيل”، أو كما يقول نيتشه المذكور في مَتنِه: “ليسَت هُناك حقائق، بل تأويلات”. وتأويلُنا أنّ هذا كيان مادي حتّى النُخاع، لا يأبه بأيّ قيم، والإله غير موجود بالنسبة له، والبقاء للأصلَح، وبالتالي يفعل ما تشتهيه نفسه وما يجعلُه الأقدَر و”الأليَق” على التكيّف مع شروط البقاء، فيَقتُل أعداءه كبارًا وصغارًا دون رحمة، لأنّ هذه الأرض جنّته وليسَ ثمّة من سَيُحاسبُه.. لا محكمة عدل على هذه الأرض، ولا محكمة في أرض أخرى.. أي العالم الآخر، غير الموجود بالنسبة له.

يوڤال أم يهوه؟ -
والتر وايت متحرّرًا من قيد الحياة العارية وصانعًا المعنى في مختبر الموت


«إنّهم كما الموتى الأحياء، على قيد الحياة لدرجة الموت، وميّتون لأقصى درجة من أجل الحياة»
مجتمع الاحتراق النفسي – بيونچ-شول هان
الموت هو أكثرُ احتمالٍ مؤكّد، لكن هل هو أسوأ احتمال؟ بالإمكان الإجابة بسهولة: لا؛ إذْ هُناك ما هو أسوأ بكثير: الحياة نفسها حين نكونُ موتى فيها، أو نعيشُ الموت في حياتنا ومن أجلها! وخيرُ مثالٍ على ذلك شخصيةٌ يعرفها الجميع، ليست واقعيةً لكنّها مخلوقةٌ ومكتوبةٌ من صلصال الواقع الإنساني، وفي رحلتها وتحوّلاتها رمزٌ للإنسان الحالي/المُعاصِر.. أو بالاستعارة من القاموس النيتشوي: الإنسان الأخير.
الحديث هُنا عن بطل مسلسل بريكنچ باد، والتر وايت، الذي تحوّل من قاطنٍ في أرض الاستقرار إلى مسافرٍ في “أرض الخوف”، ومن كائنٍ ميّتٍ في حياته، إلى كائنٍ حيٍ في مماته، حينَ ارتحَلَ من ضَيق حياة الإنسان الأخير، عبر جسر الإنسان الذي لا بُدّ من تجاوزه كما يقول فريدريش نيتشه، إلى سعة ورحابة الإنسان المُغامِر العاشق للخطر، الذي يشعُر بأنّه حيّ لأوّل مرّة وموجودٌ في العالم، الإنسان العائِش في قلب الرعب، المُستَمتِع بـ”الاستجابة الإثباتية للحياة” -التعبير لنيتشه أيضًا- وهو مُرتمٍ في أحضان المغامرَة ومُنتَشٍ بالصِراع مع وحوشٍ أضخم منه!

دور “التورّطات” في التحوّلات
ظاهريًا تبدو حياة والتر آمنةً -إلّا من الناحية المادية- لكنها مُمِلّة! حياةُ رَجُل عائلة، تتلاعَبُ به زوجته سكايلر التي تُحيل إلى الأنثى الفاتنة/اللعوب1 (Femme Fatale) في “الفيلم الأسود/فيلم النوار“2 (Film noir)، وربما لو حُذِفَت شخصيّتها، لما فعل وايت عُشر ما فعله؛ إذْ كانت من المُحفّزات الرئيسة لتحوّله إلى ما أصبَح عليه فيما بعد.. إلى هايزنبرچ، قالب موازين عالم المُخدّرات ومُقوِّض نظامه وقاتل قياصرتِه.
تتحكّم سكايلر بزوجها، فتُحدّد مَعالِم طريقه وتَرسُم له أهداف حياته التي يمشي فيها مُكِبًّا على وجهه، تَكبِت دوافِعَهُ وتقمَعُ غرائِزهُ، فيما هي تَخونُه بلا حَرَج. وكما كانت تفعل الأنثى الفاتنة/اللعوب في الفيلم الأسود، الذي تبدو شخصيّتها متأثّرةً بالسرديّة التوراتية-القرآنية لحَوّاء ودورها في إسقاط آدم من الجنّة، تُمارِس سكايلر ألاعيبها وإغواءها على زوجها لتُسقطه.. لكن ليس بالضرورة من الجنّة إلى الأرض!

ولا يَقتَصِر الأمر على سكايلر، فحتّى أكثر رجال المسلسل “استقامةً”، عديل والتر، الضابط في إدارة مكافحة المخدّرات في ألباكركي هانك شريدر، يلعَب دورًا في تحوّل والتر إلى هايزنبرچ؛ عبر تقليل تقديره له واعتباره شخصًا عاديًا، “نَكِرةً” -حتى ولو لم يُصرّح بذلك- وانتصارُه لأناه على حساب تقزيم “أنا” والتر، وتدخُّله بحياة هذا الأخير وتأثيره على ابنِه مع ممارسته لما يمكن تسميته بـ”استعراض الفُحُولة” أمام عديلِه.
هانك كان يُحِبُّ عديلَه، لكنّه ذلك النوع من الحُبّ الذي يُقدّم للآخرين مَمزوجًا بالاعتقاد بأنّ صاحبه أدرى بمصلحتهم ويحقُّ له ممارسة الوصاية عليهم. ولقد استطاع والتر أن يضع لهذه الوصاية والتدخُّلات حَدًا عند نقطة مُعيّنة.
إنّ الأسرة/العائلة هي بالنهاية وبتعبير مارتن هيدچر “تورُّطات غير مُختارة” وجدنا أنفسنا مُقحَمين فيها. وهذه التورُّطات إمّا أن نَهرُب منها أو نتمرّد عليها أو نَقبَلَها ونتعايَش معها، وقد تمرّد والتر عليها ورفض قمعها له لكن دُونَ أن يَهرُب منها أو يخسرها حتى بعد خُسرانه لحياته؛ إذْ في خِضَمّ تورُّطاته الكبرى، جَاهَدَ ليترُك شيئًا لتورُّطاته غير المُختارة وليحميها من تورُّطاته المُختارة.

العمل مُنتِجًا للمَهانة والمَلَل
هذا تأثير “مؤسّسة” الأسرة/العائلة والزواج، وهناك مؤسّسة أخرى تُشارِكُها دورًا مُهمًا في هذا التحوّل: العمل. حين يكون العمل مُنهِكًا وتحديدًا على الصعيد النفسي بدرجاتٍ أكبر من البَدَني، كما هو حال مِهَن العبودية “الطوعيّة” -نسبيًا- اليوم، فإنّه يقود الإنسان صوب “الاحتراق النفسي” والاكتئاب.. وربما الجنون. وحينَ يكون مُمِلًا، فإنّ المرء يشعر بأنّه سجينٌ داخل روتين قاتل، بأنّه عالقٌ في حلقة مُفرَغَة، بأنّ الحياة تَسبِقُه، ولا يشعُر أثناء رحلتها بشيء، ولا يموت فيها ولا يحيا. أمّا الجنون بدرجاته المختلفة فليسَ مُستَبعَدًا!
عَمَلُ والتر كمُدرّس كيمياء كان جامِعًا بين المَلَل وبين مهانةٍ يتعرّض لها من الجميع، حتى من طلبته! ولم يكن من دافعٍ وراءه إلّا دعم عائلته ماديًا والاستمرار في حياة منزوعة المذاق. أمّا وظيفته الثانية كـ”كاشير” في محطّةٍ لغسيل السيارات، فكانَت شبه مماثِلة لتلك الرئيسة، مع وجبةٍ مضاعفةٍ من الإذلال والمهانة يُقدّمها مدير المحطّة عريض الحاجبين.
والتر وايت، جاك تورانس والجوكر في مواجهة المَلَل
قبل عرض بريكنچ باد بـ28 سنة، أي في عام 1980، كانت هُناك حالةٌ مشابهةٌ لبطله، أخذت مآلاتٍ مختلفة بشكلٍ جذري، لكنّ مزيج العائلة والزواج والعمل والمَلَل والكبت، كان موجودًا لدى الحالتين. الحديث هُنا عن جاك تورانس (جاك نيكولسن) من بريق ستانلي كوبريك. هناك بالطبع عشرات بل مئات التأويلات للبريق، لكنّي أرى أنّ الدوافع الرئيسة وراء تحوّل تورانس إلى الجنون هو المَلَل الذي خَلَقَهُ “تَحالُف العائلة والزواج والعمل”، إلى جانب حياةٍ مكبوتة ومدفونة يبدو أنّ تورانس لم يَعِشها، ويَتمظهَر ذلك في “مشهد البار المتخيّل” وفي عبارته المعبّرة عن غرقه في بحار الجنون والانهيار:
All work and no play makes Jack a dull boyجنون تورانس هو تعبيرٌ عن رفض المَلَل، عن أنّه يريد أن يحيا حقًا وأن يشعر بوجوده في العالم، وربما شعر بالحياة التي كان يَفقِدُها حينَ فَقَدَ عقله، على نحوٍ مشابهٍ لجنون جوكر واكين فينيكس وتود فيليبس الذي أحسّ بوجوده في العالم وبأنّه حيّ، سَاعةَ تَخلُّصه من الكبت وشُعوره بالسعادة مع ممارسته لفعل القتل!
لكن والتر بعكس تورانس والجوكر، لم ينجرّ للجنون؛ لقد استثمر كلّ هذا المَلَل المتراكم وكل هذا الكبت الشامل، ليتحوّل إلى الشيء الذي يجب أن يكونَ عليه، ليُوقِظ الغوريلا المقموعة في داخله ويُطلِق لوحشيّتها العنان، وليشعر بأنّه موجودٌ في العالم وبأنّ هناك حياةً يجب أن تُعاش وبأنّه يجبُ تعويضُ ما فات قبل أن يحين مَوعدُ المَمَات.

إرادة الجنون وإرادة التوحّش
صحيحٌ أنّ و.و مارس فعل القتل مثل الجوكر، لكن ممارسته للقتل لم تَقِف خلفها “إرادة الجنون” كما هو الحال مع مُهرّج چوثام. لقد كان قتلًا عمليًا وبراچماتيًا -إنْ جاز الوصف- يَقتُل لأنّه مُضطرٌ لذلك، ليجلب مَنفَعَةً ويَدفَع ضَرَرًا ولعدم امتلاكه تَرَف التفكير والانتظار أو الاستماع لنصيحة نيتشه “بأن ينتبه جيّدًا ألا يتحوّل إلى وحش أثناء مُنَازَعَة الوحوش”، وقد تحوّل إلى واحدٍ منهم! إنّها إرادة التوحّش الضرورية في عالمٍ وحشي -عالم ألباكيركي الافتراضي وعالمنا الواقعي- سواء كان وُحوشُه مُتحضّرون في المظهر مثل چوستافو “چَس” فرينچ، أو همجيون في المظهر والجوهر مثل آل سالامانكا.
من ذا الذي يَحيَا اليوم؟
إلى جانب “التورّطات” غير المُختارة والعبودية المُختارة -نسبيًا مجدّدًا- التي ساهَمَت بتحوّل والتر وايت إلى هايزنبرچ، ثمّة شيءٌ لا يختاره الإنسان أو بإمكانه اختياره عند انسداد كل الطرق أو حين يكون أفضل الطرق الممكنة، وكان صاحب حصّة مساهمة أكبر في هذا التحوّل الجذري.. إنّه: الموت نفسه!
مع تشخيص السيّد وايت بمرضه، ودُنوِّ الموت منه، لاحَ في الأُفق سؤالٌ كان قد طرحَهُ القدّيس بولس ويَذكُره سلاڤوي چيچيك: “من ذا الذي يَحيَا حقًا اليوم؟”. ماذا لو لم يكن والتر حيًا طيلة خمسين عامًا من بقائه على قيد الحياة؟ ماذا لو كان قد أهدر دفعةً كبيرةً من أقساط عمره من أجل الاستقرار وحارمًا نفسه من الإبحار في صفحات كتاب الحياة من أجل هوامش وحواشٍ على متن هذا الكتاب؟!
مأزق آخر البشر
في سِياق حديثه عن فيلم أطفال الرجال (2006) للمخرج المكسيكي ألفونسو كوارون، يرى چيچيك أنّ هذا العمل ليسَ عن العُقم بوصفه “مشكلة بيولوجية”؛ فانعدام الخَصَب في فيلم كوارون مُعضِلة شخّصها نيتشه منذ زمن بعيد، حين رأى كيف أنّ الحضارة الغربية كانت مُندَفِعَةً في اتجاه “مأزق آخر البشر”، حيث الإنسان مخلوقٌ فَاتِر، من دون أي شغف والتزام عظيم، عاجزٌ عن الحلم، تَعِبٌ من الحياة، لا يٌخاطِر ولا يَطلُب سِوى الراحة والأمن3.
الشيء ذاته ينطبق على بريكنچ باد؛ فهو ليسَ مسلسلًا عن السرطان كمرض، بل عن سرطان “البقاء ما بعد-الميتافيزقي” بوصف چيچيك الذي يقول إنّ “آخر البشر” في ظل هذا البقاء ينتهي به الأمر إلى استعراضٍ فاقدٍ لحياةٍ تُجَرجِر أذيالها كأنّها شَبحُ ذاتها. وهذا حال بطل هذا المسلسل، الذي َكان كذلك ضحيّةً لما يُطلِقُ عليه بيونچ-شول هان بـ”عنف الإيجابية” الذي لا يَفترِض ولا يتطلّب العداء، ويتكشَّف على وجه التحديد داخل مجتمعٍ يتمتّع بـ”السلاسة والدَعَة”، وهاتان الصفتان الأخيرتان كانتا طاغيتان على حياة السيّد وايت وعلى عالمه “المُتحضِّر”.

التقنيات السرديّة للتغلّب على الموت
والتر وايت هو الابن الشرعي لهذا المجتمع “الوديع والسلس”، وقد كان يعيش في كَنَفِه حياةً جرداء/عارية مُكرَّسة من أجل البقاء، خالية من مما يُطلِقُ عليها هان بـ”التقنيات السرديّة التي من شأنها التغلّب على الموت”. كان وايت فاقدًا روح الحياة من أجل البقاء “على قيد الحياة”، وكانت هذه الجملة الأخيرة تأخذ دلالةً سلبية؛ حيث الحياة المُجرّدة هي نفسها القيد الذي يَربِط ويُعيق ويُضيّق ويَخنِق الإنسان.
صناعة المعنى في مختبر الموت
لكن العَدَم وقُربَهُ من ديار وجود وايت، والحقيقة القاسية التي قدّمها الزمان له بأنّ الرصيد المتبقّي منه ليس كافيًا لإجراء المزيد من إتلاف الحياة، جعله يفكّ هذا القيد. وبدأت مسيرةُ التحرُّر من الحياة العارية الجرداء مع صناعة والتر شبه العاري في الصحراء الجرداء للميثامفيتامين في عربة الكرفان، وكان في تلك اللحظة قد استهلَّ مشوار صناعة المعنى وطهي السرديّة في مختبر الموت، وكان لتفاعُل البقاء مع قُرب الفناء مفعولٌ سحري؛ إذْ أخرَج الحيَّ من الميّت وكانت المنايا أماني ذاك الرجل الشاعِر بالحياة الحقّة غير منزوعة السحر!
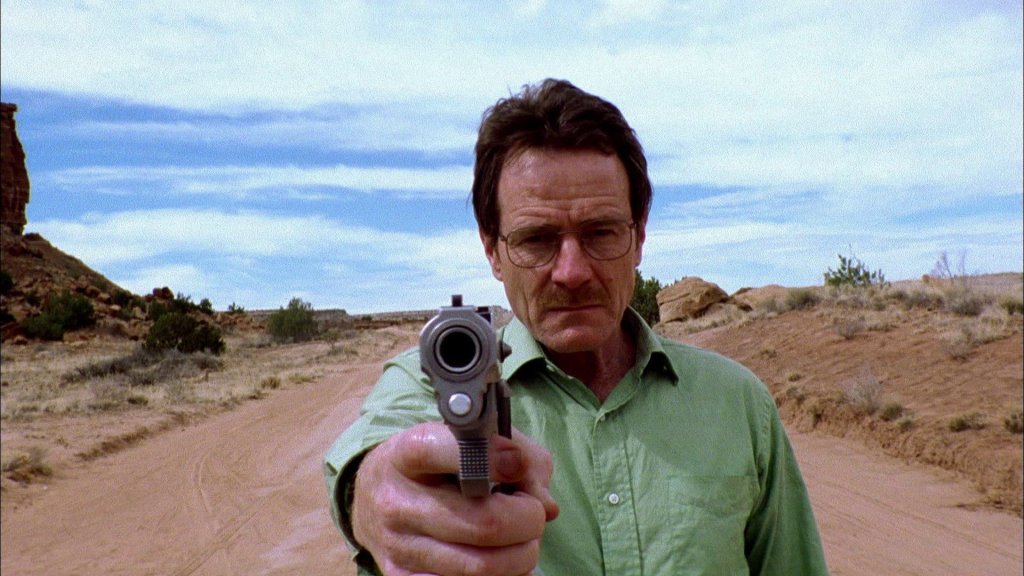
انغَمَسَ والتر في مشروعه الواهب للمعنى وأعطى لهُويّة صاحب المشروع الجديد اسم هايزنبرچ، ومشروعه هذا كان مقرّه في أرض الخوف -باستعارة عنوان فيلم المخرج المصري الكبير داود عبد السيّد والراحل الخالد أحمد زكي-، وأعمالُه كانَ يُديرُها في مكاتب الخطر. أمّا الموت فأصبح تهديدُه مَضاعَفًا؛ إذْ تدخّل البشر فيه إلى جانب مرضه، لكنّه مع كل مرّة كان يتلقّى فيها تهديدًا، يتجاوز ذلك ليُصبح هو التهديد. وفي كل مرّةٍ يُمارِس فيها فعل القتل، فيُنهي حياة عدوّ ويُرسِل خصمًا برحلةٍ بلا عودة إلى العدم، كان يُشكّل حياتهُ من جديد ويَخلِقُ طريقته في الوجود.
وكلّما ارتفع منسوب الخطر والمغامرة في “مشروع هايزنبرچ” الواهب للمعنى، كان يَشعُر صاحبهُ بوجوده في العالم، ومع كل مواجهة مع العدم.. كان يصبحُ “فردًا موجودًا” على حد تعبير كيركچرد، ورُّبَمَا كان القتل فِعلًا “شرّيرًا” لكنّه خلق لوالتر حياةً “خيّرة”، فكما يقول كيركچرد: “الحياة الخيّرة لدى الشخص هي تلك التي تُحقّق الشرط المُتعلّق بالعيش بوصفه فردًا”.
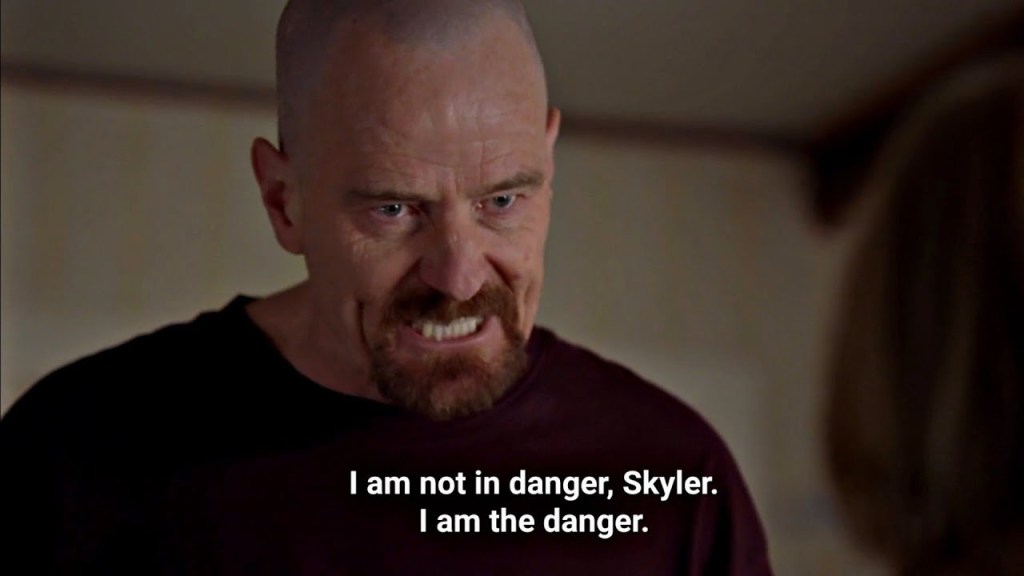
جدلية السيّد والعبد أو: القدرة على الموت
في سياق حديثه عن جدليّة هيچل للسيّد والعبد، يقول بيونچ-شول هان، إنّ الطرف الذي يَخرُج كسيّدٍ هو ذاكَ الذي لا يخافُ الموت، حيث الرغبة في الحريّة ونيل الاعتراف والظفر بالسُلطة، تَستَنهِض السيّد لتجاوُز الاهتمام بالحياة العارية. ويُضيف هان بأنّ الخوف من الموت هو ما يدفعُ العبد مُستقبَلًا إلى إخضاع نفسه للآخر؛ إذْ يُفضّل العبودية على التهديد بالموت ويتمسّك بالحياة العارية. ويرى بأنّ ما يُثبَت بوصفه عنصرًا حاسمًا في هذه الجدليّة الهيچلية هو “القدرة على الموت”، وهؤلاء الذين لا يملكون الحريّة التي من الممكن أن تُكلّفهم حياتهم، لا يملكون المخاطرة بهذه الحياة، وبدلًا من مواصلتهم للقتال حتّى الموت فإنّهم يُفضّلون أن يظلّوا وحدهم داخل الموت!
إنّ التحوُّل من والتر وايت إلى هايزنبرچ، من رَجُل العائلة الضعيف الهزيل وصاحب العمل المُمِلّ إلى صانع الكريستال ميث ثم صاحب إمبراطورية مخدّرات يجني من ورائها مئات الملايين ومُصارِعٍ ماكر لأشرَس الوحوش، هو تحوّلٌ من العبد المُخضِع نفسه للآخر (الزوجة، العائلة، رب العمل، المجتمع، القوانين…) الوحيد داخل موتٍ في الحياة، إلى السيّد الذي يعترف به الجميع، الظافر بالسلطة، المالك للحريّة، و”صاحب السيادة” -عند نيتشه- القادر على خلق أوقات الراحة، والقادر على الموت وقدرته هذه تمنحهُ حُريّةً وحياةً حقيقيّة. هذا التحوّل أماتَ العبد الذليل المُمِلّ العالِق في “مأزق آخر البشر”، وأحيَا نقيضَهُ، ذاك الذي يتحدّث عنه نيتشه: الحامل لشيءٍ من الفوضى كَي يَلِدَ نجمًا راقصًا!

بهجة المُضيّ قُدُمًا لمُقابلة الموت
بعكس الحكايات والقصص التي يَفرُّ فيها الإنسان من الموت أو يختبئ منه في بروجٍ مُشيّدة لكن دون جدوى فيُلاقيه في النهاية ويُدركُه أينما كان، توجّه والتر وايت شَطرَ الموت، مُقتَفيًا أثر هيدچر الذي يرى بأنّ “الدازاين” (وجود الإنسان)4 لا يكون أصيلًا بحقّ إلّا في توجُّهِهِ شطر الموت، مُنتَشيًا لا من الميث الذي كان يصنعه دون أنْ يتعاطاه، بل من المُضِيِّ قُدُمًا لمواجهة الموت، ليكونَ مُضَادًّا لأولئك “الموتى الأحياء”، وواحدًا من الّذين يَحيونَ أثناء حياتهم عبر موتهم، الذين تَكمُن ماهيّتهُم في الوجود، وكينونتهم في الحَيَويّة.
الحَيَويّة التي يُفترَض أن تكونَ نقيضًا للموت والعَدَم، تُوجَدُ في حُضنِهِما، في قبلةٍ منهما، ليكتَسِبَ الوجود الإنساني “المُؤقّت” صِفَة “الخلود” حتّى بعد نهايته وليتمتَّع بالحضور في ظلِّ غيابه، كما هي أُسطورة هايزنبرچ -وربما سول چودمان حين اتّخذ جيمي ماكچيل قرار الاعتراف بجرائمه وتحمّل السجن المؤبّد لصناعة شيء من المعنى وتخليد أسطورته– حتى بعد مرور 10 سنوات على نهاية هذا العمل الذي يبدو أنّ مُهندِس كونِه الأعظم ڤينيس چيليچان قد زوّدَهُ بخاصيّة أن يكونَ مُضَادًا للزمان، فلا يتأثّر بالوقت، كما هو موضوع “الحياة والموت”.

مصادر:
– هكذا تكلّم زرادشت – فريدريش نيتشه، ترجمة: علي مصباح، منشورات الجمل.– نقيض المسيح – فريدريش نيتشه، ترجمة: علي مصباح، منشورات الجمل.
– ما وراء الخير والشر – فريدريش نيتشه، ترجمة: جيزيلا فالور حجّار، مراجعة موسى وهبه، دار الفارابي.
– دليل أكسفورد في الفلسفة – تحرير: تِد هُندرتش، ترجمة د. نجيب الحصادي.
– المُعجَم الفلسفي – د. جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة.
– مجتمع الاحتراق النفسي – بيونچ-شول هان، ترجمة بدر الدين مصطفى، منصّة معنى.
– مُعاناة إيروس – بيونچ-شول هان، ترجمة بدر الدين مصطفى، منصّة معنى.
– العنف: تأملات في وجوهه الستّة – سلاڤوي چيچيك، ترجمة فاضل جتكر، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
– مرحبًا في صحراء الواقع – سلاڤوي چيچيك، ترجمة أحمد حسّان، دار العين للنشر.
– الكينونة والزمان – مارتن هيدچر، ترجمة: د. فتحي المسكيني، مراجعة: إسماعيل المصدق.
هوامش:
1 . حول الأنثى الفاتنة/اللعوب (Femme Fatale)، يمكن قراءة مقال قديم كتبناه عام 2016. وقد قامت جريدة الأنباء الكويتية بالسطو على المقال ونسبه إليها بعد عامين ونصف تقريبًا من نشر جابر حيّان للمقال عبر صفحته على الفيسبوك، لذلك اقتضى التنويه.
2 . للمزيد حول الفيلم الأسود/فيلم النوار، يمكن مُراجعة هذا المقال من ويكيبيديا، بترجمة مهنّد الجندي.
3 . لاحقًا يتساءل چيچيك: “أليس هذا التناقض الذي أطلقَ عليه نيتشه عدمية “سلبية” و”إيجابية”؟ ويُقارِن بين الغرب و”الإسلاميين الراديكاليين”، فيقول: نحنُ في الغرب “الرجال الأخيرون” غارقون في بحرٍ من المُتَع والملذّات اليومية البليدة والغبيّة، فيما “الأصوليون الإسلاميون” مُستعدّون للمخاطرة بكل شيء ويَنخَرطون في صراعٍ عَدَمي وصولًا إلى مرحلة تدمير الذات!” (المصدر: العنف: تأملات في وجوهه الستّة).
4 . دازاين (Dasein) هي كلمة ألمانية مركّبة من da (هُنا، هناك) وsein (يكون)، وهي حرفيًا تعني: أن تكون/توجد هُناك. وعند هيدچر هي كينونة الموجود الإنساني أو كيفية وجوده. ولمّا كان العالم في تبدّل مستمر كانت هذه الكينونة الإنسانية غير مستقرّة على حال. وماهية الإنسان هي وجوده، وحقيقتُة هي نزوعه إلى ما يريد أن يكون؛ فهو إذن يحدّد ذاته بذاته وينسج جميع إمكاناته بيديه، ويجاوز بفعله حدود الواقع وينفتح على العالم. (المصدر: المُعجَم الفلسفي ودليل أكسفورد في الفلسفة).
مصادر:
– هكذا تكلّم زرادشت – فريدريش نيتشه، ترجمة: علي مصباح، منشورات الجمل. -
بانشيات إنيشِرين: عن هشاشة الصداقة وقساوة الملل.. أو الأصالة في مواجهة النرجسيّة وتسليع الروابط الإنسانيّة
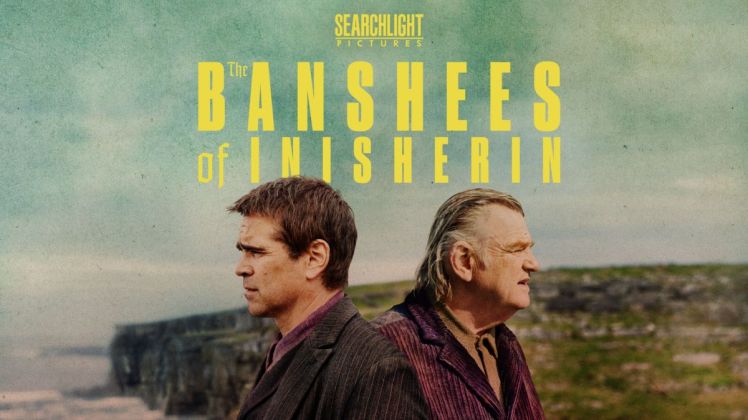

للوهلة الأولى قد يبدو إنهاء العلاقة بين “الصديقين الحميمين” في فيلم بانشيات إنيشِرين أمرًا مستغربًا ومستهجنًا و”قاسيًا”؛ فَلمَ الآن وبعد مُدّة طويلة تُنهى علاقة صداقة بدافع الملل ولأنّ طرفًا فيها أدرك أنّه ما عاد يُحبّ الطرف الآخر وأنّ أَمامَهُ بقايا حياة تستحقُّ أن تُعاش في الفن والتجارب لا في الأحاديث المملّة؟!
الصداقة على دفتر حسابات التسلية والملل
لكن إنهاء الملل لهذه الصداقة ليسَ أمرًا مستغربًا تمامًا -وإن كان لا يخلو من الاستنكار-؛ فلهذه القوّة التي تُشارِك الموت والمرض حرفهما الأوّل، قدرة جبّارة على تدمير علاقات حب وزواج وصداقة، وبإمكانه في حالاته المتطرّفة أن يقود للجنون، كما فعل في “بريق” ستانلي كوبريك، حين لعب الملل دور المحفّز لجنون بطله “الكاتب” وشُروعِه بقتل زوجته المُملَّة وابنِه المُضطَرِب وكتابة نهاية مُريبة لحياته. لكن علينا أن نسأل هُنا: كم كانت هذه الصداقة قوية؟ هل كانت صداقةً حقيقية أساسًا ونحنُ لا نعرفُ عنها الكثير سوا كلام أهل جزيرة إنيشِرين المُتخيّلة عن “الجدالات المُتجدّدة” لهذين الصديقين كولم (برِندون چليسون( وبادريك (كولِن فارِل). السؤال الأهم والأولى طرحه: هل الصداقة خاضعة لحسابات الملل والتسلية؟
الجواب على آخر سؤالٍ يبدو صعبًا أو مُعقّدًا؛ فالصداقة كما نعرفها وألفناها أو كما يُفترض تصوّرنا حولها: صلبة، متماسكة، ولا تعيش حالة دائمة من التبدّل والتحوّل والتنقّل. ومَن نُسمّيه صديقًا مقرّبًا، نعرف أنّ بيننا وبينه ما يتجاوَز تبادُل المنافع الماديّة وإن كان من الطبيعي وجودها لكن لا تكون هي الأساس. كذلك نعلم أنّه ليس مطلوبًا منّا لعب دور المُهرّجين أو الحكواتيين لبعضنا، ُنسلّي ونخفّف عن بعضنا لكن لا نعمل في وظيفةٍ بدوامٍ كامل كمرفّهين لبعضنا. وليس شَرطًا للصداقة أن يكون أطرافها نُسخًا عن بعضهم (هُنا إحالة لإدراك كولم بأنّ بادريك لا يُشبهُه وبأنّه أكثر عمقًا وتركيبًا منه) كما في الحُب أيضًا. ببساطة ثمّة الكثير من العفوية والبساطة والأصالة في الصداقة، وهذه الصفات كانت موجودةً في بادريك.
البشر كسلعٍ في السوق الحرّة للتواصُل
لكن حينَ نُصبح نحنُ أنفسنا سلعًا، لا بالنسبة لرأس المال، بل لبعضنا، في السوق الحرّة للتعارُف والتواصُل، على الفور تَخضَعُ الصداقات لحسابات التسلية والمتعة، وتُبنى على تبادل ومُقايَضَة سلعٍ ذات طبيعة غير تجاريّة لكنّها لا تخلو من تجارة. وعند هذه النقطة تحديدًا يمكن فهم هذا التغيير الذي أنهى العلاقة والتحوّل الذي طرأ على شخصية كولم، فجعله ينظر للأشخاص من حوله كسلعٍ تُجرَّب ويُستفاد منها وتُستهلَك ليتم قذفها في مكبّ نفايات العلاقات، وهذا الشيء ينطبق على عالم الروابط الإنسانية اليوم أكثر من أيّ وقتٍ مضى، وإن كان حاضرًا في الفيلم الذي تدور أحداثه قبل مائة عام تقريبًا.
منذ مطلَع هذا العمل الذي أخرجه صانع الأفلام والمسرحي الأيرلندي البريطاني مارتن ماكدونا، صاحب “في بروج” (2008) و“المختلّون السبعة” (2012) و” ثلاث لوحات خارج إيبينغ، ميزوري” (2017)، نرى لقطاتٍ لأقنعةٍ داخل بيت الموسيقي المثقّف كولم، ربما تُخبِرُنا بأنّ الرجل عاشقٌ لارتداء الأقنعة وأنّه طيلة علاقته ببادريك كان يرتدي واحدًا منها هو قناع “الطيبة” و”اللُطف”، ليخفي وجهه الحقيقي النرجسي، مع أنّه ينكر هذه النرجسيّة، كما ينكر إصابته بالاكتئاب، لكن الاكتئاب والنرجسيّة في حالة كولم صِنوان لا يفترقان.

الأًسر في جحيم النفس
في كتابه مُعاناة إيروس1، يرى الفيلسوف الألماني من أصل كوري جنوبي بيونچ-شول هان، أنّ الاكتئاب في الأصل هو مرضٌ نرجسي، والذات النرجسيّة المُكتئِبَة تَستنزِفُ نفسها وتتداعى من تلقائها، وهي بدون عالمٍ يَسكُن فيها وقد هُجِرَت من قبل الآخر. ويبيّن هان، أنّ الاكتئاب يعمل على استغراق الذات داخلها وتقوقعها، لتبحث “ذات-الإنجاز النرجسيّة” -كما يَصِفُها- عن النجاح الذي يتحقّق عبر الاستحواذ على الآخر، فتسعى لسلب الآخر من آخريته، ليرتدّ إلى مرآتها؛ مرآةٌ تؤكّد صورة الأنا فقط.
هذا التوصيف يمكن بكل سهولة إسقاطه على كولم: ذاتٌ نرجسيّة مُكتئِبَة، وقبل أن يَهجُر صديقه بادريك، كان هو ذاتهُ مهجورًا من فكرة الآخر ومتقوقعًا في أناه، ولقد تخلّى عن صداقة بعيدة عن المصالح، ليُجرّب مذاق صداقات جديدة يبحث من خلالها عن النجاح والإنجاز من خلال سَلب الآخر من آخريته ليتردّ إلى مرآته التي تؤكّد صورة أناه. لم يستَطِع كولم سلب آخرية بادريك وجعلها مجرّد صورة عن أناه.. فَنَبَذَهُ، ولم يَجِد مُخرَجاتٍ من هذه الصداقة سوا تبادُل الأحاديث وتناوُل الكحول، فنفاه.
يتظاهَر كولم بأنّه مرتاحٌ بهذا الوضع، أو ربما يَظنّ بصدقٍ أنّه كذلك، لكنّ المُعلَن عن مُحيّاه وما تنطق به أفعاله يشي بعكس ذلك: تدخينه بأسىً لوحده ووحيدًا، اعترافاته للراهب في الكنيسة، وحتّى ما فعله بأصابعِه الخمسة، وهذا الفعل الأخير تحديدًا يَكشِفُ عن نرجسيةٍ مُكتَئِبَةٍ مُختَلِطَةٍ بابتزازٍ عاطفيٍ لصديقٍ تم هَجرُه: إذا كنت تهتمّ لأمري وتحبّني فعلًا، لا تَكُن سببًا في فقداني موهبتي المُعتَمِدَة على أصابعي! إنّ كولم بلا شك مُنجِزٌ وناجحٌ بعكس صديقه بادريك، لكن وكما يقول هان -مجددًا- إنجازاته الاكتئابية تغوص في نفسها وتختنق في داخلها، وهو وإن بدا مُفعَمًا بالإيجابية إلّا أنّه “أسيرٌ في جحيم نفسه” بحسب توصيف هان الدقيق والبديع.
على الضفّة المقابلة، ثمّة النقيض والضدّ لكولم، صديقه “السابق” بادريك، الذي يجد ذاته في الآخر كما هو ويذوب فيه دون أن يصبحَ صورةً عنه. بادريك بسيط و”أصيل”، يُجاهِد لإصلاح العَطَب الذي حلَّ بعلاقته مع صديقه، إيمانًا منه بأنّ الناس ليسوا قطع غيارٍ يمكن استبدالهم في أيّ وقت، ولا يتعامل مع الصداقة كموضوعٍ للاستهلاك. من خلال علاقته بحيواناته، نأخذ فكرة عن أصالة بادريك ورِفقِه، مع أنّ هذا الرِفق يُصبُح محطّ سخرية الآخرين، وأحد الأسباب التي تدفع صديقه كولم لوضع حدٍّ لهذه الصداقة! لكن حتّى رفق بادريك لا يدوم.. فبعد موتِ حمارته التي يُحبُّها ويَرفِق بها، يحدث تحوّلٌ في شخصيّته يجعله يفعل ما هو عكس الرفق تمامًا، فيَحرِقُ منزل صديقه.

الحرب الكُبرى مَفرَخة لحروبٍ صُغرى
في خلفية هذه الصداقة منتهية الصلاحية، ثمّت حربٌ طاحنة وطازجة: الحرب الأهلية الأيرلندية، وقد يبدو هذا الصدع الآخذ بالتوسّع في العلاقة بين الصديقين مجرّد إسقاطٍ رمزي لهذه الحرب، وهذا الرأي الأخير، مذهبٌ قد يذهب إليه الكثيرون، فيختزلون قصّة هذه الصداقة المُتآكِلَة في الحرب الأهلية، في شخصٍ بسيط غير مبالٍ بها، وآخر عميق وملتزم وثوري. يبدو هذا الفهم أو التأويل للفيلم متماسكًا ومنطقيًا جدًا، لكنّي أميل إلى الاعتقاد بأنّ الأفراد وصراعاتهم مع أنفسهم والآخرين من حولهم هي المركز والمَحوَر، أمّا الحرب بين المؤيّدين والمعارضين للمعاهدة الإنكليزية الأيرلندية، فتبدو في الهامش.
لا شك، أنّ الحرب -أيّ حرب- على أرض الواقع هي الأساس والمِحوَر، وهي المُؤثّرة في ما حولها، والصانعة للتحوّلات والخالقة لشّتى أصناف الأزمات. لكن في هذه القصّة يتم الابتعاد عمّا هو جمعي وتصغير الحرب الكبرى، لتكبير الحروب الصغرى بين الأفراد، وتقريب نزاعاتهم الفردية من المركز أكثر. وربما لا أعرف كثيرًا عن الحرب الأهلية الأيرلندية، لكنّني أعرف الكثير عن الحروب الأهلية في منطقتنا العربية، وعن تفريخها لحروبٍ أُخرى، صغيرة الحجم، قويّة التأثير، تدور رحاها بين الناس العاديين، بين أفراد يكونون في كثيرٍ من الأحيان عن مركز الصراع وبؤرة الصراع بعيدين، وبطريقة ما وبالنسبة لهؤلاء الناس تُصبِحُ هي الأساس!
مزيجٌ سُريالي
لكن هذا الفيلم لا يتوقّف عند حدود كأسٍ من مزيج الصداقة والحرب التي تؤثّر بها أو الملل الذي يَسحقُ عظامها الهشّة، إذ يتجاوزها ليقدّم كوكتيلًا من الكوميديا والتراجيديا مع كسرِه بالسواد القاتم، يتم إعداده على يد ساقٍ مُحتَرِف وصاحب عدّة كتابية ومهارات إخراجية غير عادية، هو مارتن ماكدونا. يخلِط ماكدونا ببراعة بين ما هو عادي -أو اعتيادي- كالصداقة والرِفقة وبين ما هو غريب ومنفّر ومُريب مثل قطع كولم لأصابعه الخمسة. وعلى سيرة هذا القطع، هُناك ذاك المشهد الذي يُجهِز فيه كولم على آخر أصابعه ويمشي باتجاه بادريك وشقيقته والدمّ يَقطُر من يده مبتورة الأصابع. لو قُطِعَ هذا المشهد من سياقه، ولو شوهِدَ لوحده خارج أسوار الفيلم دون أنّ نعرف شيئًا عن خلفيّته، لبدا مشهدًا من فيلم رعبٍ دموي.

كذلك، يَحضُر غموضٌ ممتزجٌ ببُعدٍ ماورائي، يتمظهَر في ميتاتٍ لا ندري كيف حدثت، وفي تلك المرأة العجوز “السيّدة ماك كورميك” المتنبّأة بتلك الميتات، والتي يتمحوَر عنوان الفيلم حولها؛ إذ تبدو هي تلك “البانشية” أو الجنية/الحورية (ليست ترجمة دقيقة)، وهي روحٌ أنثوية أسطورية من التراث الأيرلندي، تنذر بالشؤم واقتراب الموت، عبر الصراخ والنحيب. هذه العجوز/البانشيّة تبدو وكأنّها في دارٍ للعرض السينمائي تستمتع بمشاهدة أشخاصٍ يموتون في الحرب وآخرون عاديون يموتون بشكلٍ عاديٍ لدرجة التفاهة على شاشة هذه الجزيرة، وتُتابع وهي تدخّن غليونها مسلسل موت صداقة وقتل علاقة.
في شخصية هذه العجوز الأشبه بملك موتٍ خاصٍ بهذه الجزيرة المُتخيّلة المعزولة، ثمّة إحالة إلى شخصية الموت في فيلم الختم السابع (1957) لإنچمار بيرچمان، لكن عوضًا عن ممارسة البطل العائد من الحروب الصليبية، للعبة الشطرنج مع الموت نفسه من أجل البقاء، يلعب الموت نفسه الشطرنج بسكّان الجزيرة -الذين لا ليس بينهم أيّ بطل- وبأولئك الذين تدور بينهم رحى الحرب. والإحالة لا تستدعيها شخصيّةٌ واحدة فقط، بل أيضًا الموت المُشتَرَك القابع في الخلفية؛ ففي بانشيات إينشِرين، ثمّة نذيرُ شؤم بخاتمةٍ أو خواتم سيئة يلوح بالأفق بفعل الحرب وتبعاتها وإفرازاتها، وفي الختم السابع هناك نذيرٌ بخاتمة سيئة هي الموت بسبب الطاعون الأسود.

بين جزيرة ماكدونا ومنارة إيچرز وطيور هِتشكوك
يذكّر بانشيّات إينشِرين كذلك، بفيلمٍ آخر صدر عام 2019: عملٌ تعتريه حالة من القلق والارتياب وانتظار شيء مشؤوم في النهاية، المنارة الذي أخرجه الشاب روبرت إيچرز. تتشابه المنارة مع جزيرة إينشِرين من حيث هيمنة الغموض عليها واستعمار الرعب المجهول لها. أيضًا ثمّة رابطٌ روحي بين العجوز الناحبة المنذرة بالشؤم وحورية بحر منارة إيچرز التي تظهر في خيالات وهلاوس الشاب توماس هوارد (روبرت باتِنسون) وتتلاعب فيه ليمضي قدمًا في مسعاه الخائب لاكتشاف سرّ المنارة.. لتمهّد له طريق السقوط في حفرة أعظم أسرار الوجود.. العدم!
وفيما يتعلّق بالرعب غير المفهوم والغموض العصيّ على التفسير، يُحيل الفيلمان إلى طيور الإنكليزي ألفريد هِتشكوك؛ ففي الأعمال الثلاثة ثمّة رعبٌ ما ورائي، حيث تتصرّف الطيور والنوارس وشخصيات إينشِرين على نحوٍ لا يمكن فهمه بالعقل أو تفسيره بالعلم -في فيلم الطيور تُحاوِل إحدى العالمات تفسير الظاهرة بأدوات العلم وتفشَل!- ممّا يُعطي إحساسًا بأنّ هذه المخلوقات الطائِرة تتخبّطها الشياطين من المسّ أو تتلبّسُها أرواحٌ شريرة أو هي نتاجٌ لمؤامرةٍ مُعقَّدةٍ يستحيلُ فهمها بأدوات العلم والمعرفة، لأن مصدرها خارجي/غير بشري. في جزيرة إينشِرين لا تتمثّل هذه القوّة الماورائية في كياناتٍ محدّدة، إنما تبدو موجودةً بشكلها المجرّد، كقوةٍ خفيّة تلعب بكلّ شيءٍ حيّ حتى تسلب منهُ الحياة.

جبل الجليد الغائر
لكن ما هو غير مفهوم، لا يقتصر على ما هو “ماورائي”؛ فهناك ما يشبه “جبل الجليد الغائر” وتحديدًا في شخصيات البطلين، اللذان تبدو الكثير من جوانب حياتهما غير مفهومة: لِمَ يغيب البعد العاطفي/الرومانسي عن حياة الرجلين؟ وكم يبدو منطقيًا ما ألمَح إليه الراهب في الكنيسة من علاقة مثلية كانت تجمعُ بينهما؟ مع استبعادها في سياق الفيلم، لكن في سياقٍ آخر قد تبدو جدًا مُحتَمَلة! لا حُبّ ولا علاقات جنسية في حياة بادريك وكولم، وقد يبدو الأمر مفهومًا في حياة الأخير بالنظر إلى سنّه وتجاربه، لكنّه ليس كذلك مع الأوّل، مع بادريك الرجل الطفل، البالغ غير الناضج، الذي لا يزال يعيش مع أخته وتربطه بها علاقة اعتمادية -وربما قد نُغالي ونَصِفُها بالطُفيلية- تبدو فيها أقرب للأم من الأخت.
إذًا لا يَقتَصِر اضطراب الشخصية على كولم، فحتّى بادريك ذلك البسيط الأصيل العفوي، مُضطَرِب،؛ فإضافةً إلى عدم نضجه وعلاقته الاعتمادية بشقيقته، يُوحي رفضه لقطع علاقة كولم به وردود فعله تجاه هذا القطع، بأنّه يعاني من بعض أعراض “اضطراب الشخصيّة الحدّية”، ممثّلة في صعوبة تحمّل الوحدة، والرعب من الهجر والخوف من الفقد، التي بدأت تظهر منذ أن قرّر كولم إنهاء كل شيء، مرورًا برحيل أخته بعيدًا عنه لكل تعيش حياةً طبيعية. ومع أنّها لا تعني إصابته بهذا الاضطراب تحديدًا كون الأعراض الأخرى لا تظهر عليه ولا نراها، لكن ملاحظة هذه الأعراض الظاهرة أمرٌ تجدر الإشارة إليه.
التوزيع العادل للاضطرابات على جزيرة الموت
ومع ذلك، يُمكن الردّ على ما سبق، بأنّ بادريك بحكم أصالته وبساطته وعدم تعامله مع البشر كقطع غيار -كما ذُكِرَ سابقًا-، رفض قطع علاقةٍ وثيقة، واختار أن يكون عنيدًا ولا يمضي قدمًا في حياته ولا يتنازل عن إقامة شخصٍ في مساكن قلبه، لكن الشعرة الفاصلة بين ذلك، وبين أعراض اضطراب الشخصية الحدّية، من الصعب العثور عليها وبالتالي الخروج بقولٍ فصل في حقيقية ما يجري. لكن الواضح أنّ هناك اضطرابًا.. في الحقيقة هذه الجزيرة يتوزّع الاضطراب فيها على الجميع بالتساوي (الشرطي المضطرب الممارس للعنف ضد ابنه، وابنه التائه، وحتّى سُقاة الحانة وروّادها وربّما حيوانات الجزيرة (وهُنا عودة إلى الجانب الماورائي!).
القطيعة السهلة ضد القطيعة المستحيلة
إنّ باب بانشيات إنيشِرين مفتوحٌ على عشرات التأويلات والقراءات، ولا يَعلَم تأويلها الحقيقي إلّا صانعُه مارتن ماكدونا والراسخون في الفيلم! لكن بعيدًا عن التأويلات وقريبًا مما هو شخصي ومُلامِس أكثر للفردي ولليوميّ المُعاش، تبقى الصداقة والملل والعلاقات هي نواة هذا العمل، ومن الصعب عمل قطيعة معها ونحنُ نشاهد قصّةً عن قطيعة مع صداقة وطيدة، لنستحضرَ صداقاتٍ مقرّبة آمنّا بأنّه لا يُفرّقها الدهر وانفرط عقدها في بضع سنين، وصداقاتٍ أخرى كنّا المبادرين لإنهائها، لا لأنّنا كنّا نتعامَل معها كموضعٍ للاستهلاك، إنّما لأنّها كانت تستهلِكُ حياتنا، ونباتات صداقات أخرى ذبلت أوراقها مع الأيام، مع عدم سقايتها بالقُرب الجُغرافي وتأثّرها بتغيّر الاهتمامات وتعاظم الالتزامات، لكنْ هُنا على المرء أن يسأل مجدّدًا وبجدّية أكثر: هل كانت كل هذه صداقات؟!
في النهاية يبدو من من السهل نسيانُ الحرب بكل واقعيّتها الفجّة وعمل قطيعةٍ معها، لكن الأمر ليس كذلك مع الصداقة والمشاعر التي تأتي من ضمن عبوّتها والعواطف التي تتخلّلها والذكريات التي تبقى منها والجروح التي تُخلّفها؛ فالقلب يتقطّع لهجر الأوهام، لقلّة ما في الإنسان من حقيقة2، كما جاء على لسان الكاتب الفرنسي فرانسوا-رينيه دو شاتوبريان ذات مرّة.

مراجع:
- مُعاناة إيروس – بيونچ-شول هان، ترجمة بدر الدين مصطفى، منصّة معنى.
- من مقدّمة الترجمة العربية، لكتاب جان بودريار “المُصطَنَع والاصطناع”، ترجمة جوزيف عبدالله، المنظّمة العربية للترجمة.
-
الحارة يَصدِم سكّان «حارة الواقع» ويَنقُل الهامش إلى المركز


قد يأتي الانطباع الأوليّ عن فيلم “الحارة” الأردنيّ، على هيئة سؤالٍ تَعجُّبيّ: كيف لعملٍ بهذا الشكل أن يكونَ أردنيًا؟ لكن الفيلم ذاته يُثبِت أن هذا السؤال فيه شيءٌ من السطحيّة والاختزاليّة وأن التعجُّب ليسَ في مكانه أبدًا؛ إذ يَكشِفُ لنا أنّ عمّان ملاى بكمٍ هائلٍ من الإمكانات، والحديث ليسَ محصورًا بالإمكانات التقنية والإخراجية التي تُفاجئنا، بل أيضًا بتلك البشريّة المُمثّلة بطاقمٍ يُفجّر طاقاتٍ كامنة، والأهم الإمكانات المكانية لعمَّان كمدينة، التي تَنبَجِسُ في الكاميرا على نحوٍ لم نشهدهُ من قبل. والأمر ليسَ حول أنّها تبدو أجمل على الكاميرا من الواقع، بل في ظهورها كما هيَ بكل ما تحمِلُه من جماليات في مَكامِن خللها ومواضِع عُيوبِها.
ليسَ ثمّة مُبالغة، حين نقول إنّ الفيلم الذي كتبه وأخرجه الأردني باسل غندور عام 2021، يَطفَح بالمفاجآت والصدمات، فمع أوّل دخول إلى الحارة يتكوّن شعورٌ بأنّ قصّة علي (عماد عزمي) ستأخذ منحى درامي – رومانسي، وربما سيحظى بنهايةٍ متوقّعة، شبه سعيدة، حيث علي سينالُ ما يُريد بعد تجاوز مِحَنِه مع نفسه قبل الآخرين، أو رُّبَمَا نهاية على النقيض تمامًا لكنّ علي يستحقّها، حيث نراهُ مسجونًا أو قتيلًا على يد البلطجي عبّاس (منذر رياحنة) وعصابته. لكنّ الحارة صعد طابقًا آخر فوق أعلى قمّة أسوأ الأحوال” وقفز منها، ليُقتَل علي فعلًا، لا على يد عبّاس بل بمِقَصِّ تَغرِسُه أسيل (نادرة عمران) صاحبة صالون الشعر وأم حبيبته لانا (بركة رحماني) في رقبته بالخطأ.
هناك جُثّة.. لا أريد للسجّادة أن تتلطّخ بالدماء!
كم يبدو هذا “القتل بالخطأ” صادمًا لنا ومُروّعًا لقلوبنا؟ جدًا! لكنّه لا يعني شيئًا لأسيل! وبعكس توقّعاتنا، لا تأتي الشرطة وتُلقي القبض عليها أو تُسلّم نفسها أو تنجو وتعيش بصُحبة تأنيب الضمير، بل يكون هَمُّها الأكبَر أنْ لا تتّسخ سجّادة صالونها بدم علي، في ما يُشبه إحالةً إلى أفلام كوينتِن تارانتينو وتحديدًا Pulp Fiction في الجزء المُعنوَن بـThe Bonnie Situation.أما زوجها السابق “توتو” (نديم الريماوي)، فيتخلّص من جثّة علي بحرقها في حاوية قمامة في مكانٍ مكشوفٍ شرق عمّان وكأنّه يتخلّص من مجموعة صورٍ وذكريات غير مرغوبٍ فيها، بإطعامها للنيران!
مرحبًا في حارة الواقع!
كل هذا يبدو مُستهجَنًا ولامعقولًا ولا إنسانيًا بالضرورة، لكنّه -بالضرورة أيضًا- ليس خياليًا، إنّها حادثة تَحدُث وواقعة تَقَع في حارة الواقع الكُبرى، سواء في شرق عمّان أو غربِها وبعيدًا عن عمّان وفي كل مكان في هذا العالم! فالإنسان عند استسلامه لقانون هذه الحارة وحينَ تجرفه سيولَتُها الأخلاقية، سيفعل كل شيء ممكن، سيستَبيح الآخرين وسيرضى بأن يُستباح لأجل أن يُحافظ على بقائه في الحارة.
ومن يَرى أن ما حدث لا يَحدُث أو هي حالة نادرة وقد جرى تضخيمها؛ فكما يقولُ المثل العامي: “حارتنا ضيّقة وبنعرف بعضنا!”. وبعضنا يعرف جيّدًا عالم النوادي الليلية ودهاليزه القذرة والصراعات الضاريَة عليه، أو على الأقل ذَهَبَ إلى نادٍ ليلي ذات يوم أو ليلة وشاهد ما وجده مألوفًا في الفيلم. والبعض الآخر له معاناة مع الابتزاز والتهديد بالفضح وتشويه السمعة، وكثيرون مرّوا بتجارب مريرة مع فارضي أتاوات وبلطجية، نصيبٌ كبيرٌ منها موثّقٌ في المحاكم ومراكز الشرطة والصحف والمواقع الإلكترونية ومنصّات “التواصل”. ومُجدّدًا: ما في يَحدُثُ في فيلم الحارة يَحدُثُ في حارة الواقع، لكنّنا نختار إشاحَة وجوهنا عن هذا الواقع أو نُنكِر وجوده، وفي كلتا الحالتين ثمّة أزمة عميقة.
بين الأم وفتاة الليل، هل هنالك فرق؟!
وكما يحدث في حارة الواقع، تصدمنا بعض الأحلام الكبيرة حين تتقزّم فتتأزّم أو تتضخّم لدرجة الانفجار، لتتحوَّل بالنهاية إلى كوابيس لا أمل بالاستيقاظ منها، كما حدث مع علي في مآساته. مع أنّ الأخير كان بإمكانه التحلّي بمقدارٍ قليلٍ من العقلانية وبلع تهديد عبّاس له والسعي وراء مَنفَعَتِه، وكانت أحداث قصّته -وقصص الآخرين- لتأخذ منحى أقل مأساوية، لكن يا لقلّة ما في الإنسان من عقلانية ويا للعقلانية كم يُمكِن أن تَصِلَ إلى درجةٍ عاليةٍ من البرود كما هو حالُ أسيل، الأم التي لا تبدو مختلفةً كثيرًا عن فتيات الليل اللَّاتي يعملن في “نادي الطاووس الليلي” المُتخيّل (لكن الفتيات حقيقيات!)؛ فأسيل غايتُها تُبرِّر أي وسيلة، حتى لو كانت تَعريةَ ابنتها لانا وامتهانها، لتبلغ غاياتها والتي من ضمنها الحفاظ على حياة ابنتها وحماية سُمعتها.. ويا للمفارقة!
الهامش مُنتَقِلًا إلى المركز
قطار المفاجآت لا يتوقّف عند محطّة، يَصدِمُنا، فنَمتصُّ الصدمة، فتُفاجئنا أُخرى! مثلًا، يُفاجئنا تحوّل بعض الشخصيات من الهامش إلى المركز، ومن الأطراف إلى المحور، مثل بهاء (محمد الجيزاوي) الذي ينتقل من دورٍ هامشي أو ثانوي -بأحسن الأحوال- كمُجرّد حلاّق و”كشّيش حمام” وصديق لـ”علي”، إلى لاعبٍ رئيسي في سير الأحداث، وإلى رجلٍ متابعٍ وملاحظٍ لكل شيء من بعيد، ومؤمنٍ بأنّ مسار الأحداث يمكن تصحيحُه بالتلاعب به حتى بعد وصوله إلى خطّ النهاية، وأنّ ما حدث وانقضى أمره يمكن إعادة إنتاجه بروايتِه من جديد، ليصبح شيئًا آخر تمامًا؛ فبالنهاية ليَست الوقائع كما وقَعَت هي ما يُهمّ، بل سرديّتنا لها.. على الأقل بالنسبة لأشخاص مثل أهل علي؛ فموت ابنهم الآن هو قضيّتهم لا قضيّته، قضيّة سمعته وذكراه، والرمز هُنا يغدو المركز والحقيقة هي الهامش.
بين الحارة وذيب: أبطال بلا بطولة
هذا الانتقال أو التحوّل شاهدنا شيئًا مُشابِهًا له في فيلم كتبه أيضًا باسل غندور -إلى جانب مُخرجه ناجي أبو نوّار- عام 2014 وهو ذيب، حين يَغدو الفتى البدوي ذيب الشخصية المِحوَرية في القصّة، بعد أن كان مجرّد تفصيلٍ قابعٍ على الهامش، لتصبح المعركة في سبيل الاستقلال عن العثمانيين، في الخلف، ولتتصدّر المشهد معركة ذيب في سبيل البقاء.
الأبطال في الحارة -وكذلك في ذيب– هم أبناء الهَامِش، القابعون على حواشي كتاب الحياة، وبطولتهم ليست من اختيارهم؛ فالظروف تُجبِرُهُم على لعب دورها. والبطولة هُنا ليست بالضرورة تلك ذات المعنى الإيجابي كما في بطولة الأبطال الخارقين، بل تعني شيئًا أبسَط من ذلك: أن تُصبِحَ في الواجهة، أن تتصدّر الحَدَث وَتلعَب دوراً رئيسًا في تغيير مسارِه أو حَرفِه عنه.
بطلٌ مهمٌ آخر، لا يَملِك أي مُقوّمات البطولة ولا خَصلة من خِصال الأبطال، هو الراوي، الذي نترقّب معرفة هُويّته، فنصدم بالنهاية: إنّه إحدى الشخصيات الأكثر هامشية.. صبري (إسلام العوضي)، مُبتَزُّ أسيل وابنتها لانا، الذي يُشاهِد كل فضائح المدينة من بعيد ويُوثّقها عبر عدسة كاميرته. إنّه الرجل الذي يعرف كل شيءٍ عن العالم الخفيّ لهذه الحارة، وعن الجوانب السريّة لسكّانها ويحفظ كل زاوية مُظلِمَة فيها وفيهم، ويَعيشُ على ما يعرفُه عنهُم.. وعلى لا يَعرفونَه عَنه!
لكن الهَامِش المُرتَحِل للمَركِز ليسَ الأشخاص فقط، بل كذلك عمّان نفسها وتحديدًا شقّها الشرقي الذي يغدو هو المَركِز في قصّة الحارة، فنرى طَيفًا من جوانبه المختلفة وشخصيّاته المتنوّعة، بعكس أعمالٍ أخرى أردنيّة، كانت تَختَزِلُ هذه المدينة الكبيرة الغنيّة بطبقاتها ومكوّناتها ومنابتها في شطرٍ واحدٍ، في عمّان الغربية، وتحديدًا في طبقة وحيدة منها: بُرجوازية ومُنفَصِلَة عن وَاقعها.
هُناك طيف واسع من المآسي.. لكن لا مُتّسع للحُزن واللطميات
بالرغم من مأساويّة أحداث هذا العمل، إلّا أنّه يتجنّب الانزلاق إلى دراما مُبتذَلَة يسودُ فيها العويلُ والنحيبُ واللطميّات وتُرافِق أحداثُها موسيقى تَستمني حُزنًا ليس في مكانِه كما هو الحال في كثيرٍ من الأعمال السينمائية والتلفزيونية العربية المستمرّة على هذا النهج منذ عقود. وعِوضًا عن ذلك، يَخلِط إحباط خيبة المَسعى وتفاهة انتهاء الحياة بكل بساطة وبُرودة العنف وهَول المآسي، بموسيقى تُحاول التقليل من شأن ما يَحدُث ولا تأخُذُه بشدّة على مَحمَل الجد. ويُعزّز ذلك كلُّه أداءٌ يمزج بين الطرافة والقتامة، يُقدّمه نديم ريماوي من خلال شخصية “توتو”. وبما أنّ الحديث عن الأداء، يَصطَفُّ إلى جانب ريماوي طابورٌ طويلٌ من النجوم الّذين يقنعونك بأنّهم مُتمكّنون ولا يُمثّلون، أبرزهم: محمد الجيزاوي، ميساء عبد الهادي.. وبالطبع نادرة عمران!
وبعيدًا مؤقّتًا عن المَضامين والمُحتوى، تبدو الكاميرا مُحبّةً لوجه عمَّان، وتَبرُز مَفاتِنُ مِعمارها وعُمرانها أكثر في الظلام، حينَ ينجح الليلُ وظِلالُه وأضواؤه الخافِتَة في إبراز جماليات الأزقّة والشوارع والأدراج والعمارات المهجورة والأبنية القديمة المُهتَرِئة أو المَبنيّة بشكلٍ مُخالِف. تلك العشوائية التي نراها كل يوم تتحوّل إلى لوحة مُنظّمة والفوضى تبدو مُرتّبة وجاهزة للخروج في الكادر بأفضل صورة.
ومع ذلك، وبطبيعة الحال، هُناك جملةٌ من المآخذ على الحارة، ولأنّ المقام لا يتّسِع والوقت لا ينتَظِر، سأكتفي بذكر أهمّها، بدءًا من النهاية التي تبدو مُتسرّعةً وحَلّت قبل أوانها؛ إذْ كُنتُ أتمنّى نهايةً مختلفة لعبّاس، تتطلّب المزيد من الوقت وتكون منطقيةً أكثر؛ إذ كم من السهل والواقعي أن يقتل شخص بحجم بهاء وقُدراته وتجاربه شخصًا أضخم وأعنف وأشرس منه؟ لكن ربّما هو الدهاء الذي يغلب أقوى الأقوياء!
أصحاب الحارة يتسرّعون في القفز للنهاية
كذلك، كَمْ مقدار الواقعية ونسبة التماسُك في ما فعله بهاء مع أهل علي من تلفيقه للقَصص والشخصيات لإنقاذ ذكرى ابنهم والحفاظ على سمعته/م؟ أيضًا، كنت أنتظر تَعمُّقًا أكثر بعلاقة عبّاس بهنادي، على الصعيد الشخصي وبعضٌ من الأنسنة لعبّاس؛ أي تناولُه كإنسان قبل رجل عصابات. الخُلاصة، هُناك شوطٌ ما قبل نهائي قفز عنه الفيلم. وفي النهاية عَاشَ الجميع على الأكاذيب، فَلَم تُشرِق شمسُ الحقيقة على شرق عمّان وغَرَبَت عن غَربِها، ويبدو أنّنا في ردود فعلنا على هذا العمل نفعل مثلهم!
مَأخذٌ آخر مُهمٌ وجوهري، هو انتزاع قطعة الحارة من اللوحَة الكُبرى لعمّان بشرقها وغربها، وانتشالُها من سياقها الاجتماعي والاقتصادي، حيث لا يَأخُذُها كظاهرة مُركّبة ومعقّدة تتراكَم في قلبها الأزمات وتتجمّع في باطنها التناقُضات، حيث مشاكِلُها هي نتيجةٌ للطبقيّة وسياسات الإفقار ونهج التهميش.
الفرد: المركز، المجتمع: الهامش
لكن لنَعُد لما يُقدّمه ويَقولُه الفيلم، لا لتأويلاتنا ولا لَمَ ننتَظِرُه منه: يُركّز الحارة على الأفراد ومعاناتهم مع -وبسبب- مُحيطهم الاجتماعي ومع أنفسهم كذلك -مثل علي-، ويبدو سائرًا على خُطى ذيب، حيثُ الفرد -وصراعه- هو المركز، وإنْ بدا للكثيرين، للّذين يَرونه من بعيد، من عُلوّ، مُجرّد كائنٍ صغير، غير مُهم، قصّة قصيرة على هامش روايةٍ كُبرى. وكما يقول فرانز فانون، فإنّ الإنسان/الفرد هو الذي يتحقّق المجتمع من خِلاله، ويُضيف فانون في كتابه “بشرة سوداء، أقنعة بيضاء” بأنّ التشخيص يكون بين أيدي أولئك الذين يُريدون حقًا زعزعة البُنى المَنخُورة! فهل زَعزَعَ “الحارة” أي بُنى مَنخُورة؟ أو لنُعِد صياغة السؤال على النحو التالي: هل أرادَ ذلك أساسًا؟!
دفاعًا عن السينما لا الفيلم
وبِصدَدِ عكسه للواقع أم لا، فإنّ الحارة ليس بالضرورة مرآةً للواقع، وليسَ مطلوبًا من السينما بشكلٍ عام أن تكون كذلك! يُمكن لأيّ فيلم أن يقدم الواقع كما هو أو نظرته له أو رؤيته البديلة والافتراضية وأن يذهب لأقصى أبعاد الخيال؛ ليست ثمّة من قيود أو حدود.
أما ما يُقال عن تعميم الأحداث والشخصيات على عمّان وأهلها وإيصال صورة أنّ كل سكّان الحارة هم مجرّد نُسَخٍ عن سكّان العاصمة، فليس ثمّة من دليلٍ عليه والفيلم لا يقول أبدًا أنّ هذا حالُ الشعب كلّه! والحارة بين أيدينا وكل شيءٍ في صفحات كتابها وَاضِح: القصص مَحصورةٌ في قلب حارةٍ هي نسخةُ عن حارات الواقع وهي -أي القصص- فيها بعضٌ مما يجري داخل تلك الواقعية واختبرناه ويختبره بعضنا، وعلى نحوٍ ذكي يَتجنّب صنّاع الحارة الخروج لما هو أبعد منها أو تجاوز أسوارها إلّا نادرًا. بالطبع هي تتأثّر بالحارات المُحيطة بها وتنعَكِس أزمات المُدُن التي حولها عليها، ومن جديد: المركز كما ذُكر أعلاه، هو الفرد ومعاناته ومآسيه وصراعه من أجل البقاء والباقي يَقبعُ على الهامش.
وحولَ أنّ هذا العمل لا يُقدّم حلًا للمشاكل ولا يوفّر علاجًا لأزمات الحارة في الفيلم والواقع، فهل هذه وظيفة السينما أو إحدى وظائفها؟ هل مطلوبٌ منها أن تحلّ وتُعالِج وتُصلِح؟ حسنًا، بإمكان فيلم أن يُقدّم الحلّ الذي يُريده ووصفة العلاج التي يعتبرها مثالية، لكن ليسَ مطلوبًا من كل فيلم أن يفعل ذلك.. في الحقيقة ليسَ مطلوبًا من أي فيلم أي شيء! إلّا أن يكون وعظيًا أو تعبويًا أو دعائيًا أو مُنتَصِرًا لأيديولوجيا مُحدّدة أو مُدافعًا عن مشروعٍ واضح المعالم، أو جزءًا من حملة إعلانية أو خُطّة تسويقيّة، أو عملاً تُنتجهُ دولة ويُعرَض على قنواتها الرسمية.
في النهاية، هذا عملٌ لا يُؤلَّهُ ولا يُشيطَن، تمامًا كغيره من الأعمال السينمائية وذلك بَدَهي! تَكرَهُه، تُحبُّه، تُهاجمُه، تَمتَدِحُه، تَنتَقِدُه، تَستمتِع بِه، تَملّ منه، ترفُض مَضمُونَه وتَحتَقِر رِسالتَه/رَسائله… إلخ. لكن ليس بِوسعِ أَحدٍ أن يُحدّد لهُ لائحةً بما يَجبُ أن يقول أو لا يقول وبما يجب أن يظهَر فيه أو لا يظهَر وهل يَجبُ أن يَعكس الواقع أم لا.
ولنتخيّل أنّ صنّاع سينما عُظماء، التزموا بلوائح “ما يجب” و”ما لا يجب”، أو كان كان همّهم الأكبَر أن تكون أعمالهم مرآةً للواقع أو مُلتَزِمَة بما يُريده جمهورهم ويَصنعون أفلامًا ليُقدّموا حلولًا ووصفاتٍ علاجيّة، حينها ما كُنّا -مثلًا- لنرى ستانلي كوبريك وهو يَبتَدِعُ تُحفةً مثل بُرتقالة آلية أو ما كنا سنَنبَهِرُ بديڤيد لِنش وهو يخلط الواقع بأكثر الكوابيس رعبًا في الطريق السريع المفقود، أو لحُرمنا من لذّة الاستمتاع بغرائب شخصيات عوالم الأخوين كوين أو جنون كوينتِن تارانتينو الدموي!
-
البصل الزجاجي: تقشير طبقات وفضح تناقضات في «قصّة موت مُعلَن»


من السهل التقاط كثير من “المُتشابهات” والأشياء المتوقّعة في فيلم البصل الزجاجي، مثل ملاحظة التشابه بين الملياردير المُتخيَّل مايلز صاحب شركة “ألفا” وأصحاب المليارات من روّاد شركات التقنية الكبرى و”فاعلي الخير” و”المُحسنين”، وتحديدًا “إيلون ماسك”، الذي يبدو أنّه يُهاجَم في كثيرٍ من الأعمال السينمائية والتلفزيونية على نحوٍ رمزي مؤخّرًا، أكثر من غيره من “أيقونات الرأسمالية الملساء الناعمة” كما يصفها سلاڤوي چيچيك1، وهذه الشخصية سبق ورأيناها في أعمالٍ أخرى مؤخّرًا مثل لا تنظروا إلى الأعلى ورأس العنكبوت، وحتى قبل ذلك من خلال شخصيّة ليكس لوثر، الشرير الشهير من عالم القصص المصوّرة “دي سي” وعدوّ سوبرمان الرئيسي.
شبحٌ هِتشكوكي ينتابُ هذا العمل
ولا يتطلّب الأمر الكثير من التفكير والتحقيق لمعرفة المُجرم الحقيقي أو العقل المُدبِّر للجريمة في الفيلم الذي أخرجه الأميركي ريان جونسون، وهذا الأخير يبدو مُقتَفِيًا أثر ألفريد هِتشكوك في سينماه، حيث نعرف الفاعل أو نَعلَمُ ماذا سيحدث في النهاية: لكن المُتعة على الطريقة الهِتشكوكيّة لا تأتي من معرفة النهايات بل من الأحداث المالئة للمساحة الزمنية التي تسبقها والإثارة تنبع من كيفية وقوعها. مثل الحياة تمامًا، النهاية معروفة: الموت، لكن المرء لا يعيش منتظرًا هذه النهاية، بل يُحاول أن يصنَع معنى لِمَا يَسبِقُها وأن يستمتع بالطريق قبل الوصول إلى المحطّة الأخيرة. ويمكن القول إنّ الفيلم كان على اسم نوڤيلا للروائي الكولومبي الراحل چابرييل چارسيا ماركيز “قصّة موت مُعلَن” لكن فيها قليلٌ من الحقيقة فيما يَخُصّ هذا الموت الذي يتم الإعلان عنه وننتظر أن نكون شهودًا عليه.
أثر “شقلبة الزمن”
جونسون الذي أخرج ثلاث حلقات من بريكنچ باد، أشهَرُها Ozymandias وأمتَعُها Fly، يبدو أنّه فهم المسار الهِتشكوكي وسار عليه، لكن ذلك لم يمنعه من الانحراف عنه. وهو انحرافٌ إيجابيٌ نستمتع به حين يتلاعَب بنا بواسطة تقنيته لسرد الأحداث من زوايا مختلفة وممارسة ما يمكن تسميته بـ”شقلبة الزمن” في السرد، وقد رأيناه من قبل يتّبع أسلوبًا مشابهًا في العمل الخيالي العلمي الذي كتبه وأخرجه وأبدعه قبل أكثر من 10 سنوات صانع الحلقة حيث تَختَلِط فيه أنساب الزمن، فلا نعرف أصل الماضي ولا فصل الحاضر، وكل مرحلة زمنيّة تُولَد من رحم الأخرى وتتلاعب فيها في حلقةٍ مفرغة.
نتيجةً لما سبق، نشكّ بالشخص الخطأ ونتّهمه -وهُنا مجددًا الروح الهيتشكوكية حاضرة- وكل مرّة يُخامِرُنا شكٌّ بشخصٍ تشيرُ الظروف والمُعطيَات إلى أنّه صاحب المصلحة في الجريمة، لكن مع ذلك، حتى ونحنُ نُوجّه أصابع الاتهام لأكثر من أحد، في داخلنا شعورٌ قويٌ على تخوم اليقين، بأنّ المجرم/الفاعل هو نفسه ذلك الظاهر والواضح على نحوٍ فاضح. وفي النهاية، وكما يُعلن المحقّق بنوا بلانك (دانييل كريچ): لا ألغاز أو أحاجي في باطِن “البصل الزجاجي” وليس ثمّة شيءٌ معقّد في العُمق كما يظهر للوهلة الأولى.
البصل الزجاجي.. أم الإنساني؟
مع ذلك، ثمّة الكثير من المفاجآت المكتوبة والمُنفّذة بعناية، والتي لا تتمركَز حول هُويّة الشخص الذي يقف وراء الأشياء التي تحدث أو “قصّة الموت المُعلَن”، بل تتوزّع على مجموع الشخوص ومجمل الأحداث؛ فنرى على مدار 139 دقيقة مفاجآت حول مختلف الشخصيات.
وهُنا لا يبدو مشروع البصل الزجاجي هو الأكثر أهمية، بل مشروع “البصل الإنساني” -إن جازت التسمية- حيثُ أبطال العمل مجموعةٌ من البصل يتمّ تقشيرُ كل بَصلةٍ منها بسكين تحرّيات المحقّق الخاص بنوا بلانك، الذي يتم شحذه على حجر الحقائق الصادمة، فتتكشّف طبقاتٌ مختلفة بعد عملية التقشير وتبرز الرائحة الحقيقية القويّة التي يُحاول كل واحدٍ من الشخوص إخفائها بمضغ علكة المظاهر الكاذبة والمواقف المُصطَنَعَة، لكنّها تفوح في وجه الآخرين وأمام نفسه. وهذا التقشير يُسبّب إسالة بعض الدموع وهي دموع حزنٍ ممتزجٍ بضحكٍ على الذات وجنونٍ هستيري بوصفه أفضل الردود على جنون الواقع وأولئك الذين يتحكّمون به.
عبر التقشير للبصل الإنساني، نكتشف بأنّ المجرم ليس واحدًا، بل الجميع. كل واحدٍ من هذه النخبة، يقترف جرائم بحقّ الآخرين ونفسه، من خلال ممارسة الكذب والنفاق وانتهاج الانتهازية وعيش حياة مزدوجة. وإن كانت تحقيقات بلانك تكشف عن شيءٍ مهم، فهو أنّ الناس تقول ما لا تَفعَل وتُظهِر خلاف ما تُبطِن، وليس أيّ أحد من الناس، بل تلك النخبة، المتنوّعة بين اليمين واليسار، بين ذلك “الناشط المناصر للرجال” الذي يفعل كل ما يُخلُّ بالرجولة لينال ما يريد، ويعرض نفسه للمجتمع الذي يتفرّج عليه كـ”ذكر ألفا”، بينما في الواقع وبالرغم من ضخامة بُنيته وقوّته الجسدية لا يزال ذكرًا غير ناضج ولا يتمتّع بأدنى حِسٍ من المسؤولية، ويبدو أقرب لطفلٍ تتحكّم به أمّه وحبيبته، وبين حاكمة ولاية كونيتيكت، يساريّة الميول، التي تُوافق على تمرير كل ما تَقِف ضدّه، وتَستغلّ حاجة مؤيّديها لتغيير العالم للوصول لما تُريد، ولا تُغيّر أي شيء حقًا ممّا تريد قاعدتها الشعبية من “اليساريين” تغييره!
رأسماليو كوارث بأقنعة يسارية وليبرالية
وعلى سيرة تغيير العالم، يُذكّر بعض المجتمعين على الجزيرة في هذه القصّة المتخيّلة، بالناشطين أصحاب الخطابات الثورية في جزيرة واقعنا المُعاش -أو فيما تبقّى من هذا الواقع- حيث يعيش هؤلاء على الدعوة إلى تغيير العالم وشعارات الثورة على فساده وحتميّة إصلاحه، لكن تغيير العالم ليس من مصلحتهم؛ فبمجرّد حدوث ذلك، ستنتهي صلاحية خطاباتهم أو عليهم أن يخلقوا أزمات جديدة لكي لا تبور تجارتهم. وليس أمرًا عشوائيًا أنّ هذه النُخبة المُجتَمِعة في قصر مايلز، يسمّيها هذا الأخير بـ”المُزَعزِعين” أو “مُثيري الاضطرابات”! إنّهم “رأسماليو كوارث”، بعضهم صريحٌ بذلك، وآخرون يرتدون أقنعةً ليبرالية ويسارية.. ولامُبالية متّبِعَة لمذهب اللذّة.
مع ذلك يتم تقديم نقيضٍ لدعاة تغيير العالم المُزيّفين، من خلال شخصية التوأم هيلين وآندي براند، وتحديدًا هيلين. ويبدو في ذلك سائرًا على نهجٍ “صائب سياسيًا”، متوقّعٌ من عملٍ يُوزَّع عبر نتفليكس ويُعرض عليها؛ فالفتاة السوداء هيلين، “الناشطة الحقيقية” و”الثورية الصادقة” هي بطلة العمل في النهاية، لا المُحقّق بنوا بلانك، الذي يبدو 2أقرب لمساعدٍ لها أو مرشدٍ لطريقها أو “الراعي الصالح” كما جاء في إنجيل يوحنا.
بين “البصل الزجاجي” و”لا تنظروا إلى الأعلى”
إنّ “البصل الزجاجي”، يذكّر بفيلمٍ آخر صدر في أواخر عام 2021، وقد ذُكر في مُقدّمة هذا المقال، وهو “لا تنظُروا إلى الأعلى“. وبالرغم من الاختلاف الجوهري بين عمل جريمة وغموض يبدو مزيجًا من روايات أچاثا كريستي وسينما هِتشكوك، وبين عمل كوميديا سوداء ونقد سياسي ساخر، أجواؤه قيامية، حيث اقترب للناس حِسابُهُم وهم في غفلةٍ مُعرِضون! لكنّهما يلتقيان في نقد -ونقض- “مُجتمع الفُرجَة” وتَعرِيَة نُخَبِه وإنذار أفراده بأنّ هُناك خطأً كامنًا وخطرًا داهمًا، وبأن على الناس أن يكفّوا عن التحديق في ما يستعبدهم والمسارعة برفع رؤوسهم للنظر إلى أعلى، إن كان ثمّة أمل، فنحنُ في هذا “الواقع الذي يُخفي عدم وجود واقع”، وكما يقول جان بودريار3: فقدنا نعمة التعالي وما عُدنا قادرين على تصوّر عالمٍ من نوعٍ آخر!
لكنّي لو خُيّرت بين الاثنين، بدون تردُّد سأختار “البصل الزجاجي”؛ فهو يتجاوز نفسه كفيلم غموض وجريمة أحداثه مُمتعة وفيه مقدارٌ متوازنٌ من الكوميديا المرسومة بخفّة ظل، ليكشف عن هشاشة الأيديولوجيا وتهافت الدعاوى الكبرى ودجل “المُحسنين الكبار”، دون أن يكونَ مباشرًا كما كان “لا تنظُروا إلى الأعلى”، وهذا الأخير وإن كان قد جَمَعَ صُنّاعُه زُبدة المُمثّلين، إلّا أنّ معظمهم بدوا وكأنّهم في مكانهم غير الصحيح، وربما كان بالإمكان الاستعانة بوجوه جديدة أو أقل شهرة، وكان العمل ليظهر بنفس المستوى أو حتّى أفضل. لكنها وجوهٌ مثالية للتسويق لعملٍ ربما ما كانت ستكون نسبة مشاهدته عالية لو كان طاقمه أقلّ شهرة وحدّة سُطوعِ نجومهم أخف. وهي مفارقة أنّنا حتّى عندما شاهدنا فيلمًا يُحذّر من عواقب عدم النظر للسماء ولما هو أعلى منّا ويتجاوزنا، ما جذب الكثير منّا إليه الوجوه الجميلة والأسماء الكبيرة.. لا ما وراء ذلك!
أمّا هذا العمل، فيقدّم طاقم تمثيل أفراده ليسوا أقلّ شأنًا من ناحية رصيدهم الفنّي وجودة آدائهم وشهرة أسمائهم، مع إفساح المجال لوجوهٍ جديدة. ويبدو كل واحدٍ من هذا الطاقم متواجدًا في مكانه المناسب ومُتموضعًا في موقعه المثالي حيث يجب أن يكون. فنرى دانييل كريچ بروحٍ جديدة، قافزًا من عباءة العميل 007 ومتمرّدًا على الأدوار الجديّة، ليقدّم أداءً كوميديًا أصيلًا، لا مكان فيه للاصطناع والإجبار ليبدو مضحكًا أمام من لم يعتادوه كوميديًا.
فيما يُثبت ديڤ باتيستا مجددًا، أنّه ومن بين كل المُصارعين المحترفين الذين اتّجهوا للتمثيل، هو الأفضل؛ إذ يُفلِحُ في مزج المُتناقِضات مع بعضها: قامةٌ طويلةٌ وبنيةٌ ضخمةٌ تليق بشخصٍ يَصرَع خُصومه بأريحيّة، مع قلبٍ طفوليٍ وجوهرٍ هو نقيض المظهر وشخصيّة لا تُخيفُك بل ترتاحُ لها! كذلك تتألّق كيت هيدسون، صاحبة الغيبات الكبرى عن السينما، في دور مُصمّمة الأزياء و”العارِضة” السابقة، اللامُبالية بأيّ شيء سوا متعتها ولذّتها، أمّا كاثرين هان، فيبدو دورُ السياسيّة ذات الخلفية اليسارية مُفصّلًا على مقاس قدراتها تمامًا.
في النهاية، فإنّ هذا العمل الذي يحمل عنوان أغنية لفرقة البيتلز، ليسَ هو الأكثر عُمقًا أو تعقيدًا وتركيبًا من بين أعمال الغموض والجريمة، لكنّه بلا شك يَنجَحُ في فنّ صناعة الطبقات -إن جازت التسمية-… طبقاتٌ من القصص داخل القصص، والحبكات في قلب الحبكات، وطبقات مفاجآت فوق مفاجآت. ومجدّدًا، هو يُبدِعُ في تجاوز نفسه، ويَتعالى على ذاته، ليَخلِق أبعد من الجريمة والغموض، ويقدّم لنا خبّاز طبقاته ريان جونسون ما يُشبه نسخةً حيةً من لعبة الغموض والجريمة الشهيرة “كلودو” (Cluedo)، نحنُ أحد المشاركين فيها بطريقة أو بأخرى. وكم كان سيكون أجمل وأمتَع لو كانت هناك نُسخة تفاعُلية منه على غرار “بلاك ميرور: باندرسناتش”، حيث نحنُ لاعبون رئيسون بالشخصيات، مُتحكّمون بمصيرها ومُساهِمون بتغيير مجرى القصّة/القصص وبتقشير الطبقات.. وفضح التناقضات.
مصادر:
- العنف: تأملات في وجوهه الستّة – سلاڤوي جيجيك، ترجمة فاضل جتكر، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
- إنجيل متى 10:11,15، الكتاب المقدّس: كتاب الحياة ترجمة تفسيرية.
- المصطنع والاصطناع – جان بودريار، ترجمة جوزيف عبد الله، المنظّمة العربية للترجمة.
Glass Onion, Knives Out, فضائح, قصة موت معلن, كلودو, مفاجآت, مبادئ, يمين, يسار, أغاثا كريستي, إثارة, البصل الزجاجي, انتهازية, باتيستا, جريمة, حقوق الرجال, دانييل كريغ, ذكورية, سياسة, طبقات, غموض -
هشاشة الخطاب الأخلاقوي أو: كيف تَعلَّمت السُلطة أن تتوقّف عن القلق وتُحب الأخلاق


مشكلة “الخطاب الأخلاقوي” الرئيسية، تكمن في حقيقة أنه “مجرّد خطاب” في عالمٍ لا يقيم وزنًا للخطابات ولا يهتمّ إلا بتلك المدعومة بالقوّة. وإن اهتمّ بها فيكون اهتمامًا لغايات الاستغلال الهادف إلى تدعيم القوّة ولا شيء غيرها؛ فهذا الخطاب دائمًا عُرضة للاستغلال، ستستغلّه السُلطة لتعزيز نظام الردع والهيمنة، وستقول -مثلًا- لصاحب/حامل هذا الخطاب: “ليلًا ونهارًا تهاجم فسادنا وإهمالنا وتعلن عبر كل منصّةٍ للتواصل سخطك وغضبك على الوضع القائم، وتشكي من عدم اهتمامنا بأرواح الناس وصحّتهم وسلامتهم.. لك ذلك، سنهتم، سنغيّر، سنُصحّح.. سنعطيك مزيدًا من القيود على الحريات لكبح جماح الفساد، وسنحميك بمضاعفة الإجراءات الأمنية ومراقبتك ومعاقبتك.. لمصلحتك!”، إذ ليس في جعبة أيّ سُلطة إلا الحلول الأمنية لمواجهة -أو مفاقمة- أيّ أزمة أو كارثة أو تهديد.
كذلك، سيستغل رأس المال هذا الخطاب بما يعود عليه بالمزيد والمزيد من الربح والسيطرة؛ فهو لا يأبه لأيّ خطاب، خاصةً ذلك القائم على أرضية أخلاقية. وإن كان رأس المال بحسب عالم الاجتماع والفيلسوف الفرنسي جان بودريار، يحتاج هذا الخطاب وتلك الأخلاق لخدمته، حيث يقول في كتابه المصطنع والاصطناع: “لا يستطيع رأس المال وهو عديم الأخلاق والذمّة، أن يمارس دوره إلّا من خلال بُنية تحتية أخلاقية، ومن يُجدّد هذه الأخلاق العامة بالسخط والتشهير… إلخ، يعمل عفويًا لصالح رأس المال”.
وفي عالمٍ يعجّ بالخطابات، سيجد رأس المال في الخطاب الأخلاقوي فرصةً للتنويع وتغيير طعم فم المستهلِك للخطابات. سيراها سلعةً يمكن بيعها لأنّها نادرة في “عصرٍ لا أخلاقي”، كما حدث في حلقة Fifteen Million Merits من الموسم الأول لمسلسل Black Mirror، حينَ ألقى البطل “بينغهام” خطابًا أخلاقويًا مُلتَهِبًا بالرفض والاعتراض والحماسة الثورية، أمام لجنة تحكيم برنامجٍ اسمه Hot Shot، وهو نسخة عن برامج المواهب مثل Arabs Got Talent، لكن الفرق أنّ المواهب فيه أكثر تنوعًا، حيث يمكن للمرء إن كان يملك المهارات اللازمة أن يُصبح نجمًا في أفلام البورنو!
وبعكس المتوقّع من برنامجٍ ترفيهيٍ، يروق الخطاب للجنة ويؤثّر بها، وعوضًا عن أن يأمُر رئيسها بإبعاد صاحب الخطاب الأخلاقوي الثوري الراديكالي هذا، يمتدحه ويقول له إنّ هذا ما نفتقده اليوم وما يحتاجه الناس.. الأصالة! ويتم تسليع هذا “الخطاب الأصيل”، ويحصل صاحبه على وظيفة إلقاء خطاباتٍ أصيلةٍ مشبّعةٍ بأقصى حمولةٍ راديكاليةٍ غاضبةٍ وساخطةٍ وبنفس الروح الحماسية المتّقدة في برنامجٍ مخصّص له سيحظى بنسبة مشاهداتٍ عالية. هذا الخطاب بكل أخلاقيته وجذريّته و”أصالته” ينقصه عنصرٌ جوهري: “الغضب الحقيقي” الذي يُعرّفه الفيلسوف الألماني من أصل كوري جنوبي بيونچ-شول هان في كتابه مجتمع الاحتراق النفسي، بأنّه “القدرة على قطع حالة روتينية قائمة وإحلال حالة أخرى محلّها” ويرى شول هان، أن الوضع اليوم يسفر عن المزيد والمزيد من الإزعاج والضجيج، وتلخّصه عبارة “عليك أن تُقدّم شكوى”، ما يؤكّد غياب القدرة على إحداث تغييرٍ حاسم.
يبدو كل شيءٍ في هذه الحلقة، كما المسلسل وكما العالم اليوم، غَارِقًا في العدميّة “عدميّة الشفافية” -كما يسمّيها بودريار- حيث يدخل الناس أفواجًا في دائرة اللامبالاة، ولا يعود للخطاب الأخلاقوي وللأخلاق نفسها أي قيمة، إلّا تلك القيمة الترفيهية الاستهلاكية، فيتهافت الناس على هذا الخطاب أو على “تسوّقه”.
ولن يشكّل هذا التهافُت أيّ تهديدٍ للسُلطة، بل سيُعزّز نظام ردعها وهيمنتها؛ فالناس سيتابعون الخطاب الأخلاقوي، سيتعاطونه ويُدمنونه، لكن بوصفه وسيلة ترفيه وتفريغ وتصريف غضب، وكطريقة لجلب النشوة، كشيء يشبه انتشاء الاستمناء على البورنو، وهو ليس انتشاءً حقيقيًا في النهاية؛ إذ لا يُغني عن الممارسة الجنسية الفعلية ولا يصل بصاحبه للإشباع، كما لا تُغني الخطابات الأخلاقوية مهما كانت ساخطة ورافضة، عن فعل شيءٍ حقيقيٍ وفعّال ومُشبِع في الواقع الآخذ بالتلاشي لصالح عالمٍ “فوق-واقعي” هو العالم التكنولوجي الافتراضي الذي نعيش به اليوم أكثر من أيّ وقتٍ مضى والذي تُرسّخ دعائمه شركات التقنية الكُبرى والميديا المُتلاعب بها من قبل رأس المال الذي يبدو أنه دائمًا أذكى من الذين يظنّون أنّهم يحاربونه ويقاومونه.
-
الأصولية، العدمية والفوضوية في ثلاثية «فارس الظلام»


من بين كل الأعمال السينمائية التي أُنتِجَت حول البطل الخارق من عالم القصص المصوّرة الأميركية “DC” الرجل الوطواط -حتّى الآن-، تبدو ثُلاثية فارس الظلام للبريطاني الأميركي كريستوفر نولان، الأفضل، من ناحية إخراجها لصاحب العباءة السوداء من عباءة القصص المُصوّرة وإتيانها بنسخة واقعية وحقيقية له، ليس فيها أيّ مكانٍ لما هو خيالي وسحري، إلّا سحر ثروة بروس واين الذي ليس خياليًا وما أكثر أشباهه في الواقع، مع فارقٍ جوهري: أنّهم ليسوا فُرسانًا ولا يمتّون لأخلاق الفروسية بأيّ صلة.
إنّ ابتعاد فارس ظلام نولان عن القصص المصوّرة، ليس بالضرورة شيئًا إيجابيًا لمُحبّي هذه القصص، الذين يُفضّلون ترجمة ما قرأوه وتخيّلوه في أذهانهم وشاهدوا منه أفلام/مسلسلات رسوم متحرّكة إلى صورٍ حقيقية نابضة بالحركة وآخر شروطها “الواقعية”، وأفضل من قام بذلك هو زاك سنايدر في المراقبون (2009) وحتى في باتمان ضدّ سوبرمان (2016). لكن يبدو أنّ ذلك كان آخر همّوم نولان وأخيه جوناثان الذي كتب معه سيناريو فارس الظلام (2008) ونهوض فارس الظلام (2012)، وكان يتطلّع آل نولان إلى صورةٍ أكبر من مجرّد صنع نسخة واقعية عن قصّة/قصص مصوّرة، وإلى مشهدٍ أكثر تعقيدًا، ليس باتمان هو مِحوَرُه.. بل أعداؤه!
وبما أنّ الحديث عن الأعداء في هذه الثُلاثية، سيقفزُ إلى الذهن على الفور أكثرهم جاذبية -وأكثر أعداء الرجل الوطواط ربما يفوقونه جاذبية-: جوكر الراحل هيث ليدجر، أحد العوامل الرئيسَة في جعل باتمان نولان عصيًا على النسيان حتّى بعد مرور قرابة 15 عامًا على ثاني أفلام الثُلاثية والعمل السينمائي قبل الأخير لليدجر. وهي مُفارَقَة أنّ حُبّنا لفيلمٍ حول باتمان، مَردُّه إلى جاذبية نقيضِه.. وكما قال النقيض للبطل: “أنتَ تُكمّلُني!” الحديث عن الجوكر آتٍ، لكن لنستهلّ المشوار بأوّل الأعداء.
المعركة الأولى ضد مشروع الاستئصال الأصولي
في البدء وقبل أن يُصبحَ الرجل الوطواط، يُواجه بروس واين حركة أصولية راديكالية (اتّحاد الظلال أو عُصبة الظلال) كان جزءًا منها وتدرّب على يد شيخها -إن جاز الوصف- “رأس الغول” مُعلّمه ومرشده وعدوُّه لاحقًا. هذه الحركة ليست جديدة أو تشكّلت كردٍّ على “فساد العالم المُعاصر”، بل موجودة منذ آلاف السنين كقوّةٍ ضد الفساد البشري، ومن أعمالها: تدمير روما وشحن سفن تجارية بفئران مصابة بالطاعون وإحراق لندن كليًا، كما يروي رأس الغول. وفي كل مرّة تبلغ أيّ حضارة قمة التدهور وتصل لهرم الانحطاط تأتي هذه العُصبة لتقويم الاعوجاج واستعادة التوازن.
تُسافر بنا عُصبة الظلال عبر الزمن، إلى القرن الحادي عشر الميلادي تحديدًا، لتُذكّرنا بـ“جماعة/طائفة الحشاشين” التي تتقاسَم معها أوجه تشابهٍ كثيرة؛ فجنودها راديكاليون بلا رحمة، يغتالون بلا هوداة، وهُم “فِدائيون” لا يهابون الموت ويجدون الحياة الحقّة فيه ويُقبلون على الفناء ويحتضنونه بانتشاء وكأنّهم تحت تأثير الحشيش! ويبدو رأس الغول وكأنّه مستوحى من قائد الحشاشين حسن الصبّاح أو شيخ الجبل، وربما المعبد الذي أحرقه واين هو نسخة مصغّرة عن قلعة “ألموت”!

وعودةً إلى عصرنا الحالي، تبدو العُصبة أقرب إلى الحركات الأصولية الإسلامية المُسلّحة أو “الجهاديين”، إذا ما أُخِذَت الفترة التي أُنتجَ فيها الفيلم بعين الاعتبار، حيث كان الصراع مُحتَدِمًا بين الغرب وهذه القوى، ولم يكن قد مضى الكثير على الهجوم على البرجين التوأمين لمركز التجارة العالمي في نيويورك. هذا التشابُه بين الطرفين يَتمظَهَر في “النشوء والاستناد إلى سلسلة من البيانات الدُغمائية القاطعة”، بتعبير المنظّر الماركسي اليهودي الألماني وأحد أعضاء مدرسة فرانكفورت فرانز ليوبولد نويمان، ونشاط كلا الطرفين -خاصة الأنساق المُسلّحة من الحركات الأصولية- بالفوضى واتخاذهما العُنف كوسيلة للوصول للغاية النهائية.
وجه تشابهٍ آخر هو رفض تحكيم “القوانين الوضعية”، وإن جاء الوصف بشكلٍ مختلف على لسان رأس الغول الذي استنكر رفض واين لمحاربة فساد مدينة چوثام بتدميرها وسخر من الاحتكام لقوانينها، بتساؤلٍ استنكاري: “ما البديل؟ هل هو قانون البيروقراطيات الفاسدة وقوانين المجتمع التي يحتقرها المجرمون ويتلاعبون بها كما يشاءون؟!” ألّا يبدو التشابه هُنا قويًا ومقصودًا؟!

كذلك تتلاقى عُصبة الظلال مع النازية، من ناحية استعمالها الإرهاب لإقناع الناس، وانطوائها على بعض “المعتقدات السحرية” مثل عبادة القائد، بحسب نظرة نويمان لـ“الاشتراكية القومية” في كتابه “البهيموت1. ووجه التشابه الأخير هذا ليس حِكرًا على النازية؛ إذْ تُشاركُها بِه الجماعات الأصولية الراديكالية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، إلى جانب دولٍ يفترض أنّ أيديولوجيتها ونهجها نقيض الرايخ الثالث، لكنّها كادت أن تكون توأمَهُ من ناحية عبادة القائد واستعمالها الإرهاب تحت مُسمّياتٍ ناعمة.
يصل واين وعُصبة الظلال إلى مفترق طرق، حين تقرّر العُصبة أن چوثام قد حقّ عليها القول، لأنّ مُترَفيها فسقوا فيها واستوجب عقابها بـ”استئصالها” بتعبير محمد بن عبد الرحمن الإيجي الشيرازي في تفسيره للآية السادسة عشرة من “سورة بني إسرائيل” في القرآن الكريم. والاستئصال يَعني الاجتثاث الكامل من الجذور بدون استثناء، فحتّى “غير المُترِفين” سينالُهُم الاستئصال؛ لأنّهم “رضوا بفعل المُترَفين وسكتوا عن النهي فاستحقّوا العذاب”، كما جاء في حاشية محمّد بن عبد الله الغَزنوي على تفسير الآية في “جامع البيان في تفسير القرآن”2. ويُجادل واين بأنّ هناك الكثير من غير المُترَفين وأهل الصلاح في مدينته، لكن ذلك لا يعني شيئًا لـ”عدالة عُصبة الظلال”، الجميع سيُباد؛ فالعقاب عادل والعذاب شامل وقد استحقّه هذا المجتمع “الجاهلي” بنظرها،إذا ما استحضرنا وصف سيّد قطب الذي يبدو استعمالُه في هذا السياق مَنطقيًا ومع التشابه الكبير بين خطاب هذه العُصبة والبيانات الدُغمائية القاطعة للجماعات الأصولية ومُنظّريها.
يرفض واين تنفيذ القصاص بيديه ويَستنكِر أن يكون مُطبّقًا لحُكم إعدام أيّ إنسان عدا عن إبادة مدينته، وهي -أيّ الإبادة- وظيفة كانت تقوم بها العُصبة جيلًا وراء جيل، وذلك من ثوابتها وقد “كَفَرَ” واين بها! يَنقلِب هذا الأخير على مُعلّمه ومُرشِدِه ويحرق المعبد، ظانًا أنّ كل شيءٍ قد انتهى، ويذهب ليبدأ حياته من جديد في مدينته كمنقذٍ ومخلّصٍ لها تحت قناع الرجل الوطواط.. لكنّها بداية النهاية التي مُقدّرٌ لها أن تَحلّ لا محال! إذا يعود رأس الغول ويعود بروس واين لمُقاتلته ومنعه من جعل چوثام لـ”أهلها الفاسدين”.. حصيرًا، ولاستئصال سمومها.. بسمٍ مُضَاد لا يُبقي ولا يَذَر. ينجح التلميذ بإحباط مخطّط مُعلّمه، ينقذ مدينته.. ولا يقتُل هذا “الأب”، لكنّه لا ينقذه.. لكنّ ذلك لا يعني أنّ السلام قد حلّ!
ليسَ لدى المُهرّج ما يخسره.. ولا للبطل أيُّ سلاحٍ ضد “عميل الفوضى”
في منتصف الطريق، يُواجه واين قوّة شريرة جديدة، لكنّها على النقيض من عُصبة الظلال: لا تعنيها تطبيق أيّ قوانين أو أحكام أو تشريعات ولا تأبه بأيّ عدالة، ولا تستند إلى أيّ بياناتٍ دُغمائية قاطعة ما خلا بيان العدميّة والجنون. وتلك العدمية ليست شيئًا شاذًا، بل هي تعبيرٌ أصيل عن روح العصر؛ فالجوكر -الذي لا نعرف شيئًا عن أصله وفصله سوا سرديّاتٍ متناقضة جاءت على لسانه- ابن زمانه بالنهاية! هو فقط تجرّأ على إعلان عدم وجود أي قيمة ومعنى، عبر تأكيده بأنّه لا يملك خطّة، والخُطّة هُنا هي بمثابة المرجعية والترياق لسمّ العدميّة والصلابة في مواجهة الميوعة والوضوح القاطِع في مواجهة الغبش الخادِع.

أمّا جنونه فهو مُجرّد جنونٍ مُضَادٍ لجنون الوضع القائم في چوثام المُمثّل في فساد رجال أعمالها وإرهاب عصاباتها ونفاق مؤسّساتها الرسميّة، وهو وإن سعى لإغراق هذه المدينة بالفوضى وخراب العمران، فالظُلم السائد فيها كان أصلًا مُؤذِنًا بخراب عمرانها وكل ما فعله “عميل الفوضى” أنّه استثمر ذلك لصالح عدمّية تخريبه الفوضوي! والظلم هُنا بالمعنى الأعمّ، وفي هذا الشأن يقول ابن خلدون في الفصل الثالث والأربعين من مُقدّمته3:
“ولا تَحسبَنّ الظُلم إنّما هو أخذ المال أو المُلْكِ من يد مالكه من غير عوضٍ ولا سبب كما هو المشهور، بل الظُلم أعمُّ من ذلك. وكُلُّ من أَخذَ مُلكَ أحدٍ أو غصبَهُ في عمله أو طالبَهُ بغير حقٍّ أو فَرضَ عليه حقاً لم يَفرِضهُ الشرع فقد ظَلَمَهُ؛ فجُباة الأموال بغير حقهّا ظَلَمَة والمُعتَدون عليها ظَلَمَةٌ والمُنتَهِبون لها ظَلَمَةٌ والمانعون لحقوق الناس ظَلَمَةٌ وغُصَّاب الأملاك على العموم ظَلَمَةٌ، ووبالُ ذلك كُلِّه عائدٌ على الدولة بخراب العُمران الذي هو مَادَّتُها لإذهابه الآمال من أَهلِه”.
وتوصيف ابن خلدون هذا، ينطبق بدرجةٍ كبيرةٍ على ظُلمِ چوثام، وفي نسخة أخرى من الجوكر، تنالُ هذه المدينة المجنونة البطل الذي تستحقّه!
ضِدّ الجوكر تبدو كل القوى والأسلحة بلا جدوى؛ فهو كممثّلٍ لقوّةٍ عدميةٍ ومجنونة، لا يسعى للثورة بمعناها التقليدي أو الرومانسي، فلا يعنيه تغيير الأوضاع أو قَلبُها والتمرُّد على السُلطة.. هو رَجلٌ يريد مشاهدة العالم مُحتَرِقًا، ولا تملك القوة المُضَادة له أي شيءٍ حقيقي وذي فعالية ضِدّه! وفي المواجهة الأخيرة بين البطل ونقيضه، لا ينتصر صحاب المبادئ غير القابل للإفساد على المُهرّج العَدَمي، إذْ ينتهي الفصل الثاني من الثلاثية، بفوز “عميل الفوضى”، حين تُفلِحُ ألاعيبه في صيد عفاريت چوثام (باتمان، هارڤي دينيت) وإسقاط واين في ظلام الهزيمة واليأس!

وفي آخر الطريق أو بداية آخرِه، يبدو واين مُثقلًا بحِملِ هزيمته النفسية والمعنوية على يدّ الجوكر وروحهُ تغذو محطّمة، بعد اضطرار فارس الظلام لتحمّل وزر جرائم “فارس چوثام الأبيض” هارڤي دينيت، الذي غدا واحدًا من المجرمين، بعد أن نقل إليه المُهرّج جرثومة الفوضى وأصابه بفيروس الجنون وجعله يشاهد نفسه يتحوّل إلى “الشرير” الكامن في “الهُوَ” الذي كان بطل “الأنا” يُحاربه. يدفن الرجل الوطواط وحليفه جيمس جوردون الحقيقة والتاريخ الحقيقي لإنقاذ الرمز؛ فالتاريخ في جوهره العميق ليس أكثر قاطرة لرأسمال رمزي ومادي وقوة غير منظورة لتحريك الوعي الجمعي، كما قال الكاتب السوري نادر قريط ذات مرّة.

العودة الثانية للعدوّ الأول من أجل يوم الحساب
يُحاوِل واين أن يَنهَض، يَسقُط مرةً أُخرى، لكن هذه المرة في ظلام الماضي الذي يعود على هيئةٍ أكثر جنونًا وعنفًا وفوضويةً! عُصبة الظلال تُبعثُ من جديد كطائر الفينيق، للإيذان باقتراب يوم حساب چوثام، حاملةً الأيديولوجيا المتطرّفة ذاتها، والغاية نفسها مع بضعة تحديثات: إسقاط النظام في چوثام -الآيل للسقوط مسبقًا- وتدميرها وإبادة أهلها وقتل فارسِها، وهي غايةٌ ساميةٌ -بالنسبة للعُصبة- من أجل تحقّقها تُبرّر أي وسيلة، ووسيلة الاستئصال هذه المرّة ليست سمًا قاتلًا بل قُنبلةً نووية!
وبعكس الجوكر يُعلِن ممثّل العُصبة هذه المرّة، الإرهابي و“الشر الضروري” -كما يَصِفُ نفسه- باين أنّه يملك خُطّة، فيؤكّد: “ليس مُهمًا من نحن، المُهِمّ خُطّتنا!”؛ فالأفراد غير مهمّين، الجميع لا قيمة لهم، المهم الخُطّة التي تنشط في الفوضى وتتحقّق في ظلّها ويموت الكل من أجلها، إبادة شاملة وعادلة وعَدَمٌ كاملٌ لا يقبل التنازلات هو جوهر هذه الخطّة التي هي بمقام الأخّ الكبير، الذي لم يكن يومًا موجودًا ككيانٍ فعلي، لكنّه يحكم ويبطش.
المؤمن الصادق والحقبة الجديدة للحضارة الغربية
يأتي باين إلى چوثام ويقيم في أسفل عالمها كشيطان، ينتشر ببطء وينهش جسدها كسرطان! يُعدُّ جيشًا سِريًا لتنفيذ وعد عُصبة الظلال بأن يكون مصير هذه المدينة الفاسدة “الاستئصال” لتبدأ بعده “حقبة جديدة للحضارة الغربية” كما يُعلِن باين الذي يُهاجم بعض مظاهر هذه الحضارة مثل البورصة وملعب كرة القدم الأميركية، ومثلما فعل الجوكر قبله حين اقتحَم حفلًا لأشخاصٍ مُتحضِّرين ومُتمدّنين! وهُنا مجدّدًا لا بُد من استحضار الصراع بين الغرب و”الإرهاب” وكيف أنّ هذا التهديد حتى وإن مرّت عليه فترة غيابٍ وسُبات إلّا أنّه دائمًا جاثمٌ على قلب الغرب ويحضر في هواجسه حتى في غيابه.
ولأنّ العدوان الخارجي الواضح سيَجِد مقاومةً ولن ينجح لوحده في نشر الفوضى، يعمَد باين إلى استخدام خطابٍ ثوري، مُوجّهٍ إلى معذّبي أرض چوثام، يَصبّ من خلال عباراته التحريضية، الوقود على نيران الغضب والحقد الطبقي المتأجِّجة في نفوسهم ليُسرّع قدوم يوم الحساب؛ فيُوهمهم بأنّها فرصتهم لاستعادة مدينتهم وأنّ كلّ ما يجري هو ثورةٌ على الطُغاة المُتسلِّطين، لتصبح السلطة في يد شعب چوثام.
هذا الشعب لا يعني شيئًا لباين ومشروعه، الذي لا قيمة فيه للفرد ولا للجماعة، لكنّه يستخدم ما أسماه إيريك هوڤر في كتابه المؤمن الصادق4 “آلية غرس الاستعداد للقتال والموت”، حيث يُبيّن هوڤر أنّ هذه الآلية “تعمل على تذويب الفرد في المجموعة المُوحّدة المترابطة، بإعطائه نَفْسًا جديدة متخيّلة، تغرس فيه اتّجاهًا إلى احتقار الحاضر وشغفًا بالأشياء القادمة التي سوف تجيء في المستقبل وتشحنُه بالعواطف المُتفجِّرة”. لكن لا أشياء قادمة سوف تجيء إلّا الموت بعد أن تتفجّر چوثام، ولا مستقبل سوى النهاية.

المجيء الثاني للمُخلِّص
يَنهَضُ واين من حُفرة الماضي المُظلِم، ليكون فارس الظلام المُنقِذ، المُخلّص المُنتَظَر الذي يعود مُجددًا وقت القيامة، قيامة چوثام، ليقود أهلها في الملحمة الكبرى والفتنة العُظمى، في الحرب الأخيرة بين مشروع المعنى والنظام والقانون والمرجعية وإحياء النفس البشرية، ضد مشروع العدمية التدميرية المجنونة والفوضى الهدّامة والاستصال وقتل النفس بغير نفس.
إنّها حرب نهاية الكون فعلًا؛ چوثام هي مركز هذا الكون (وهُنا لا يُمكِن للمرء أن ينسى مشهد المعركة بين رجال أمن چوثام وجيش عُصبة باين ومرور باتمان فوقهم ليُعطي رجال الأمن دفعة معنويةً ويبثّ في نفوسهم العزيمة وفي قلوب عدوّهم الرُعب. ولا يمكن أيضًا إغفال دور موسيقى هانز زيمر في إضفاء الطابع المَلحَميّ وتعزيز الأجواء القيامية)، أمّا واين فهو ليس إلّا المسيح الذي سيَفدي مدينته بدمه (أو دم أسطورة باتمان)، بما تُمثّله من رمزيات وجماليات.

ومع نهاية هذه الحرب الكونية وختام هذا المقال، يعود المرء للتساؤل بعد مُضيّ أكثر من 10 أعوام على آخر أجزاء ثُلاثية فارس الظلام: هل كان الفارس الحقيقي بروس واين/باتمان فعلًا؟ أم كريستوفر نولان؟ الذي يبدو عبر هذه الثلاثية، مُكافحًا ضد عصره ومنتصرًا للنظام بمعناه الأشمَل ومُحافِظًا على شيءٍ من المعنى. على النقيض تمامًا من مُعاصريه من صنّاع الأفلام الّذين قد أفضّل الكثير منهم عليه (چاسبَر نوي وديڤيد كروننبرچ مثلًا لا حصرًا).
وفي الوقت الذي تَرسو فيه كثيرٌ من الأعمال السينمائية المُعاصرة في ميناء الفوضى والعدمية، ترسو سُفُن ثلاثية فارس الظلام في ميناءٍ آخر، معادٍ بشكلٍ جذري لها وداعمٍ للنظام والمعنى ومساندٍ للقانون، ولهذا السبب يُمكن للبعض بكل سهولة اتهام نولان بأنّه كان يمينيًا ومُحافِظًا جدًا -في الجزء الثالث والأخير تحديدًا- ومُؤيّدًا شرسًا للدولة وللوضع القائم والأمر الواقع وضد “الثورة” و”الثوّار” بالمُطلَق!
ومع جماليات النهايات الملحميّة هذه، إلّا أنّ العودة للواقع تُفسدها؛ فچوثام نالت البطل الذي تستحقّه وأنقذها.. الملياردير بروس واين. ولسوء الحظّ فإنّ صحراء واقعنا ليس فيها أثرياء مثل واين أو حتّى توني ستارك (الرجل الحديدي) من عالم مارڤل، بل أشخاص على شاكلة إيلون ماسك وبيل غيتس ودونالد ترامب وآخرون أكثر سوءًا، منهم “مُؤثّرون” لا نعلم بماذا يؤثّرون، ونَحصُل عليهم كأبطالٍ نستحقّهم بلا شك.
المصادر:
- البهيموت: بنية الاشتراكية القومية (النازية) وممارستها – فرانز ليوبولد نويمان، ترجمة حسني زينة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
- جامع البيان في تفسير القرآن – محمد بن عبد الرحمن الإيجي الشيرازي الشافعي ومعه حاشية محمد بن عبد الله الغَزنوي، تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية
- مقدّمة ابن خلدون – عبد الرحمن بن خلدون، دار الكتب العلمية
- المؤمن الصادق: أفكار حول طبيعة الحركات الجماهيرية – إيريك هوڤر، ترجمة الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي، مؤسسة الانتشار العربي، العبيكان، كلمة
فارس الظلام, قتال, كريستيان بيل, نولان, هيث ليدجر, الفوضى, المؤمن الصادق, النازية, اليمين, اليسار, الأصولية, الإرهاب, الاستئصال, الثورة, الجوكر, الحشاشين, الحضارة الغربية, الدولة, الراديكالية, الرجل الوطواط, ابن خلدون, باين, باتمان, بروس واين, بطل خارق, توم هاردي, ثلاثية, دي سي, رأس الغول, عصبة الظلال -
للأسف، إنّها ليست نهايتنا! أو: عن الخطاب الذي يستحق سخريتنا


«لقد كان الخوف، الهوى الوحيد في حياتي»
توماس هوبز، من مقدّمة كتاب “لذّة النص” لرولان بارت
«ثمّة عدوى واحدة تنتشر أسرع من الڤيروس، ألا وهي الخوف»
رواية الجحيم – دان براون
لا يحظى أصحاب الخطابات الجنائزية والرؤى القيامية بالنصيب الذي يستحقونه من النقد ويتم حرمانهم من السخرية منهم والاستهزاء بهم، لصالح أنصار نظريات المؤامرة من أمثال ديڤيد آيك وعلياء جاد وغيرهم، مع أنّ الفريقين يحقنان خطاباتهما بنفس المادة القاتلة: الخوف!
لكن الخوف بذاته ليس مشكلة؛ فهو غريزة ضرورية تُزوّد المرء بما يحتاجه من الحذر تجاه “إخوته” البشر، وتحميه من الوقوع في شِراك وفِخاخ الحياة المزروعة في كل أركانها، وتساعده على معرفة أعدائه الذين يحتاج وجودهم أكثر من “أصدقائه” في سبيل البقاء لاعبًا على حلبة صراع الحياة.
الخوف الذي أتحدّث عنه بوصفه مشكلة، هو المُضخّم والمبالغ فيه، ذلك النوع الذي يتحوّل إلى مادةٍ مخدّرةٍ للتفكير والتساؤل ومعطّلةٍ للحسّ النقدي. ويتم الترويج له من قبل تحالف أجهزةٍ يعمل بجد ويكد، لكن لا لحماية الناس ولا خشية فقدان حيواتهم؛ فهو لا يخشى إلّا فقدان شيءٍ واحد.. الهيمنة. وادّعاء حماية الناس وحفظ أرواحهم من المخاطر والتهديدات العظيمة، إحدى وسائل الحفاظ على هذه الهيمنة، أو تعزيزها؛ فهي لا تقلّ ولا تنقص ولا تكتفي بقدرٍ معينٍ أو تصل إلى الإشباع، بل تفيض دومًا وترتقي باستمرار لتصل حدودًا بلا حدود، يمكنها عندها أن تستفيد من أعدائها، فيغدو مقاومها خادمها من حيث لا يشعر.
صاحب الخطاب الجنائزي والرؤيا القيامية، يُشيّع البشرية إلى مثواها الأخير ويُبشّر بابتداء النهاية ودُنوّ القيامة، وقد يفعل ذلك شاهرًا سيف تخصّصه الأكاديمي، ليؤكّد: “المليارات ستموت.. سينقرض البشر.. نحنُ نعيشُ في أسوأ عصورنا، وإن لم نفعل شيئًا سنفقد أحبّاءنا وسيموت الجميع وسينتهي الكون وتقوم القيامة أو نذهب جميعًا للعدم” وفي تأكيده هذا لا ينطق عن الهوى، بل ينهلُ من وحي التخصّص الأكاديمي التي اصطفاه نبيًا له.
وفي كل زمانٍ من أزمنة الحرب والموت، يُسارع صاحبنا مُنتشيًا، إلى نشر نبؤاته وتوزيع بياناته على مختلف المنصّات. وقد دأب على فعل ذلك منذ عصر ما قبل هذه المنصّات؛ ففي كل حربٍ حدثت وكارثةٍ طبيعيةٍ وقعت أو وباءٍ استجد، بَشّر الجنائزي القيامي على الدوام، باقتراب نهاية العالم وبثَّ الرعب في قلوب الناس، فقدّموا تنازلاتٍ تتعلّق بحرياتهم، لكي تتم حمايتهم من هذا الخطر، الذي ظهر مع الوقت أنّه لم يكن مختلفًا عما واجهه أسلافنا الذين كانوا محرومين من الأدوات المعرفية المتقدّمة والتقنيات المتطوّرة لإنسان اليوم.
وإذا أردنا المقارنة، مخاطر اليوم “قد” تبدو صغيرة أمام مخاطر الماضي الكبيرة. لكن يبدو أنّ هناك علاقةً طرديةً بين التقدّم العلمي والتطوّر التقني وتدهور قوى الإنسان “الحديث” وانحطاط عزيمته في مواجهة الكوارث والأزمات، أو أنّ البشر أصبحوا يخافون على بعضهم بجنون، بدافع الحبّ والإخاء والمساواة والمصير المشترك… إلخ، لذلك يُبالغون في ردود فعلهم.
يُمارس الجنائزي القيامي وظيفته بدوامٍ كامل، مدفوعًا بحب الظهور وإثبات مؤهّلاته في مجاله الأكاديمي، أو لتحقيق ذاته ببساطة. أو لأسبابٍ عقائدية، مثل هوسه بأفكار الفناء الحتمي وإيمانه أنّ النهاية قادمة لا ريب فيها والمسألة مسألة وقت، وعند بداية أي أزمة جديدة، يرى أنّها الفرصة المواتية لتكون بداية النهاية.
لكن للأسف، وأقول “للأسف” مُتعمّدًا وصادقًا مُخلصًا.. لا تبدأ هذه النهاية ولا نرى شارة مقدّمة مسلسل الفناء الذي قرأنا عن أحداثه كثيرًا، لكنّنا لم نشاهدها! وإن حدث فناءٌ ما، فهو يستهدف جماعةً بعينها، كما كان -وما زال- يحدث في الإبادات العرقية والدينية والثقافية. وربما تُسبّب الأزمات نهايات، لكنّها ليست كالنهايات السينمائية، بل نهايةٌ للعالم السابق القديم الذي كنّا نعرفه وفناءٌ لنظامه.. كما حدث نتيجةً لهجمات الحادي عشر من أيلول و”الثورات العربية” وإفرازاتها وأزمة فيروس “كوفيد-19” وتبعاتها والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها والحروب الأهلية القائمة هُنا وهُناك.
يُذكّر هذا “النبي الكاذب” المُبشّر بنهاياتٍ لن تأتي، بالشخصيات التي تظهر في الأفلام، وتكون في العادة دينية أو لمجانين وسُكارى ومشرّدين يتمنون نهاية العالم ويريدون إقناع سكّانه بأنّ أمانيهم وقائع ستقعُ قريبًا. ويحمل هؤلاء لافتات عليها عبارات مثل: “النهاية قريبة”، “إنّها النهاية”. أو يتجوّلون وهم يُنذِرون بأنّ كل البشر سيموتون! وثمّة من يُصدّقهم دومًا ليكون مجنونًا مثلهم، ولا يخدم بالنهاية إلّا أولئك الذين يستمدّون -أو يُعزّزون- رزقهم وهيمنتهم بواسطة المجانين.. ولكن بعكس المثل الشعبي، هم ليسوا من طائفة “الهُبل” أبدًا!*الصورة من مسلسل “مسامير” – الموسم الرابع، الحلقة الثامنة.
** كُتِبَ في 13 كانون الأول 2020.
-
سوبرانو في مواجهة أعدائه: انتصار ضخامة الحيوان الأصلي على ضآلة الإنسان العادي


مع الصفحات الأولى من سفر تكوين آل سوبرانو، يبدو توقّع هيمنة أنتوني “توني” الدائمة وانتصاره المتواصل أمرًا سهلًا، وليست هناك الكثير من المفاجآت بخصوص ذلك، بعكس مصائر شخصيات يُفترَض أنّها رئيسة في أعمالٍ أخرى (نِد ستارك في لعبة العروش، مثلًا لا حصرًا). هذا التوقّع السهل مَردُّه ليسَ لحقيقة أنّ رجل المافيا الأميركي ذو الأصول الإيطالية هو البطل وبالتالي سينتصر، والانتصار هذا ليس حتمياً؛ فالبطل مُعرّضٌ للخسارة والنفي والتشريد والهزيمة بجوانبها الجسديّة والمعنويّة/الرمزيّة، أو على الأقل الأبطال الحقيقيين أو من نُريدُهُم أن يكونوا كذلك، الّذين لا تاريخ لَهُم.. لا أبطال تاريخ المُنتَصِرين.
إنّ تَشكُّل هذا التوقُّع بالهيمنة نابعٌ من ضخامة بطل العمل (هو بطلٌ مخالفٌ للعُرف أو بطل مُضَادٌ للبطولة التقليديّة)، وهذه الضخامة يُقصَد بها: تلك الرمزيّة المُمثّلة في سُلطَتِه وبَطشِه بوصفه زعيم عائلة ديميو الإجرامية في شمال نيوجيرسي ومُرعِبَ العائلات الأخرى. والحرفيّة المُمثّلة في بُنيته الجسديّة وقوّته الجسمانيّة. ومن البَدَهي أنّ ضخامة المرء لا تكفَل لَهُ التفوّق على أعدائه، ربّما تفعل ذلك في السجون وبيئات المراقبة والمعاقبة والإخضاع والضبط المُستَنسَخَة عنها بدرجات مُخفّفة مثل المدرسة، وحتى بين العصابات وفي الأحياء المُسيطَر عليها من قبل “البلطجية” أو “الزعران”، وفي هذه الأخيرة، قد ينهار بُرج الضخامة الجسدية والقوّة الجسمانية بطلقة مسدّس أو سيل طلقاتٍ من رشّاش أو بضربة سكينٍ غدّار.
لكن ضخامة توني سوبرانو تَهزِمُ الأسلحة بطريقةٍ سحريّةٍ تَجعلُ منه بطلًا خارقًا وإحدى قواه هي ضخامته ذات الوجهين: الرمزي والحرفي. لا شَكّ أنّ هذه الضخامة تُصاب بهذي الأسلحة الفتّاكة وتَقتَرِب من الموت على يد حامليها ومُطلِقي رصاصها، لكنّها تنهض دومًا لتُعلِن نَصرَها المظفّر وأنّ أعداءها الّذين فشلوا بقتلها.. ضَاعَفوا قُوّتها!

وهذه الصفّة المميّزة تتجاوز ظاهرها الفيزيولوجي/الحرفي لتتموضَع في باطن الرمز، وتُوصِل رسالةً مفادها أنّ كلّ خصمٍ لابن جوني سوبرانو ليسَ نِدًّا له، وأنّ مُناوئيه لم يعرفوا حجمهم الحقيقي في صراعهم المُميت معه. وتلعبُ هذه “الهِبة”، دورًا محوريًا على مدار ستّة مواسم، ولا يبدو أنّها مجرّد صدفة أو تفصيل ثانوي أنّ هذا المافياوي صاحب ملامح الوجه التي تبدو طفولية أحيانًا، ضخم الجثّة (الفضل لضخامة بُنية الراحل جيمس چاندولفيني.. صاحب الـ185 سنتيميترًا)؛ إذْ تتمّ الإشارة في عدّة مواقف وعلى لسان حلفائه وأعدائه إلى ضخامة بُنيته، وأحيانًا تأتي الإشارة على شكل سخرية من سُمنته، تُسترُ حسدًا على هذه الصفة التي يفتقر إليها من يُناصبونه العداء.
تُحيل تلك الضخامة إلى بداءة البشر، الذي فقد الإنسان الحالي أو “المُعاصِر”، الاتصال بها تحت إغواء -وأحيانًا إرغام- التمدُّن والتصنيع والقانون، والتحديث المستمرّ أو كما يُسمّيه زيچمونت باومان1 “التغيير الوسواسيّ القهريّ المُتَواصِل”، وتسهيل الحياة بالتقنية والذكاء الاصطناعي.. إلخ. ذلك الإنسان الموهوم بتمتُّعه بأمنٍ ليس في يده بل في قبضة حكوماتٍ ومنظّماتٍ وشركاتٍ ونُخَب، “الإنسان الفاقد للحُكم الذاتي والاستقلاليّة والمُبتلى بـتعطيل عملية السُلطة” بتعبير تِد كازنسكي2، الذي يُقارِن في بيانِه الشهير “المُجتمع الصناعي ومُستقبلُه” بين الإنسان البدائي الذي يمتلك غالبًا أمنه بين يديه (إمّا كفردٍ أو عضوٍ في مجموعة صغيرة)، و”الإنسان المُعاصِر” الذي وُضِع أمنه بين أيدي أشخاصٍ آخرين أو منظّماتٍ بعيدة عن مُحيطه وأكبر من أن يتمكّن من التأثير عليها شخصيًا.
بالطبع لا يعيش زعيم عائلة ديميو بأمنٍ دائمٍ، بل يُقيم في ديار الرُعب. لكنّه يَملِك التحكّم بأمنِه وحماية نفسه وعائلته من التهديد؛ إذْ إنّ عملية السُلطة عنده لم تتعطّل، بل يخوضها يوميًا ويُمسِك بزمامها تمامًا، ويَعرِف كيف يُلبّي نداء البداءة متى ما اقتضَت تلبيته.
توني ليس مجرّد رجلٍ ضخمٍ آخر؛ إنّه حيوانٌ بريّ، لا يزالُ فيه كما يقول جان بودريار3: “ذلك المعنى الذي لم يتغيّر للوحشيّة، تلك الوحشيّة الأصليّة للحيوانات التي هي موضوع رعبٍ وانبهار”. ولقد كانت وحشيّته موضوع رُعبٍ لقلوبنا وإبهارٍ لنا.. فنُعجَبُ به ونُحبُّه ونؤيّده على الرغم من معرفتنا بأنّه مُجرِم.. لكنّه أيضًا صاحب نمط حياةٍ أنيق، يتألّق مُرتديًا قمصان “ألوها” ويَسحَرُنا وهو يَنفُث دخان سيجار CAO ويلعب الغولف، ونشعر بفخرٍ يخالطه الانبهار بأنفسنا حين نعرفُ أنّه مِثلُنا.. يُصاب بالاكتئاب ويتعاطى البروزاك (Prozac).. وهو حيوانٌ وحشي لكنّه يُحبُّ البَطّ ويَرعاه!
ربما يُخبرنا هذا الشبه وتقول لنا تلك “الوحشية الأصلية” بأنّ هناك حيوانًا كامنًا في أعماق الإنسان مهما تحضّر.. مخلوقٌ همجيٌ موجودٌ منذ أن كان الذكر الأقوى أقرَب لغوريلا تصطاد ما تُريد وتظفَر به، وبتفوّقها على الغوريلات الأخرى تَسود. مع فارقٍ وحيد: ليس ثمّة هُنا غوريلات إلّا توني! وليس أمرًا عجيبًا أنّ الجانب الحيواني من “تي” طاغٍ على أفعاله أيضًا: هوسُه بالجنس مُمثّلًا بمُضَاجَعَتهِ لأيّ أنثى تَقذِفُها الصُدفة في طريقه، شراهته في تناوُل الطعام، إتقانِه لِلغةٍ واحدةٍ هي العُنف والتحدُّث بها بلكنةٍ همجيةٍ مع كُلّ من يَقِف عقبةً في مشواره إلى وجهة المجد. وما الدُبّ الذي ظهر في ساحة منزله إلّا رمزٌ لسوبرانو ذاته؛ إذ إنّ مصدر التهديد لأُسرته هو نفسه رَبُّها! وهُنا لا بُدَّ من استحضار حلم طبيبته النفسية جينيفر مِلفي حين حلمت بكلبٍ أسودٍ ضخمٍ يَنتقِم من مُغتَصِبِها الذي تمنّينا رؤيته مُعذّبًا على نحوٍ سادي على يد مريضها.. ذلك الحيوان الوحشي، لكن رغبتنا بالانتقام بقيت مكبوتة.

على الضفّة المُقابِلَة لضخامة توني هُناك ضآلة خصومه: بعد إلقاء نظرة سريعة عليهم من أوّل الأعداء وحتى من يُفترَض أنّه آخرهم فِل لوتاردو، لن نجدَ واحدًا منهم يُضاهيه في بُنيَتِه وقوّته، وكأنّ الأميركي ديفيد شايس والذين معه من خالقينَ لهذا العمل البديع، تعمَّدوا أن يكون المُمثّلون المؤدّيون لأعداء بَطلِه ضئيلين جسديًا؛ لنحسّ دائمًا بتفاهتهم وسخافتهم ولكي لا نأخذ واحدًا منهم على مَحمَل الجِدّ ونطمئن بأنّ النصر مكتوبٌ لبطلنا دومًا وبأنّ هذا الآخر بالنسبة له لَمْ يَكُن جحيمًا، بل نعيمًا.. نعيمُ الضآلة التي تَسحَقُها الضخامة بكل أريحيّة.
هذه الصفة ليست على المستوى الفيزيولوجي فقط، إذ يتمتّع الأعداء بضآلةٍ معنويةٍ واضحة أيضًا؛ بدءًا من عمّه كورادو جون “جونيور” الزعيم الرسمي لكن الشكلي فقط لعائلة ديميو. صحيحٌ أنّه ليس قصيرًا ولا ضئيلًا بشكلٍ ملحوظ، لكنّه إنْ وُضِعَ جنبًا إلى جنب مع ابن أخيه، بدا هزيلًا وضئيلًا (ولتقدّمه بالعمر دور)، عدا عن الجانب الهَزَلي أو التهريجي لشخصيّته وليسَ عجيبًا أنّه ظنّ نفسه لاري ديڤيد، حين شاهده على التلفزيون في مسلسل Curb Your Enthusiasm.
يبدو العَمّ جونيور أقرب لطفلٍ يَسهُل التحكُّم بِه من قبل أُمّه المُتلاعِبَة، ولقد تحكّمت بِه كدُمية متحرّكة ووجّهتهُ بخيوط دهائها أينما أرادت، زوجة أخيه ووالدة توني.. ليفيا. لقد حاول جونيور جاهدًا أن يكون زعيماً حقيقيًا للمافيا -لا بالاسم فقط- لكنّه فشل، لا لسُلطة ابن أخيه وقوّة تحالفاته ودهائه، إنما لأنه بِبُنيته وتكوينه دون ذلك؛ لأنّ الطبيعة لم تنتخبه ولم ينشأ ويرتقي ليكون قياديًا حقيقيًا. وبالرغم من ذلك، شكّل العمّ لابن أخيه مصدرًا للقلق وللكثير من المتاعب، وكاد أن يتسبّب في موته مرتين، لكن كلّ ما فعله أو حاول فعله وإن كان فيه تهديدٌ وجوديّ، إلّا أنّه ليس أكثر من إزعاج قطٍ منزليٍ لنمر.
ثمّة أعداء آخرون كانت خصومتهم أكثر جديّة وتهديدهم أشدّ خطورة، مثل ريتشي أبريل، ذاك المافياوي الأصيل، المُنتَمي للمدرسة التقليدية، الشيطان الرافض للسجود لزعيم المافيا حديث العهد. ريتشي صغير الحجم ومن أقصر خصوم سوبرانو، لكنّه كبيرٌ في جرأته وقوّته و”جنونه”؛ إذ مستعدٌ لممارسة أكثر أشكال العنف ساديةً على خصومه بضميرٍ مُرتاح، ومواجهة من هم أكبر منه بكل جسارة دون الخوف من الخسارة. مشكلته الوحيدة أنّه لم يَعرِف حجمه جيّدًا ولم يُتقِن عقد تحالفاتٍ تُعوّض ضآلته! وربما في سيناريو موازٍ كُتِب لريتشي أن يكون دوره أعظم على حلبة المصارعة المافياوية، حيث لم يرتبط بأخت توني جانيس التي قتلته فجعلت نهايته سريعة.. وضئيلة.


مع تقادم الفصول يتعثّر توني بخصومٍ يتراوحون بين ضآلةٍ لا تُؤخَذ على مَحمَل الجِدِّ لكنّها مزعجة، وأخرى يمتزج فيها الإزعاج بالتهديد الوجودي، ويصبر عليها مضطرًا، حتى ينفذ مخزونه من الصبر، فيضَعُ حَدًا لها. الحديث هُنا عن رالف سيفاريتو، المُختَل وكاره النساء والمكروه من الجميع، والذي تدور بينه وبين زعيمه رحى حربٍ باردة على مدار موسمين، تنتهي بقتالٍ مميت على غرار لعبة الفيديو Mortal Kombat حيث يَظفرُ الأضخم بنصرٍ لا تشوبه شائبة Flawless Victory يُجهِزُ معه على خصمه المهزوم بحركةٍ ختاميةٍ لا تقلُّ وحشيّةً وإذلالًا عن حركة الـ Fatalityفي تلك اللعبة الشهيرة.
لكن الحاصل على لقب الخصم الأكثر ضآلة بدون مُنازِع هو آخر الأعداء فيليب “فِل” لويتاردو، زعيم عائلة لوبيرتازي في نيويورك -بعد رحيل جوني ساك-؛ إذْ كان غلبُه مسألة وقت وكُنّا نَحنُ منذ ظهوره نُشاهِد مباراةً نعرف مُسبقًا نتيجتها لكنّنا مُستمتعون بأحداثها! فِل كان ينظُر لكل ساحة الصراع المافياوية وعلاقاتها المُتَشابكة وتطوّراتها المُتسارِعة بمنظار الجيل القديم ويُعالجها بأدواته التي عفى عليها الزمن. وهو استعراضيٌ وانفعالي، تَغلِب عليه صفات المتنمّر التقليدي الذي يحتاج لأن تكون عصابته حوله لكي يفرد عضلاته، أمّا لوحده فيستحيلُ دُودةً مُنكَمِشَة! إنّه مُدّعٍ للقوّة لا مالكٌ حقيقيٌ لها، تَعوزُه الكاريزما التي يملك خصمُه فائضًا منها. وربّما مشهد مطاردة توني لفِل بالسيارة على وقع أنغام أغنية Rock the Casbah لفرقة الروك الإنكليزية The Clash، في الحلقة السابعة من الموسم الخامس، هو أفضل تجسيدٍ لفضل ضخامة الأوّل على ضآلة الثاني، أمّا خاتمته فقد جاءت تافهةً تليقُ بـ”شرير تافه” مثله!
حتّى أولئك البعيدين عن الضآلة، من خصومٍ كان توني يحترمهم وعلاقته بهم تتأرجَح بين العداوة والتحالُف والاختلاف والتآلف في سياق حربٍ باردةٍ طويلة، اتّسمت خاتمتهم بالضآلة، مثل جوني ساك الذي سُجِنَ ثم أصيب بالسرطان ليقضي نَحبَهُ على فراش مستشفى السجن وبجانبه عائلته.. لا في ساحة الحرب بين العائلات. هُناك أيضًا خصمان مُهمَّان من عائلة ديميو يَنطبِقُ عليهما الشيء ذاته: ابن العم توني بلونديتو أو توني بي الذي كانت نهايته مثل قصّته كلّها.. مأساة! أو فيتش لا مانا صاحب الأمجاد القديمة والمُتشوّق لإعادة ماضيه الذهبي، الذي تجنّب الزعيم إزعاجاته المتتالية بإبعاده إلى السجن.. لا إلى العالم الآخر كما يفعل بالعادة.
ثمّة مُفارَقَة طريفة لا يُمكنُ إهمالُها، وهي أن الشخص الذي يُضاهي توني ضخامةً كان بوبي باكاليري أو بوبي باكالا الابن، أحد جنوده ومُساعديه الأوفياء وزوج أُخته الذي استقرّت عليه ومعه. بوبي وإنْ كان توأم سوبرانو بالضخامة إلّا أنّه ليس نِدًا له؛ فهو رجلٌ بسيط، هادئٌ وصادقٌ وخجول، مخلصٌ لزوجته ولم يكن قاتلًا في حياته إلّا قبل أن يُصبِح هو نفسه قتيلًا بفترةٍ قصيرة.. وكل هذه الخِصال يَحملُ سوبرانو نقيضها. لكن مع ذلك، تَفوّق بوبي على زعيمه وشقيق زوجته في عراكٍ مشحونٍ بالثُّمالة والأحقاد المدفونة بين الرجلين، بدا كل واحدٍ منهما -بالنظر إلى حجمهما الضخم- دببةً تُقاتل بعضها.


هذه الضخامة الجسديّة المُعزّزة بشخصيةٍ ضخمة والمدعومة بقوّةٍ ممزوجةٍ بالمكر، تُصيبها نوباتٌ من الضآلة على يد ألدّ الأعداء وأخطرهم: “الأم”.. ليفيا، المُصابة بـ”اضطراب الشخصية الحدّية” الكارهة لابنها والمتلاعِبَة به والمتسبّبة دائمًا بالمتاعب له، والتي تلاعبت أيضًا بعمّه لقتل ابن أخيه الوحيد. العلاقة الشائكة والمضطربة بين الابن وأمّه، تنعكس على كثيرٍ من أفعاله بشكلٍ غير واعٍ، مثل وقوعه في غرام نساء فيهنَّ الكثير من صفات أمّه وحاملات لبعض اختلالاتها واعتلالاتها، وهُنا تُضاف مفارقة أخرى إلى رصيد هذا العمل الحافِل بالمُفارقات: زوجة توني كاراميلا كانت نقيض أُمّه وعكس عشيقاته!
كل الأعداء كان يسحقهم زعيم مافيا جيرسي كالحشرات بين يديّه الغليظتين، ولم يكونوا ليتركوا أيّ أثارٍ عليه. بينما خلّفت فيه أمّه آثارًا وعقدًا وجروحًا وأزماتٍ لم تذهب حتّى بعد رحيلها! وكم هو أمرٌ مثيرٌ للسُخرية أنّ الأمّ بنَسجِها للعُقَد في نَفس ابنها منذ الطفولة، تستطيع بمنتهى السهولة تحويل الشِدّة التي تُميّزه إلى هشاشةٍ تُضعِفُه!

في النهاية تنتصرُ ضخامة الحيوان الوحشيّ بكل معناها الأصليّ على ضآلة الإنسان العاديّ، وليس في عالم سوبرانو مكانٌ للمثاليات ولرومانسياتٍ حول شهداءٍ أضرّوا بالحقيقة -كما يقول نيتشه4– والقوي يَغلِب الضعيف، سُنّة الكونِ في أَبسَط صورها! لكن، ثمّة هناك احتمالٌ بأنّ هذه الضخامة قد غلبها المكر، وبأنَّ نرجسيّتها وغرورها منعتها من رؤية كافة الأعداء، ولم تُدرِك بأنّ العدوّ قد يكون مُختَبئًا مثل الشيطان بين سطور مواقفَ منسية وتفاصيل حياةٍ عادية، وبأنّ أسوأ الاحتمالات -أي الموت- قد لا تحدث على يد الأعداء البارزين بوضوح كعنوانٍ رئيسيٍ في صحيفة، بل على يد أشخاصٍ ثانويين، لا يحسّ المرء بوجودهم، يقبعون على هامش وجوده، يتسرّبون بهدوءٍ كقطرات ماءٍ تتراكم مُسبّبةً غرقه.. ويتسلّلون إلى مرماه ليسدّدوا هدفًا وحيدًا.. هو إنهاء وجوده.
وإنْ صحّت النظرية التي تقول بأنّ توني قُتِل في تلك النهاية -التي أبدعها دايفيد شايس وتركنا من بعدها حائرين حتى بعد مرور أكثر من 15 عامًا على عرضها- وأنّ السواد الذي في ختام الحلقة الأخيرة هو إعلانٌ ضمني بذلك، فهي مفارقةٌ كُبرى أنّ هذا الزعيم الضخم مُرعِب الجميع ومُبيد أيّ تهديد.. لم يَلقَى حَتفَه على يد عمّه أو فيل ليوتاردو أو ريتشي أبريل أو حتّى مكتب التحقيقات الفيدرالي بل على يد شخصٍ لا نعرف من هو، رجلٌ من عامة الناس يرتدي سترة من العلامة التجارية Members Only، وغالبًا هو مُجرّد منفّذٍ لمؤامرةٍ تَقفُ وراءها زوجة أحد جنوده المُنتحرين -بسببه- يوجين بونتيكورفو وربما بالاشتراك مع باتسي باريزي الذكي والماكر، الذي أصبحَ مُقرّبًا من توني أكثر بعد خطبة ابنه من ابنة زعيمه. وهذه السيناريو الذي يبدو منطقية جدًا، إن حدث فعلًا، فهو أمرٌ مثيرٌ للسُخرية بالرغم من مأساويته، أنَّ رجلًا على هذا القدر من الضخامة قد انتهى بتلك الضآلة!


مراجع:
- الحداثة السائلة – زيچمونت باومان، ترجمة حجّاج أبو جبر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر
- المجتمع الصناعي ومستقبله: بيان مفجّر الجامعات والطائرات، تِد كازِنسكي، ترجمة رقيّة الكمالي، منشورات تكوين
- المصطنع والاصطناع – جان بودريار، ترجمة جوزيف عبد الله، المنظّمة العربية للترجمة
- نقيض المسيح – فريدريش نيتشه، ترجمة علي مصباح، منشورات الجمل
-
حسرة العالق في الصحراء


هَرَبَ صفوان المِقدام من الصحراء مع أنّ فيها مالًا وفيرًا يضمن له أقلّ قدرٍ من التعاسة التي ورثها عن والده، بعد أنْ سأم حرّها وتَعِبَ من الصخرة التي كانت تُوضَع على صدره يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الثامنة مساءً. وكان ربّ عمله أميّة السائد يقول له: إنّ شركتنا أفضل من المنافسين الآخرين في أسواق عبودية الصحراء؛ فهي لا تُجبِر عبيدها المكرّمين على العمل لأكثر من 11 ساعة، بينما يُجبِر منافسوها عبيدهم المُهانين المذلّين على العمل 12 ساعة. ودأب أميّة على نُصحه: اقرأ كارل ماركس، لتفهَم هذا العالم أكثر! وكان صفوان حينَ يُنهي عمله يقف على رأس جبلٍ عالٍ -كأنّ نهايته تقود إلى إلهٍ ما- كان يسكن عليه ويحلم بالقفز من عليائه ليهبط إلى فردوسٍ مفقود، نسي أين ومتى فقده.
وفي طريق عودته إلى الديار، أخذ صفوان يفكّر في مدينته التي لم تكن فردوسًا لكنّها لم تكن صحراءً ولم يكن أهلها عبيدًا، وكان فيها ماء وعشب أخضر وفاكهة وفيرة وهواء عليل وفصول أربعة ووجه حبيبته نسمة: “آه كم اشتقتُ لها، لمعانقتها والاتحاد معها، للفرح والحزن برفقتها، للحديث في ما لا يُهمّ العالم لكن يُهمّنا، للمزاح معها حول قِصَرِ قامتها الذي كنتُ أحبّه جدًا، لالتهام المُجدّرة التي كانت تُعدُّها بدفء”.. حدّث نفسه وهو يستمع لأغنيةٍ عنوانها “ثلج” اعتاد إهداءها لنسمة التي كانت على الدوام ثلجًا يُطفئ نار البؤس التي أوقدها والده مِقدام الذي أصرّ على مجيئه للعالم وعوضًا عن تصحيح هذا الخطأ -خطأ المجيء إلى عالمٍ هرمٍ كهذا- اختار أن يكون مسقط رأسه مدينةً لا تتقنُ إلّا إخصاء الآمال.
وحين حطّ رحاله في مدينته، وجدها مدينةً أخرى؛ كانت مظلمةً مع أنّ الساعة الثالثة عصرًا، والطقس باردٌ بقسوةٍ مع أنّ الربيع حلّ على المدينة قبل أيام! ولم يعد فيها أيّ ماءٍ أو عشبٍ أخضر أو مناظر طبيعية تُعقّم العين من لوثةِ عالمٍ سعيدٍ بِقُبحه وإجرامِه. ليس هناك إلّا حجرٌ مُملٌّ يفتح الشهية لموتٍ أرحم من المَلَل وأَسْفَلت تنطلق منه أيادٍ تخنق رقابًا اعتادت على الخضوع وحديدٌ يُسمّم الروح المتبقّية في زجاجة كحول الوقت وسياراتٌ مُدرّعةً يقطنها رجالٌ يرتدون النظارات السوداء والشوارب الكثّة والرجولة المستعارة، وأضواء ملوّنة قويّة وضوضاء عنيفة وكأنّ المدينة استحالت ناديًا ليليًا ضخمًا لكن لا بلا رُوّاد؛ إذْ علم صفوان أنّ سكّان المدينة تم التخلّص من أغلبيتهم، فيما تمّ استيراد جنودٍ من الخارج ليحرسوا المدينة الفارغة تقريبًا من البشر، والغاصّة بمزيجٍ سُرياليٍ من الخواء والضوضاء.
وعَلِمَ صفوان أنّه تم الإبقاء على الناس الذين يقل طول قاماتهم عن 170 سَنتيمترًا، ولحسن حظّه كان طوله 169 سم وكان هزيلًا كمعنى الحياة. حتى أنّ الجنود المُستورَدين الذين يحرسون المدينة كادوا أن يقتلوه بنيرانهم الصديقة بالخطأ من شدّة ضحكهم على هيئته وسحنته، حينَ ذهب إليهم طالبًا تصريحًا بالعيش في شبح مدينته.
وحين أَخذَ يتجوّل في المدينة التي لا تعرف إلّا الليل الذي اغتصَب النهار والضوضاء المشبّعة بالوحدة وقصيري القامة، بادرَ إلى سؤال أحد الباعة المتجوّلين -وكانَ قَزَمًا- عمّا حدث للمدينة، فأجابه:
إنّها فسدت وفسقت واعوجّت كثيرًا، فكما ترى كلّها أضواء وضوضاء وقد حلّ فيها الوباء. لذلك اجتمعت لجنة من الرجال الأخيار الصالحين الذي يجري حُبّ هذه المدينة في عروقهم وكؤوس عرقهم، وقرّرت أنّ سكّانها هم المسؤولون عمّا حدث فيها؛ فقد فسقوا فيها ودمّروها تدميرًا، ورأفةً منهم بسكان المدينة الذين يُحبّونهم أكثر من أمهاتهم، قرّروا معاقبة متوسطي وطويلي القامة فقط بإبادتهم، ولقد نجا من هذه الإبادة الرياديّة الخلّاقة كلّ من كان تحت 170 سم، وأنا واحدٌ منهم كما ترى!
أنهى البائع القزم شرحه ضاحكًا مُقَهقِهًا على ما يُفترض أنّها مزحة عن قِصَر قامته الشديد! وقبل أن يذهب أمسك به صفوان بقبضةٍ قويّة بدا معها القزم كيسًا من العدم، وسأله:
-معذرةً على أسئلتي الكثيرة، لكنّي جئتُ للتوّ من السفر. في حديثك قُلت إنّها كانت إبادةً رياديةً وخلّاقةً، ماذا يعني ذلك؟
*لقد كانت إبادةً الهدف منها مصلحة المدينة، فمثلًا تم طَحنُ عظام البعض وتزفيت الشوارع بها، والآن كما ترى شوارعنا تتزحلَق فيها السيارات وكأنّها في مدينة ألعابٍ ترفيهية! وآخرون تم قلع عيونهم ووضعها في أعمدة إنارة الطُرُقات وكما ترى المدينة تشعّ بضوءٍ يخطف الأبصار والحمد لله. والبعض تم سلخ جلودهم واستعمالها لكسوِ الأثاث الذي يستريح عليه بعد جُهدٍ جهيد الرجال الذين أنقذوا المدينة من سكانها الفاسدين العابثين. وكلّ الذكور الذين تم الخلاص منهم قُطعت أعضاؤهم التناسلية وتم تحنيطها بالتجميد وتُستخدَم اليوم كأدواتٍ جنسية للراغبين بتجريبها وللحالمين بامتلاكها! وبالمناسبة أنا أبيعُ أثقل أنواعٍ وأكبار أحجامٍ منها، فاشترِ منّي وستكون راضيًا وسأقدّم لك سعرًا مُغريًا! اسمع مني.. خذ هذا، إنّه آخر موديل في السوق، قُطِعَ اليوم وطوله 27 سم.. هذا نادر!
-أوه هذا لطفٌ منك، لكن شكرًا، بالكاد أستخدم القطعة التي عندي! سؤالٌ أخير.. أعِدُك!
* لقد أطلت في أسئلتك! أمامي عمل كثير وزبائن وعملاءٌ مستعدّون لبيع أرواحهم لقاء عضوٍ واحد! هيّا قُل بسرعة ولا تهدر وقتي أكثر.
-لماذا كل البيوت أنوارها مُطفأة، ويبدو أنّ لا روح فيها؟
*حسنًا، لقد قرّر الرجال الذين أنقذوا المدينة أن يعيش سكّانها الصالحون في الشوارع، وليس في ذلك تشريدٌ أبدًا -وفقًا للبيان الذي تمّت تلاوته فور بدء مشروع الإبادة الرياديّة- بل حبًا بالأهالي وصحّتهم؛ فالنوم على الأرصفة وعتبات المنازل ومداخل العمارات عملٌ ثوري وفيه التحامٌ بأُمّنا الطبيعة. وكذلك وكما تعلم الأرض لله يرثها لعباده الصالحين، فما حاجة الصالحين الذي يملكون الأرض لبيوتٍ كريهةٍ سامةٍ لا شيء فيها إلّا المعيشة الضنكى. ثم إنّ ذلك يوفّر عليهم البحث عن عمل من أجل النقود اللعينة؛ فالإنسان الصالح يحتاج النقود فقط من أجل منزلٍ يأويه، وقد كشف هؤلاء الرجال المباركون أنّ فكرة المنزل بأساسها مجرّد مؤامرة ضد الطبيعة البشرية!
قَطعَ القَزَمُ كلامه، وأخذ يُعاين بيدين صغيرتين.. قضيبًا ضخمًا ليتأكّد من جُودَتِه، ثم هَمَسَ لصفوان:
بيني وبينك.. تَزعُم بعض الأنباء الخاصة والحصرية التي وصلتني ممّن أبيعهم هذه الأَقضِبَة، أنّ مجموعة مستثمرين لا يُعرف لهم بَلَد ولا سَنَد، قد ظَفرَت بعطاءٍ لتحويل هذه البيوت إلى مؤسّساتٍ وشركاتٍ ليذهب إليها هؤلاء الصالحون عندما يَملّون من المبيت والتجوال في أرض الله الواسعة، للترفيه والتسلية عبر ممارسة بعض أعمال الإنجاز والإنتاج مجانًا بالطبع.. فقد أُلغِيَ مفهوم العمل المأجور!
رَحلَ القزم وهو يصيح بأحجام الأَقضِبَة التي يبيعها وأسعارها. أمّا صفوان فشعر بكرهٍ غير مسبوقٍ للجنس البشري وتمنّى لو أنّ الإبادة شملت كلّ سكّان الأرض وحلم لو أنّه فقط أطول بسنتميترٍ واحد! ومن شدّة النصب الذي لاقاه من سفره، وجد نفسه مُسجّىً على رصيف خمارةٍ اعتاد على شراء العرق المحلّي اللذيذ منها. وشعر بخدرٍ مريحٍ يسري في أرجاء جسده، ربما لأنّ أحدًا لن ينهاه عن النوم على قارعة الطريق؛ فالتشرّد أصبح عملًا صالحًا وعلامةً على التقدّم. وغرق صفوان في نومٍ عميقٍ ودافئ على سطح الرصيف البارد، وولجَ على الفور في كابوس: ما زال في الصحراء، توضَعُ الصخرة على صدره من التاسعة صباحًا إلى الثامنة مساءً، ورأى ربّ عمله أُميّة السائد يأمر بإزاحة الصخرة قليلًا إلى اليسار وهو يهذي بكلامٍ عن فكر ماركس وأهميّته وراهنيّته، ويدعو العمال والفلاحين والطلبة إلى الثورة وهو يلوّح بأعلام شركاتٍ عابرةٍ للقارات.
وسرعان ما تحوّل الكابوس إلى حلمٍ جميل وبدأت الكلمات تخرج بصعوبةٍ من فم صفوان بسبب الصخرة الملقاة على صدره: على الأقل.. هنا يوجد مالٌ وفير ومقتنياتٌ متنوّعة وبأرخص الأثمان.. وما زال هناك بشرٌ من مختلف الأحجام حتى لو كانوا عبيدًا.. وهنا صحراء لكنّها صريحة كعاهرةٍ تحدّد بوضوح أجرها في الساعة، ويتعاقب عليها ليلٌ ونهار. وانغمس صفوان أكثر فيما كان كابوسًا ثم أصبح حلمًا ولم يعد يفرّق بينه وبين الواقع، لكنّه تذكّر حبيبته نسمة: “ربما هي الآن تزرع بعض الأمل”.. ثم رجع للمقاومة والتفريق بين الحلم والواقع وعاد الحلم ليتحوّل كابوسًا، وحاول الاستيقاظ لكنّه ظلّ عالقًا في الصحراء.
-
الإيطالي إليو بيتري مُحقِّقًا مع سُلطة فوق مستوى الشُبُهات

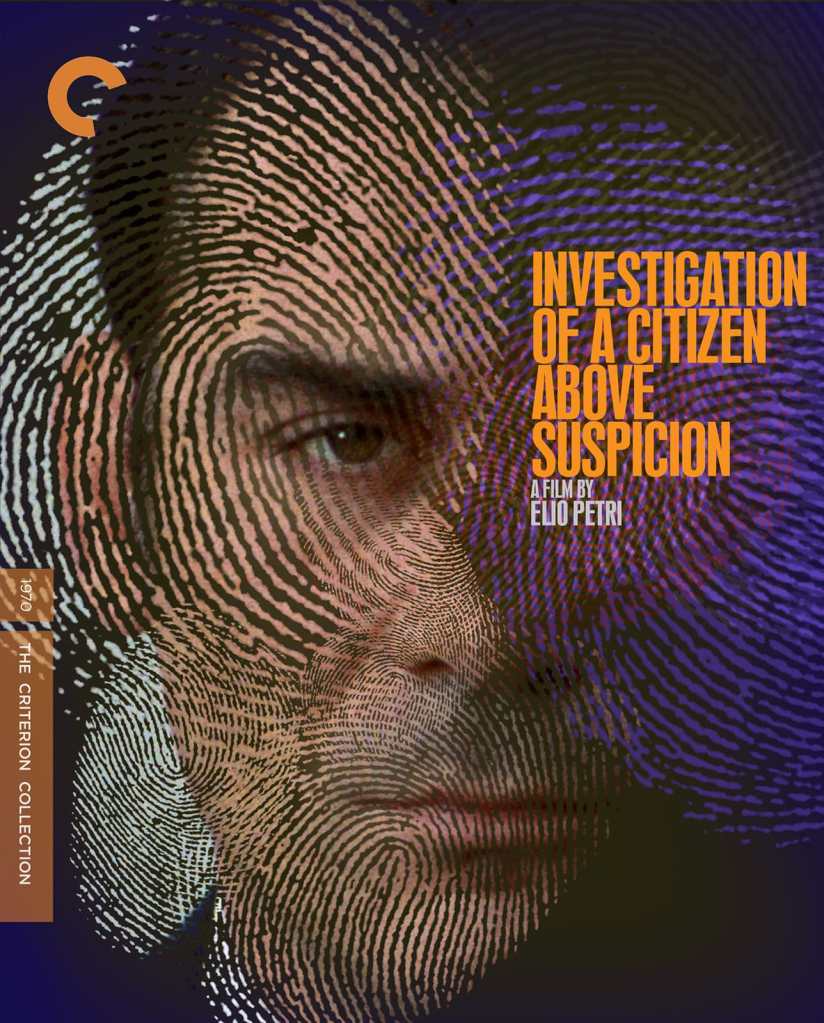
“لقد سُلِّمْتُ كُلَّ سُلطَةٍ في السَّماءِ وعلى الأرض”
إنجيل متى ۲۸: ۱۸
محقّقٌ فاسدٌ ومُتلاعِبٌ من شرطة روما، يقتل عشيقته، بالتزامُن مع ترقيّته إلى رئيس مباحث قسم الجرائم. هذا ما يحدث مع بداية فيلم “تحقيقٌ مع مواطنٍ فوق مستوى الشُبُهات”، الذي أخرجه الإيطالي الراحل إليو بيتري (صاحب فيلم الطبقة العاملة تذهب إلى الجنة) عام 1970، وحتى تلك اللحظة لا شيء غير عادي أو مثير للاهتمام. لكن حين يَحرصُ المُحقّق “دوتوري” أو “الدكتور” (الراحل جيان ماريا فولونتي) على تركِ أدلةٍ في مسرح جريمته -التي يُحقّق هو نفسه فيها!- تُثبت مسؤوليته عنها، يُصبِح الأمر مُحيّرًا ومُبهَمًا؛ إذْ يتساءل المرء: لِمَ قد يُقدِم رجلٌ صاحب سُلطةٍ منفلِتَة من عِقالِها على فعل شيءٍ أحمقٍ كهذا؟ لماذا تعمَّد إثباتَ مسؤوليّته عن جريمة القتل؟
ويبدو الجواب بَدَهِيًا أو لنقُل سهلًا، ويمكن استنتاجُه من عنوان الفيلم: ليُثبت المُحقّق أنّه “فوق مستوى الشُبُهات”؛ أنّه حتى لو كانت هناك حُزمةٌ من الأدلّة (بصماته، خيطٌ من ربطة عُنقِه، آثار حذائه، صورٌ له مع الضحيّة، أحد الشهود قد رآه، وغيرها) فإنّه بوصفه حارسًا للقانون وراعيًا للعدالة بريءٌ بالضرورة. وتلك الأدلّة التي تُثبت تورّطه في الجريمة لا تعني شيئًا أبدًا؛ فسُلطَتُه كرجل أمن تجعله في العلياء بعيدًا عن أيّ شبهةٍ قد تُدنِّس ذاته السُلطويَّة المقدّسة. وإن كان الدكتور/دوتوري الخصم، فهو أيضًا الحَكَم، إذا استعرنا تعبير المُتَنبِّي: خصمٌ للقانون والعدالة، وهو كذلك القانون نفسه وسُلطَتُه هي العدالة الوحيدة التي يُمكِن توفيرها.

لكنّ الأمر يغدو أكثر إبهامًا مع انتصاف العمل، فبعد كلّ محاولات إِلصاق التهمة بالآخرين (زوج عشيقته المثليّ، وأحد الطلبة “الأناركيين الفرديّين” الذي كانت تنام معه الضحيّة).. وبعد أشواطٍ طويلةٍ من التلاُعب المريض، يعترف المُحقّق الفاسد بمسؤوليّته الكاملة عن الجريمة لرؤسائه أو آباء النظام الّذين في السماء.. الّذي سُلِّمَ هذا الإنسان المُبَارَك بمشيئة قوّتهم كُلَّ سُلطةٍ على الأرض ومن عليها. لكنّهم يرفضون تصديقه، ويستمرُّ هُو بتقديم الأدلّة التي تدينه، وهُم يَخلقون بواسطة ماكينتهم البيروقراطية، كُلّ حجّج الكون لتفنيد أدّلته الدامغة ونَسفِ حقائقه الراسخة!
هل كان هدف دوتوري النهائي إثبات أنّه فوق مستوى الشبهات، بوصفه رجل سُلطة؟ أم أنّه عند نقطةٍ معيّنةٍ أصبحَ ضدّ النظام الذي يَستمدُّ منه سُلطَتَهُ الغاشمة وأراد بفعلته هذه توجيه ضربةٍ ضِدّه.. من داخله؟! وتلك النقطة هي لحظة تحقيقِه مع الطلبة اليساريين والفوضويين الذين تمّ اعتقالهم على إثر أعمال شغب، وبعضهم كان على صلة باحتجاجات مايو 1968 في فرنسا. هل أصابَ المُحقّق مَسٌّ ثوريّ، فأصبح عميلًا للثورة و”الفوضويين”، وأيقنَ أنَّ أفضل أداةٍ لهدم النظام قابعةٌ بين يديه؛ جريمته واعترافه باقترافها وبتلاعبه بالجميع؛ بالقانون والنظام والناس؟ أم لنذهب أبعد من ذلك ونزعم أنّه كان هكذا منذ البداية: مُدمّرًا للنظام من داخله، والمساهمة بتقويض دعائمه ونسف بُنيَتِه كان دافع جريمته؟!
تبدو هذه الفرضيّة أقل حظًا، خاصةً وأنّ هذا المُحقّق على قدرٍ عالٍ من الدناءة لا يسمح له بأنْ يعمل ضد النظام وأن يحاول الإيقاع ببيروقراطييه عبر التضحية بنفسه! لكن لا بدّ من طرحها وعدم استبعادها بشكلٍ كلّي. مع ملاحظة أنّ العمل فيه نَزعةٌ يختلط فيها المنطق بنقيضه والحقيقة الواضحة بالخيال المُشوّش والواقع الكابوسي بالأحلام الكابوسية، وهي بدورها -أيّ هذه النزعة- تدفعُ أكثر نحو عدم استبعاد هذه الفرضية نهائيًا.
لكن المُشكلة أنّ تلك الفرضية حتى لو كانت صحيحة، فَلَم تُحدِث أي فرقٍ في النهاية؛ فالسُلطة أصبحت أشدّ شراسة وحقيقة الجريمة ليست شيئًا مفيدًا بالنسبة لها. والمُهمّ سرديّتُها لهذه الجريمة -أي حقيقتها المفروضة بالقوّة- خاصةً وأنّ ضحيّتها لا قيمة لها ولن يأبَه لرحيلها أحد، كما تقول الضحيّة نفسها لدوتوري في إحدى خيالاته في نهاية الفيلم. وكأنّ إليو بيتري يتلو علينا عبر عمله هذا بيانًا مُناهِضًا للسُلطة لكنّه يائسٌ من جدوى مواجهتها، فيقول لنا لسانُ حالِه، وفي الخلفيّة تؤدّي موسيقى مزاجها عبثي، رقصةً على مسرح انتشاءاتنا السمعيّة، خَلقَ ألحانها الإيطالي الأعظم الراحل إينيو موريكوني: إنّ مسعى اليسار والأناركيّة وكلّ قوّة ثورية وتَحرُّريّة مصيرُه الفشل والخيبة والهزيمة، وإنّ السُلطة وإنْ بدا أنّها تَحمِلُ في طيَّاتِها بُذور هلاكِها؛ فإنّ خوازيقَهَا مُنتَصِبَة وحِبالُ مشانِقِهَا معقودة وأسلحتها مُدجّجة بالذخائر.. دومًا، ورِجالُهَا وُلِدوا ليكونوا فوق الناس، وفوق مستوى الشبهات.

كُتِبَ في 2 حزيران 2020*
-
مقدمة إلى الحرب (۱۹٤۲): بروباچندا عتيقة مُتجدّدة عن الصراع الأزَليّ بين الديمقراطيين الأحرار والمُستبدِّين الأشرار


«الحرب هي ترخيصٌ ممنوح شرعيًا لقتل أناسٍ لا نعرفهم، يتحوّلون فجأةً إلى طرائد يجب تعقّبها والقضاء عليها»
«في الدول الديمقراطية، يجب على الحرب أن تكون ديمقراطية»
صنع العدوّ أو كيف تقتلُ بضميرٍ مُرتاح – بيار كونيسا
عالمٌ حرٌ ديمقراطي وآخرٌ مستبدٌّ وسكّانه مستعبدون ومُذلّون. الأوّل تمثّله كرةٌ أرضيةٌ ناصعةُ البياض، والثاني: الكرة الأرضية ذاتها، لكنّ لونها شديد السواد ومنغمِسَةٌ في الظلام! هذه هي الرؤية الأميركية للعالم باختصار أو الرؤية المُعلَن عنها، من باب الدِقّة. وليس الحديث هُنا عن رؤية الرئيس الأميركي الأسبَق جورج دبليو بوش، رائد محوريّ الخير والشر، والتي كانت قريبةً في الشبه من رؤية ألدِّ أعدائِه أسامة بن لادن، رائد تقسيم العالم إلى فُسطاطين لا ثالث لهما: الإيمان والكفر. وإنْ كانت هذه الرؤية التي ذُكرت في البدء، ونحنُ بصددِ الحديث عنها أكثر، لا تختلف كثيرًا عن رؤى بن لادن وبوش الابن.. لكنّها أقدمُ منها بكثير!

لماذا نُقاتِل؟
هذه الرؤية، والتي من البَدَهيّ القول أنّها اختزاليَة أو تسطيحية؛ إذ تَردُ كل مآزق البشرية وكافة ويلات الأرض إلى صراعٍ أزليٍ بين “الاستبداد” و”الديمقراطية”، يُقدّمها الفيلم الدعائي الحربي الأميركي “مقدّمة إلى الحرب” والذي هو فاتحةُ سلسةٍ مكوّنةٍ من سبعِ أفلامٍ دعائيةٍ حملت عنوان “لماذا نُقاتِل”، وكانت موجّهةً إلى الجنود الأميركيين وفيما بعد استهدفت عامة الناس لإقناعهم بضرورة القتال في حرب العالم الحرّ ممثلًا بمحور الحلفاء، ضد العالم المستبدّ الغارق في ظلام العبودية ممثلًا بدول المحور وعلى رأسها الأشرار الثلاثة: ألمانيا النازية وإيطالية الفاشية والإمبراطورية اليابانية. وقد أخرج السلسلة صانع الأفلام الأميركي من أصلٍ إيطالي فرانك كابرا، وقامت بإعدادها إدارة الحرب الأميركية.
اختزالٌ ممنهج.. أو العودة الدائمة إلى البروباچندا الأولى
لكنّ هذه الرؤية الاختزالية ليس سطحيةً أو جاهلةً أبدًا؛ فصنّاع البروباچندا الأميركية لم يكن ينقصهم لا العلم أو الاطّلاع ولا الأدوات المعرفية المُحدّثة أولًا بأوّل ولا التقنية المتطوّرة، ولم يكونوا في النهايةِ حفنةً من السُذّج الخائفين على الإنسانية من شرور الاستبداد. بل هي نتيجة تسطيحٍ واختزالٍ مُمنهجٍ، يُستخدم في الدعاية منذ أن كانت تتّخذ أشكالًا بدائيةً، مثل هجاء العدو في النصوص الدينية ونعته بأقذع الصفات وتحميله مسؤولية كلّ فسادٍ على وجه الأرض، وردّ كل صراعٍ دُنيويٍ إلى صراعٍ أُخروي، صراعٌ مُبسّط، لا يصعب حتى على أصحاب أدنى نسبة ذكاءٍ فهمه: صراعٌ بين قوتين “الخير والشر، أو “الظلام والنور”.. أو في التعبير الديني الصريح: بين الإله الرحيم والشيطان الرجيم، وفي سياق الحرب العالمية الثانية: بين “رحمن الديمقراطية” و”شيطان الاستبداد”.
فكرة بسيطة هي كل ما تحتاجه لتبرير الحرب
كان لِزامًا على الأميركيين، أن يلجأوا لفكرةٍ بسيطةٍ لتبرير الحرب والاحتفاء بها ولقتل العدوّ دون الشعور بأي وخزِ ضمير: العدو شرير، شيطان! إنه مُستبدٌ، مجرمُ دموي، مصابٌ بجنون العظمة. وهو يكره الديمقراطية والتي هي نمط عيشنا وهُويّتنا، ويمقت الأحرار الذي لا يحصرهم الفيلم في حدود الغرب كما هو متوقّع، بل يذكر أنّ منهم النبي محمّد وموسى والمسيح وكونفوشيوس! إذًا هي حرب الإنسانية جمعاء ضد “استبداد الثالوث الشمولي” ومعركة حياتها أو موتها، حربُ نهاية الكون للحيلولة دون أن يُنهي الأشرار بغطرستهم وفسادهم واستبدادهم هذا الكون.

دغدغة العواطف الدينية تكنيك دعائي فعّال دومًا
وكأيّ عملٍ دعائي، يُدغدغ “مقدّمة إلى الحرب” عواطف جمهوره المستهدف، ويلعب بأصابعه الغليظة على الوتر الديني
الحسّاس، فأدولف هتلر يشنّ حربًا على الربّ وينصّب نفسه مكانه حين يزيل الصُلبان عن الكنائس ويضع مكانها رايات الصليب المعقوف. ويستفزّ المشاعر الدينية حين يقول إنّ النازية تخيّر كل ألماني بين الربّ والفوهرر، وكذلك يفعل الامبراطور الياباني الذي نصّب نفسه إلهًا ويعبده الشعب الياباني، ويستنكر الفيلم هذا “الحكم الطاغوتي”!
واللعب هذه الأوتار الدينية الحسّاسة لن ينتهي تفضيلها بالنسبة لصانع الدعاية الحربيّة الأميركية مع تقادم الزمن أبدًا؛ حيث سيستعملها فيما بعد مع السوڤيتي الذي سيصبح عدوًا غاشمًا، شموليًا مستبدًا ومُهدّدًا للديمقراطية ولطريقة العيش الأميركية الفريدة. وسيلجأ إليها مع أعداءٍ آخرين يَحترفون أيضًا اللعب على هذه الأوتار ويبرعون في دغدغة العواطف الدينية للجماهير على نحوٍ مُميت!أعداؤنا وحدهم يقترفون الشرور
حتى لو كان العدوّ شيطانًا فعلًا، فإنّ الدعاية ضدّه تستوجَبُ شيطنته أكثر وإضفاء بعدٍ ميتافيزيقي عليه، يجعله خارج التاريخ والزمان، لتصبح أفعاله منفصلةً عن أصلها البشري، فيبدو أقرب إلى شيطانٍ أو مخلوقٍ شريرٍ جاء من بُعدٍ آخر، يفعل كل ما هو قذر ومكروه، لأنّه ليس مثلنا، لأنّ تلك طبيعته. فالاشتراكيون الوطنيون والفاشيون واليابانيون، يرتكبون فظائع لا يفعلها أحد غيرهم؛ يُنكّلون بمعارضيهم، يعذّبونهم ويغتالونهم، ويرسلون ملائكة الموت الخاصة بهم إلى كل بقاع الأرض، ويستعبدون شعوبهم، ويحرمون الأطفال من طفولتهم، فيأخذونهم عنوةً إلى ساحات الحرب، أو يُزيّفون وعيهم في المدارس ويُجبرونهم على الهتاف بحياة القائد المفدّى.. وهذه كما يعلم الجميع وبالطبع وبلا شك، ممارساتٌ لا تحدث إلّا داخل حدود هذا الثالوث الشيطاني!
أما دول العالم الحرّ، الأمس واليوم، فلا تقترف هذه الشرور أبدًا، ولا توجد دولٌ حليفةٌ للولايات المتحدة في “الشرق الأوسط” فعلت وتفعل ما كان يفعله النازيون لكن على نحوٍ ناعمٍ وباستخدام تقنياتٍ حديثة وحتى بمساعدة نازيين سابقين! ومع ذلك تعتبر صانعةً للسلام وجالبةً للعدالة وإحدى أعمدة العالم الحر. ولا مكان لدولٍ كهذه في هذا العالم، الذي لا تهمّه أي مصالح ضيّقة، والإنسان دومًا أولويّته، والديمقراطية منهاجه، ودومًا يقف ضد الُمستبدّين والطغاة طالما أنّهم من المعسكر الآخر.

بروباچندا ضد بروباچندا.. أو النصر المظفّر للجماليات النازية
يستعير فرانك كابرا مقاطع من فيلم بروباچندا آخر، أقدم بسبع سنوات، من إنتاج أحد أضلاع مثلّث الشر “النازيون”، وهو الفيلم الوثائقي “انتصار الإرادة”، الذي أخرجته صانعة الأفلام المؤيّدة للنازية ليني ريفنستال. وتبدو هذه الإحالة لـ”انتصار الإرادة”، وكأنّها تقول: “إنّنا ننفاسكم بقوّة في صناعة البروباچندا الحربيّة!”. لكن هل كانت منافسة قويّةً فعلًا؟
إنْ كان لا بد من عقدِ مقارنةٍ سريعة، فإنّ “انتصار الإرادة” يفوز بقوّةٍ في هذه المنافسة، ويتنزع نصره في الحرب الدعائية بسلاسة. لا لأن غايته النهائية كانت أنبل أو أسمى بالطبع، بل لأن فيه عناصر فنيّة وجمالية غابت عن “مقدّمة إلى الحرب”، الذي بدا مباشرًا على نحوٍ مُضجِر وتقنيًا لأبعد حدّ وخاليًا من أيّ بعدٍ جمالي، ومبتذلًا في تقديمه لرسالته المختصرة في “عالم حر ديمقراطي ضد عالم مستبد شرير” والتي تكاد تتكرّر في كل دقيقةٍ من الفيلم. هذا البعد الجمالي -إن جاز هذا التعبير- يتمظهر في المسيرات العسكرية المهندَسَةِ على نحوٍ بديع، وفي تناسق الأعلام النازية لتشكّل لوحةً فنيةً تنجحُ في لفت الأبصار إليها، وفي صرامة وانضباط كبار قيادي الرايخ الثالث وبلاغة خطاباتهم واستعراضية الفوهرر التي حوّلها سحر ريفنستال في الخلق والإبداع، إلى جاذبيةٍ من الصعب على الجماهير الباحثة عن قائدٍ مُخلّص -ووجدته أخيرًا- أن تقول لها: لا.


وهذا البُعد الجمالي لم يكن محصورًا في صناعة الدعاية الألمانية، بل كان حاضرًا تقريبًا في كل مناحي الحياة الألمانية، في الصناعة والموسيقى والفلسفة والفكر.. وفي القتل والإبادة كذلك! وما كانت تقترفه النازية من جرائم على نحوٍ فنيٍ وجمالي -وذلك لا يُغيّر شيئًا من حقيقة أنّها جرائم- ربّما تعبّر عنه إحدى شخصيات فيلم “الحبل” (١٩٤٨) لألفريد هيتشكوك، حيث تقول شخصية الشاب براندون: “القتل يُعدُّ فنًا؛ فالمقدرة على القتل قد تكون مشبعةً تمامًا كالمقدرة على الخلق والإبداع!”. وربما هذه حقيقةٌ من الصعب إنكارها، أنّ النظام النازي نجح في صناعة خليطٍ من الإبادة والإرهاب، وتقديمه إلى العالم بقالبٍ أنيقٍ وجذّاب.٨٠ عامًا ولم يتغيّر الكثير
على مدار ٥٢ دقيقة تقريبًا، لا يملّ “مقدمة إلى الحرب” من عقد المقارنات بين العالم الحر والعالم المستبدّ، ولا يكفّ عن امتداح ديمقراطية الأوّل والحزنّ على سكان الثاني، لأنّ هذه الحبّة السحرية المسماة “ديمقراطية” غير متوفّرة في بلادهم. ويصرُّ على استبعاد أيّ أبعادٍ أخرى للصراع، ويحصرها أو يحشرها في ثنائية “الحرية – الاستبداد”، ويبدو هذا مفهومًا تمامًا في سياق عملٍ دعائيٍ تعبويٍ موجهٍ للجنود وثم لعامة الناس في ذلك الزمان. لكنّ الأمر أكبر من ذلك وأعقد، هو نهجٌ قديمٌ متّبعٌ في إبراز بعدٍ واحدٍ لأيّ صراع، وإخفاء أبعاده الأخرى الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية والعسكرية، لإقناع الناس بأنّ الأمر في غاية البساطة، وليس للسيطرة ورأس المال علاقةٌ أبدًا به، وبأنّ على جميع الديمقراطيين الأحرار في كل بقاع الأرض أن يهبّوا هبّة رجلٍ واحدٍ لقتال المستبدّين الأوغاد.

وقد تكرّر هذا الخطاب بعد ٦٠ سنةً من صدور هذا العمل، أي عام ٢٠٠٢، لتبرير غزو أفغانستان، ومن بعدها العراق.. وما زال يستخدم مع تعديلاتٍ بسيطة وتحديثاتٍ طفيفة كلّما علم حرّاس الحريّة وشرطة الديمقراطية وحلفاؤهم (الذين لا يكتفون اليوم بالقيام ببضعة مهامٍ صغيرة هنا أو هناك بل يقومون بدوره كاملًا ويتركونه ليستريح على عرش العالم) أنّ هناك مستبدًا في بلدٍ ما في “الشرق الأوسط” وما حوله، يمكن تحقيق مكاسب من شنّ حربٍ عليه أو إشعال فتيل حربٍ أهلية في بلده، سواء سقطَ هذا “المُستبدّ” أو بقي مكانه وصار أقوى.. فذلك غير مهم، المهم انتصاراتنا من أجل الحرية التي تعرضها وسائل الإعلام، ومكاسبنا على أرض الواقع التي لا يعلمها إلّا الراسخون في فنّ الحرب ومهندسو البروباچندا.
٨٠ عامًا مضت على صدور الفيلم، العالم تغيّر كثيرًا وهو اليوم في طريقه لولوج مرحلةٍ تغييرٍ أشدّ تعقيدًا وشموليةً ورعبًا، لكن يبدو أن القليل من التغيير طرأ على خطاب البروباچندا المتمحور حول محاور الخير والشر والديمقراطية والاستبداد، أو ربّما ليس ثمّة داعٍ لإحداث تغييراتٍ كثيرة أو كبيرة، ما دامت الحجج والذرائع نفسها تنجح في تحقيق الهدف كلّ مرّة.

*كُتِب في 28 أيلول 2020
-
المنارة: عن عواقِب المعرفة بلا حدود


«هناك الكثير ممّا لا أريد نهائيًا وقطعًا أن أعرفه.. إنَّ الحكمة تضعُ حدودًا للمعرفة أيضًا».
فريدريك نيتشه – غسق الأوثانتُذكّر مُطارَدة توماس وايك (ويليم دافو) لتوماس هوارد (روبرت باتنسون) بالفأس، في فيلم المنارة (2019)، بمُطارَدة جاك تورانس لعائلته في بريق ستانلي كوبريك. وليس هذا المشهد الشيء الوحيد الذي يُحيلنا إلى “البريق”، كذلك الرؤى والكوابيس التي تُطارد هوارد، والأهم الإقامة في مكانٍ يُهيمن عليه الغموض ويستعمره رعب مجهول، أو تسكنه لعنةٌ أصابت مقيمًا سابقًا، والتحوّل التصاعُدي في شخصيتي الفيلم الوحيدتين صوب الجنون.
وتُحيلنا نوراس منارة الأميركي ذي السابعة والثلاثين عامًا، روبرت إيغرز، إلى طيور الإنكليزي ألفريد هيتشكوك؛ ففي العملين ثمّة رعبٌ ما ورائي، حيث تتصرّف الطيور والنوارس على نحوٍ لا يمكن فهمه بالعقل أو تفسيره بالعلم -في “الطيور” تُحاول إحدى العالمات تفسير الظاهرة بأدوات العلم وتفشَل!- ممّا يُعطي إحساسًا بأنّ هذه المخلوقات الطائِرة تتخبّطها الشياطين من المسّ أو تتلبّسُها أرواحٌ شريرة أو هي نتاجٌ لمؤامرةٍ مُعقَّدةٍ يستحيلُ فهمها بأدوات العلم والمعرفة، لأن مصدرها خارجي/غير بشري.

البدء في الإحالة لهذين الفيلمين كان لا بد منه، للتأكيد على غموض “المنارة”، وبالتالي استحالة الخروج بتحليلٍ واحد أو حقيقةٍ واحدة، وأفترض أن أي عملٍ سينمائي أو فنيٍ وإبداعيٍ بشكلٍ عام يقدّم حقيقةً بكل وضوح، هو عملٌ قاصرٌ، مُناسِبٌ لمُخاطَبة أي حيوان، إلا ذاك الناطِق! إذاً في هذا العمل ليس هناك حقائق، فقط تأويلات -كما يقول نيتشه-.
يقوم العمل على الصراع بين قوّتين، ممثّلتين في شخصيتي حارِسَي المنارة، وربما لذلك جاء مصورًا بالأسود والأبيض، للتأكيد على ثيمة الصراع والتضاد بين قوّتين. في البدء يبدو مجرّد صراعٍ بين الحارس المُشرِف (مدير العمل) والحارس (العامل)، الأوّل يُمثّل الجيل القديم؛ العجوز المُتحَاذِق، والثاني يُمثّل الشاب القوي النابض بالحيويّة والقوّة البدنيّة، المُستعبَد من قبل من هو أعلى منه. قد تعتقد أنّه “صراع طبقي” بين عاملٍ مُستَغَلٍ ومُستَلَب، وبين رئيس العمل المُستَبِد، أو بين نمطي حياة متنافرين لا يمكن أن يلتقيا، أو ببساطة بين جيلين. لكن الأجواء الغامضة والأحداث التي تأخذ منحى ما ورائي، تقطع الطريق أمام أي محاولةٍ لتأويل الصراع على هذا النحو المادي/الواقعي.
ومع انغماس “توماس وتوماس” في شرب الكحول والرقص والتحاور والتجادل والاقتتال وانزلاقهما إلى الجنون، بالتزامن مع إسقاط كافة أشكال الرسمية والهرمية في العلاقة بينهما -حتى أنّها أوشكت على أخذ شكلٍ عاطفي/جنسي!- يبدو الأمر أقرب إلى صراعٍ بين رجلٍ كبيرٍ وحكيمٍ يعرف كل شيء/أو الكثير، لكنّه لا يقول كل شيء، وبين شابٍ يملك قوةّ وعافية الشباب، لكنّه لا يعرف شيئًا، ليس حكيمًا ولا ذكيًا -لكنه يخالُ نفسه كذلك- ويريد معرفة -والظفر- بكل شيء.. المال، والنساء والسلطة، والمنارة بما تمثّله من قوةٍ غير محدودة لا يدرك عواقبها لأنّ محدوديّته تمنعه من ذلك؛ يريد أن ينخرط فيما هو أكبر منه، دون أن يعرِف قدْرَهُ وحجمه الحقيقي، يريد سبر أغوار الحقيقة دون أن يسأل نفسه: هل بإمكاني حقًا إطاقة الحقيقة؟

هذا الصراع لا يقف عند حدود الاختلاف بين رجلٍ حكيم وآخرٍ أرعن. ويمكن الذهاب بعيدًا جدًا والزعم أنه بين قوّتين كونيتين، وعند هذه النقطة يبدو من المنطقي القول إنّه يُحيلنا إلى قصة شجرة معرفة الخير والشرّ وهبوط آدم من الجنّة في سفر التكوين في العهد القديم، وإلى نسختها الإسلامية في القرآن، لكن من دون وجود أحد أبطال الحكاية الرئيسيين وأهمّ مُحرّكٍ للحدث فيها.. “الشيطان”، أو ربما كان موجودًا فعلًا، مُحرّكًا لكل شيء، ذلك “المتمرّد الأبدي وأوّل مفكّرٍ حُر ومُحرِّر العوالم” -كما وصفه بحماس، الأناركي الروسي ميخائيل باكونين في “الله والدولة”– لكن بشكلٍ خفي، مُوسوِسًا لتوماس هوارد (الإنسان)، ومُحرِّضًا إياه على التمرّد على توماس وايك والكشف عن أسرار المنارة وتحرير ذلك العالم الذي يسيطر عليه ذلك العجوز المُتَعجرِف، مُدّعي الحكمة وصاحب القصص الغريبة.. أو ببساطة (الإله).
لكنه صِراعٌ أكبر وأعقد من أن يُقال إنه سردٌ بأسلوبٍ رمزي للقصة التوراتية/القرآنية، ولسنا أمام تجسيدٍ سينمائي لرواية الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ “أولاد حارتنا”، وإن كان هناك تشابهٌ كبيرٌ بين العملين، خاصةً في شخصية “عرفة” ومحاولته كشف سر وصيّة وقْف “الجبلاوي” ومحاولة توماس هوارد كشف سرّ المنارة وفشل كليهما. لكن “منارة إيغرز” لا تشارك “حارة محفوظ” تفاؤلها واحتفاءها بـ”عَرَفة” بما يرمز إليه من علمٍ ومعرفة!

هكذا أتخيَّلُ جبلاوي.. إنّه فعلًا أفضل تجسيدٍ له! منارة إيغرز، أشبهُ ببيانٍ ضدّ المعرفة أو ضد المبالغة في الاحتفاء بها وإجلالها وصناعة دينٍ جديدٍ منها، وهذا البيان يُحذِّرُ من العواقب غير الحميدة للامحدوديتها، موافقًا نيتشه أنّ هناك حدودًا للمعرفة تضعها الحكمة، حدودٌ ضرورية تفرضها حدود العقل البشري، ولأنّ معرفة -وإخبار- الحقيقة ليست دائمًا عملًا ثوريًا أو مفيدًا أو نافعًا للفرد وللناس. والحقيقة -بوصفها المعرفة الكاملة- لن تجعل الإنسان حُرًا -كما قال يسوع مُخاطبًا اليهود في إنجيل يوحنا- بل قد تزيد من بؤسه وتعاسته أو قد تقتله ببساطة.
سألجأ مرةً أخيرةً إلى الإحالة لفيلم، لما فيه من تشابهٍ مع نهاية المنارة؛ وهو الفيلم الأسود* “قبَّلني بإفراط” الذي أخرجه الأميركي روبرت ألدريتش عام 1955، حيث يدور في ختامه حوارٌ بين الفتاة المُحتالة (غابرييل) وزعيمها (د.سوبرين) حولَ صندوقٍ غامض، تصرُ غابرييل على أن تعرف محتواه وتراه، لكنَّ زعيمها يرفض إلحاحها، ويحذّرُها من مغبَّة محاولة فتحه:
-أخبِرني ما الذي في الصندوق؟
*يجب أن نسمّيكِ باندورا، فقد انتابها الفضول حول صندوق وفتحته… فأطلقت كل الشر في الأرض!
-أريد أن أعرف ما هو وحسب؟
*هل ستصدقينني إن أخبرتكِ؟ هل سترضين؟.. رأسُ ميدوسا، هذا ما يحتويه الصندوق، لكن من ينظر إليه لا يتحول لحجارة، بل إلى كبريتٍ ورماد! لكن طبعًا لن تصدقينني، تريدين أن تري بنفسك!
لا تأخذ غابرييل كلامه على محمَل الجد، فتقتلُه، طمعًا في ما تظن أنها ثروة يحتويها الصندوق. وأثناء لفظه أنفاسه الأخيرة، ينهاها عن فتحِه .. لكنَّها تتجاهل تحذيره تحتَ وطأة شهوة المعرفة، واعتقادها الساذج بقدرتها على تحمُّل مواجهة المجهول، فتفتحه بالكامل، لتخرج منه مادة مُشعَّة فتحرِقُها وتُسبِّبُ انفجارًا ضخمًا في المنزل الذي كانت فيه.

ليس ثمّة فرقٌ كبير بين عقبات فتح غابرييل للصندوق وعقبات استكشاف توماس هوارد لما يوجد في المنارة، كلاهما حاول معرفة ما لا يجب معرفته وما لا يقدران على إدراكه لمحدوديتهما (أو محدودية العقل البشري)، كلاهما لم يُدركا أن المعرفة لها حدود، وتجاوزها والتعدّي عليها والنفاذ إلى عالمٍ لا يمكن لطبيعتهما تحمّله، يُلقي بالمرء إلى التهلكة؛ فالمعرفة ليست دائمًا قوّة، ربما تكون جنونًا أو فناءً.
لكن الحدود في الفيلم، محصورةٌ في المعرفة فقط؛ فلا حدود لإبداع إيغرز، وهو يعيد إنتاج ما يشبه إحدى الأساطير القديمة في قالبٍ سينمائي مليءٍ باللذّة البصرية والرعب غير التقليدي؛ ذلك النوع من الرعب الشهي الذي يُمتّعنا ونطلب المزيد منه طالما أنّه يصيب غيرنا، ونشعر/أو نتوهّم في حضرته، أننا نتحكّم بأبطال العمل ونتنبّأ بمصائرهم ونكاد أن نُحذّرهم مما ينتظرهم في النهاية؛ فنحن نعرف كيف ستنتهي الأمور إلى حدٍ كبير، لكن الأهم.. بأي طريقةٍ فظيعةٍ سيحدث ذلك؟ وماذا سيقع قبله؟ وكيف سيكون شكل الطريق المفضي إلى النهاية؟
ٌولا حدود لخيال توماس هوارد (كالخيال البشري الذي يذهب بعيدًا جدًا إلى أقصى المناطق، متجاوزًا أيّة حدود يمكن أن تفرضها سلطة بالقوةّ المادية والمعنوية. لكنّ المفارقة أنّ هذا الخيال في كثيرٍ من الأحيان يخلق وثنًا جديدًا ويفرض بموجبه سلطًةً أشدّ طغيانًا تستعبد البشر وفي حالاتٍ متطرفة ومجنونة تقتلهم!). وليست هناك حدودٌ للجنون الذي تفرضه إقامة شخصين متناقضين في مكانٍ يحرسه الغموض ويسكنه الرعب والهلاوس، أو للكوابيس التي تُحفّزها قوةً ما خفيّة تسعى لخلق كابوسٍ واقعي وتنجح في ذلك، أو للحوارات التي تتّقِد نارها بزجاجات وبراميل الكحول التي تُشرَب بلا حدود، والتي -وللمفارقة- كانت تُؤخِّر قذف البطلين إلى الجنون والهلاك.. أو ربما عجّلت به!

*هامش:
هنا تجدر الإشارة إلى التأثّر الواضح بالفيلم الأسود، من حيث تضمّن “المنارة” عناصر رئيسية من عالمه؛ منها المرأة الفاتنة/اللعوب Femme fatale (حورية البحر في هذا الفيلم)، وإن كان حضورها معنويًا أو روحانيًا، لكن ذلك لا ينفي أنّها بظهورها في خيالات وهلاوس توماس هوارد تلاعبت به وأغوته ليمضي قدمًا في مسعاه الخائب ومخططه الفاشل لاكتشاف سرّ المنارة.. ولقاء حتفِه!

-
أفراح الإنسان بمؤخّرة أخيه الإنسان


انتشيتُ من جُرعة سعادةٍ زائدة، كادت روحي أن تَغرَق بفائض هرمونها، حين هَبَط عليَّ وَحيُ هذه الفكرة: سأنفذ بجلدي وأحقّق خلاصي الفردي! لكن كل ما هو جميل في هذا الوجود حتى لو كان حُلمًا بسيطًا أو أملًا سخيفًا لا يكتمل، كما هو مقدَّر -وهذه سُنّة الحياة التي لا أدري من كان صاحب فكرة سَنِّهَا ولا فكرة عندي عن السَنَة التي سُنَّت فيها لأوّل مرّة؟!- إذْ هَبَطَت على وجهي النحيل كُتلة لحمٍ بشريٍ ضخمة أطبقَت على أنفاسي، فأدركتُ أنّي قد مِتُّ وجلدي تمّ سَلخُه واستعمالُه لكسوِ مَقعَدٍ خاصٍ بأحد الإخوة الكبار والسادة الأخيار في مدينةٍ مشهورة بين أُمَم الأرض بإتقان فنون اغتِصاب الأحلام الصغيرة والمتوسّطة وممارسة رياضة تدمير ما يُعمِّرُه الناس من مبانٍ لآمالٍ تافهة.
وقبل أن أَسقُطَ في فِخَاخ الإحباط ويأتي اليأس ليفترسني، بعد تجرُّع حقيقة أنّي لنْ أنفذ بجلدي الذي تم سَلخُه ولن يكونَ هُنالك خلاص -فقد تمّ الخلاص مِنّي كما هو واضحٌ وملموسٌ ومحسوس- وجدتُ عزاءً في فكرةٍ أُخرى، فحدّثتُ نفسي.. ومن لي الآن غير نفسي:
يا رَجُل.. انظر للموضوع من زاوية أخرى مُتفائلة وفكّر خارج الصندوق؛ على الأقل أنتَ من الصنف الفاخر وحظّك سعيد ومكانُك فريد؛ فقد أصبحَ جِلدُك مقعدًا لأخٍ كبير وسيّدٍ صاحب خيرٍ كثير، تطأُه أردافٌ منجزةٌ وأفخاذٌ مُنتجةٌ تُحبُّ المُنافَسَة وتَعشَقُ المُزاحَمَة وتَعتَليه مُؤخّرةٌ سمينةٌ مكوّنةٌ من طبقات لحمٍ بَشريٍ بَلديٍ -وأحيانًا مُستورَد- مختلفٌ ألوانه، تعود ملكيَّتُها لأحد أفراد طبقة السادة المُنعَم عليهم لا العبيد المغضوب عليهم كما كُنتَ من قبل. وقد يُحالِفُك الحظّ أكثر ويُصبِحَ شأنُكَ أكبر.. فيُمارِس صاحب هذه المؤخّرة الحُبّ مع مؤخّرةٍ أُخرى عريضة -مع إكسسواراتها- على سَطحِكَ! فكُن شاكرًا لهذا التكريم وافرَح بذلك الامتياز واقرأ عليه سورة الفلق.. فحتمًا سَتَحسِدُك عليه جُلود المَقاعِد الأخرى.
- كُتِبَ في 16 آب 2020.
-
بَصْقَة
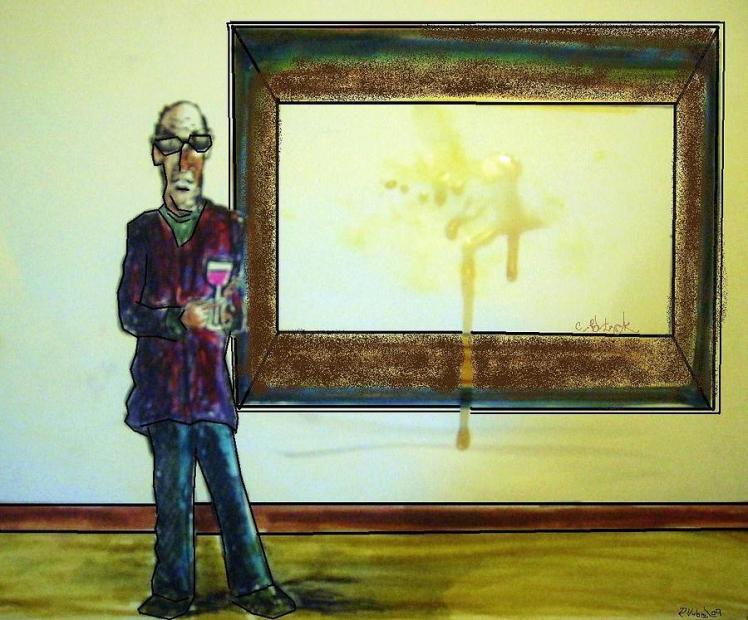

كان راضي السترة مُواطنًا صالحًا، مُلتزمًا بالأنظمة ومُطيعًا للقوانين، مُحِبًّا لوطنِه: بلاد السَفَرجَل. ويروي كثيرون مِمّن عاصروه أنّه اعتادَ ممارسة رياضة المشي بجانب الحائط وقول: يا رب السترة. وتَزعُم إحدى المرويّات حول أصل اسم عائلته، أنّ جدّه الذي كان يُلقّب بـ”الحيط” -لأنّ طوله كان يقارب المترين ونصف- غيّر اسم العائلة من “النمرود” إلى السترة، بعد أن نَزَحَ من حَيِّه الذي نشأ وترعرع فيه، إثر سيطرة العصابات المسلّحة عليه وعدم قيامه بأيّ رد فعل ورفعه الراية البيضاء منذ أوّل “كَفّ” تلقّاه، بعد أن ألقى على مَسامِع أبناء حيّه عشرات الخُطَب المُشتعِلةُ بأدرينالين الحماس الثوري والمحقونة بمُنشِّطات الشغف النِضالي، والتي تتوعّد العدوّ بالويل والثُّبور وتتعهّد بإخراجه من الديار مذءُومًا مدحورًا.
حياة راضي لم تكن مثيرةً أبدًا، بل كانت على النقيض تمامًا: تختنقُ غرقًا في الرتابة، حتّى أنّ وصف “عادية” يُضفي عليها رشَّةً من بهارات الإثارة. حياةٌ مُضجِرةٌ حَدّ الموت، لا يَحدُث فيها شيء ولا عائلة فيها ولا صديق ولا حبيبة إلّا الفراغ. ولم يكُن مُهتمًا بأي شؤونٍ خارجية أو داخلية -ربما فقط نظافة ملابسه الداخلية- ولم يُعرف عنه تدخين السجائر أو شرب الخمر أو السَّهَر والسَّمَر. وقد اعتاد على النوم عند التاسعة ليستيقظ باكرًا ويتواجد على رأس عمله في تمام السابعة ليُثبت لمُدَرائه أنّه عاشقٌ للإنجار ومُدرٌّ للأرباح ومُلتَزمٌ بدَحرَجَة عجلة الإنتاج، كما كان سيزيف مُلتَزِمًا بِدَحرَجَة صخرته. باختصار: كانت حياةً تَليقُ بشخصٍ يَسير بجانب الحائط ويبتغي السترة!
أَحبَّ راضي عمله المُمِلّ كمُحرِّرٍ ومُدقّقٍ لُغوي وكان يَجِدُ فيه متعةً ولذّة؛ فينتشي عند حذف أو إضافة همزة قطع ويبلغ ذُروةً -لم يختبر بلوغها يومًا- عند حذف حرف العلّة من فعل الأمر مُعتلّ الآخر، ويَشعُر بنصرٍ مظفّرٍ على عدوٍّ وهمي حين يتصيَّد خطأً لُغويًا أو “خطيئة لُغوية” اقترفها أحد زملائه الكُتّاب “خونة اللغة” كما يُسمِّيهم. راضي لم يَقتَرِف أيّ خطأ لُغوي في حياته، ومع ذلك اعتاد على قراءة اسم الصحيفة التي يعمل بها “الحقيقة المُطْلَقة” (الصحيفة الرسمية لبلاد السفرجل)، بطريقةٍ خاطئة، فيقرؤها “الحقيقة المُطَلَّقَة”؛ فالحقيقة من منظوره تُطلَّق دائمًا، يُطلِّقُها البشر قبل لحظة الدخول بها وهُم على بُعدِ بضعة سنتيمترات منها! لكنّ حَماسَهُ لتصحيح “خطايا المُحرِّرين”، لن يَمنعه من ارتكاب خطأ تحريري سيقلب حياته رأسًا على عَقِب.
صبيحة يومٍ مُضجرٍ كسائر أيامه، استيقظ راضي على لكمات وصفعات وركلات ثلاثة رجالٍ لم يرى منهم إلا اللون الأسود القاتم: لون ملابسهم ونظّاراتهم الشمسية وشواربهم الكثّة وكمّاشات وعِصِي كهربائية كانوا يضعونها على خُصورهم. أحدهم بعد أن سدّد عدّة ركلاتٍ من زوايا مختلفة إلى مرمى خصيتي راضي، صاح بوجهِه:
من الذي دفع لك أيّها الفَوضويّ المُندّس؟ اِعتَرِف يا حيوان يا خوّان يا عدو الأوطان، تعالَ معنا لنُلقّنك درسًا في الوطنيّة يا قوّاد….
راضي وبدلَ أن يقول خيرًا أو يَصمُت، حاول الدفاع عن نفسه وقد أضحى في وضعيّة خروفٍ مصيره الذبح صباح أول أيام عيد الأضحى، فخاطبهم بصوتٍ تغلبه الحشرجة:
لكن.. أنا.. لستُ قوادًا، أنا مُدقّق، كاتب، مُحرِّر وأُحبُّ….
وقبل أن يُكمِل، قُذِفَت لكمةٌ بقوة كرةٍ حديدية ضخمة إلى وجهه فكسرَت أنفه.
وبينما هو مُلقىً على الأرض ووجهه مُرنّخٌ بالدم، رأى راضي بصعوبةٍ رجلًا بدا نحيلًا جدًا، يَرتدي ثيابًا لونها مزيجٌ من الأصفر والأزرق والأخضر والبنفسجي وألوان أخرى لم يتمكّن من ملاحظتها كلّها. خاطِبُه هذا الرجل بصوتٍ منخفضٍ ونبرةٍ هادئة:
يُمكنك القول إنّنا زملاء؛ فنحن كتابٌ أيضًا: جئنا لنكتب الفصل الأخير في مسرحية حياتك. كذلك نحن مُدقّقون: جئنا لندقّق في حُبّك لهَذي البلاد ونُراجِع وطنيّتك أيُّها المُحرِّر!
ليَفقِدَ راضي بعد ذلك وعيه.
استيقظ راضي فوجَدَ نفسه محشورًا في قفص الاتهام داخل محكمة بلاده الرسمية، التي يُطلَق عليها “محكمة العدالة القُصوى لإعدام المجرمين الحاقدين على البلاد والحاسدين للعباد على ما في تاريخهم من أمجاد”، وأوّل ما رآه: ثياب الإعدام البُرتقالية التي كَسَت بَدَنَه! المحكمة غَصَّت بالحضور وكأنّهم جاؤُوا ليُشاهدوا وصلة رقصٍ شرقي أو مهرجانًا لمُغنٍّ شعبي. أنظارهم كلّها توجّهت صوب المتّهم باحتقارٍ وقرف، أمّا هو فلم يعرف حتّى اللحظة ما هي التهمة المُوجّهة
إليه. أخذ راضي يصرُخ دون تفكير:لماذا أنا هُنا؟! أنا مواطنٌ صالح، أنا كاتب شريف، أنا مُحرِّر.. أخرجوني من هنا أرجوكم! أنا بريء.. لستُ أنا الفاعل، ماذا فعلتُ أنا؟!
لكنّ صوتًا جاء من حيث يَجلِسُ القاضي، نهى راضي عن الكلام. أمعن الأخير النظر، فإذا بالقاضي هو نفسه الرجل النحيل جدًا ذو الثياب الملوّنة الذي كان يُرافق الرجال الثلاثة الذين أشبعوه ضربًا. نظرَ القاضي لراضي بوجهٍ عابسٍ متجهِّم مع الاحتفاظ بنفس النبرة الهادئة التي خاطبه بها ساعة زيارته الصباحية له، وتوجّه إليه قائلًا:
أنت متّهم يا راضي يا ابن السترة، بتعكير صفو علاقات بلاد السَفَرجَل مع بلد الواحات المُلتَحِمَة الصديق الحبيب.
تَعجّب راضي:
أنا يا سيدي.. كيف؟! أنا أُحبّ تلك البلاد وأحلم بالسفر إليها وأعشق ثقافتها وأحرص على متابعة الأفلام التي تُنتجها وأتمنّى أن أكون أحد أبطالها وأُحبُّ رئيسها الــــــ…
أسكَتَ القاضي راضي:
دَعكَ من الكذب الذي استمرأته بحكم عملك بالصحافة، وإلّا أمرتُ بإعدامك حالًا بدون محاكمةٍ عادلة! لقد أخطأت في تدقيق المادة الصحفية التي تَرثي فقيد البلاد والكون، سعادة سفير بلد الواحات المُلتَحِمَة المأسوف على شبابِه والمنشورة أمس، في صحيفة “الحقيقة المُطْلَقَة”، حيث وَردَ في المادة أنّ سعادة السفير الراحل ترك في بلادنا “بَصْقَة” لن تُزول بدلًا من “بَصْمَة”، وهذه إهانةٌ شديدة لسعادة السفير المرحوم ولكلّ السُفراء.. فهم لا يبصقون أبدًا!
لم يردّ راضي، سَكتَ كالأبله وأخذ بالتفكير سريعًا مع نفسه ودماغه قد استحالت فيلمًا عشوائيًا يُصوّره مخرجٌ بكاميرا مُهتزّة:
الويل لي! لقد انتهى أمري حتمًا. كيف ارتكبتُ هذا الخطأ القاتل؟! أين كنتُ وقتها؟! هل هي زلّة فرويدية لعينة؟! الويل لي.. الكل سيحكي عن مأساتي، عن حرفٍ واحدٍ جعلني محسوبًا على المنشقّين من الفوضويين والعدميين!
اِستغرق راضي بالتفكير، ولم تُرعبه حقيقة أنّه بعد دقائق سيُرسل إلى غُرفة الإعدام، ما كان يُرعبه هي طريقة الإعدام، فهو يريدُ رحيلًا سريعًا، موتًا بدون ألم ومعاناة. “حبّذا لو تكون رصاصة في الرأس أو يجزّون عُنُقي فيتدحرَج وينتهي الأمر بسلامٍ أبدي!”.. حدّث نفسه وهو متحمّسٌ جدًا للموت.
أَمرَ القاضي بإعطاء راضي دقيقة واحدة كاملة للتفكير بما سيقوله للدفاع عن نفسه؛ فوِفقَ قانون بلاد السفرجل، وفي الجرائم التي تُهدّد العلاقات مع الدول الصديقة، يُمنَع وجودُ محامي دفاع عن المتهّم الفوضوي العَدَمي المُجرم. استغلَّ راضي تلك الدقيقة فأجرى عَصفًا ذهنيًا مع نفسه، وعلى نحوٍ مفاجئ، وفي لحظةٍ تُشبّه نزول الوحي، انتَصَبَت قامته وبَدا كشجرةٍ باسقة -فقد كان طويلًا جدًا كجدّه “الحيط”- وظهرت عليه معالم ثقةٍ عالية لا تتناسب مع الموقف الموضوع فيه، وتوجّه للقاضي مخاطبًا إياه بهدوءٍ مع ابتسامة خفيفة:
لن أكذب إطلاقًا يا سيّدي، وسأقول الحقيقة المُطْلَقَة: لم يكن ما فعلته خطأً إملائيًا مُجرِمًا ولم يكن خطيئةً يجب التكفير عنها بإبادتي ولا ذنبًا يستوجب العقاب بالإعدام. أنا يا سيّدي.. كتبت ذلك وفخورٌ به لأبعد مدى، وأكَادُ أجزِمُ أن سعادة السفير الغالي لروحه الغالية الرحمة ولإنجازاته المجيدة طول البقاء، لو كانَ حيًا لفَهِمَ مقصدي وافتخرَ بي وقلّدني وسام شرف أو منحني شهادة فخر وتقدير، لأنّي مَادِحٌ لحضرة جنابه ومُبجّلٌ لمقامِه العالي.
اِندَهَشَ الجميع في المحكمة، أخذوا يتحدّثون فيما بينهم:
لقد حفر قبره بيده!/الخازوق بانتظار هذا الأرعَن/سيُقطّعونه ويرمون لحمه النتِن لتماسيح سعادة السفير/يظُنُّ نفسه ثوريًا هذا الطبل الرومانسي/فوضوي غبي/الله لا يردّه هالحمار!
أطلق القاضي رصاصةً في الهواء ليُسكِتَ الحضور الجماهيري الكبير لهذه المحاكمة، ثمّ أمرَ راضي بإكمال حديثه:
هل هناك يا سيّدي ما هو أعظم من البَصْقَة؟ البَصْقَة خارجةٌ من الأعماق وتحتاج لجُهد وتُسبّب الكثير من التعب لصاحبها! ومن يُعطيك ما هو خارجٌ من أعماقه وبذلَ جهدًا من أجله وتعب فيه، فهو يُحبُّك بالضرورة، ومن يُحبّك وَجبَ عليك تقديره وحتّى عِبادتُه! يا سيدي، أرجو أن تتحمّلني قليلًا.. فقط أريد أن أسأل بكل صدقٍ وبمنتهى العفوية: ما المشكلة حين نقول إن سعادته تَركَ بَصْقَةً في بلادنا؟ نحن في الحقيقة غارقون في هذه البَصْقَة.. نَسبح في بحرها مستمتعين وممتنّين! ولمَ الذهاب بعيدًا، هذه المحكمة ما كانت لتكون وما كُنتُ لأُحاكَم فيها لولا مساعدات بلاد سعادة السفير الراحل عن هذه الدُنيا الزائلة والخالد في قلوبنا. وأيضًا مدارسنا وجامعاتنا ومطاعمنا ومتاجرنا وشركاتنا وإعلاناتنا ومستشفياتنا وسجوننا وخمّاراتنا ونوادينا الليلية ومقابرنا من مساعداتها.. أليست هذه بَصْقَة؟ وإنّها وحقّ تراب هذه البلاد الغالية.. لأعزُّ بَصْقَة؛ كَرَمٌ حقيقيٌ خارجٌ بصدقٍ من أعماق قلبٍ مُحبٍّ دون تنازلات، إنّ هذه البَصْقَة تحمل في باطنها أسمى أشكال الحبّ اللامشروط، وإنّي لأرجو أن لا يَحرِمنا السفراء القادمون من بُصاقِهِم الممزوج بالغرام والوئام والسلام وحُبّ جميع الأنام.
بَدَت على القاضي علامات الانبهار، واِبتسَم لراضي معلنًا بذلك أنّه راضٍ عنه.. ومسك هاتفًا محمولًا من الطراز القديم، وطَلبَ رقمًا:
يا فاتِح، أعِد الأدوات إلى مكانها، واصرِف الشباب إلى مقارِهِم.. تمّ إلغاء أمر الإعدام، فالمتهم بريء.
ومنذ تلك الحادثة، أصبحت مساعدات أي دولةٍ مُتقدّمةٍ وغنيّةٍ لأيّ دولةٍ فقيرة ومتأخّرة ومُتخلّفة تُدعى: بَصْقَة. وبعدها بفترةٍ وجيزةٍ أصبح راضي رئيس تحرير صحيفة الحقيقة المُطْلَقَة، ثُمّ بعد سنة أصبح “وزيرًا لتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة”. ثم ما لبثَ أن تقلّد منصب مدير “صندوق البُصَاق الكوني”، ثمّ عُيّنَ سفيرًا لبلاد السَفَرجَل في بلد الواحات المُلتَحِمَة، وبقي في المنصب حتى اندلَعَت احتجاجاتٌ على رفع أسعار الفَلافِل، وتراجعت العلاقات بقوّةٍ بين البلدين “الصديقين”، بتراجع مُعدّلات الانتفاخ والضُّراط. فانشقَّ راضي وفرَّ من بلاده، ليتحوَّل إلى عُضوٍ في أحد أحزاب المعارضة الخارجية، وكتب روايةً عن “تجربته النِضالية الثورية” و”محنته الطويلة والمريرة” في سجون بلاد السَفَرجَل وكيف أصبحَ من أبرَز “مُعارضي المنفى” الراديكاليين، عنوانها: كيف تعلّمت أنْ أُحبَّ البَصْقَة.
-
مأساة ناتشو ڤارچا: هل الإرادة الحرّة.. حقًا حرّة؟


تدفَعُنا قصّة إِچناسيو “ناتشو” ڤارچا من مسلسل Better Call Saul، للتساؤل مُجدّدًا عن إرادة الإنسان وعن مقدار حريّة هذه الإرادة؛ إذ يبدو ڤارچا للوهلة الأولى حُرًا في كافة اختياراته، أو على الأقل في أوّل اختيار: التخلُّص من هِكتور سالامانكا. وقد نستنكر ما فعله بنفسه وبإرادته الكاملة، فنقول مثلًا: كان من الممكن أن لا يقتل هِكتور ويُوفّر على نفسه كل هذه المعاناة ولا يضطّر للتعامل مع چوستافو “چَس” فرينچ (التجسيد المثالي للنيوليبرالية ذات الوجهين: وجه إنساني مفرط في إنسانيّته، مبتسمٌ على الدوام، يحترم حقوق الجميع ويُحبُّ عمل الخير والإحسان. ووجهٌ سيكوباتي دموي، باردُ المشاعر، يشي بقلبٍ ميِّت لا يعرف الرحمة بل الإنتاجية والربح وسحق جميع الخصوم وكل من يشكّل عثرة في طريق إنجازه). أو ربما نظنّ أنّ ناتشو لا يُحسن الاختيار أو اتّخاذ قرارات عقلانية وبالتالي عليه أن يتحمّل مسؤولية أفعاله وأن يحصد ثمار ما زرعه بإرادته الحرّة.
صحيحٌ أنّ ڤارچا كان حُرًّا في مُمارسة فعل التخلّص من هِكتور، لكن هل أرادَ التخلّص منه بِحُريّة؟ وهل كان مُحرَّرًا من قيود كل الظروف المُسبقَة التي لم يسعى للمرور بها بإرادته الحرّة وأوصلته إلى محطّة اتّخاذ هذا القرار الذي شنَّ انقلابًا على توازن حياته؟
لقد كان يملك إرادة الفعل، لا جدال في ذلك؛ لكن هذه الإرادة ليست حرّة أبدًا! وصحيحٌ أنَّ أحدًا لم يُجبره بشكلٍ مباشر على محاولة قتل الدون هِكتور سلامانكا، لكن إرادته تم التلاعب بها من قبل الظروف التي وُضِعَ بها صاحب الإرادة ومن قبل الأشخاص الذين أجبروه -بشكلٍ غير مباشر- على اتّخاذ هذا الفعل بإرادته منزوعة الحريّة (مثل تهديده بقتل والده الذي كان كل شيءٍ بالنسبة له وواهبًا للمعنى ومانحًا للغائية).
ربما القرار الوحيد الذي قامَ باتّخاذه بإرادةٍ حرّة كان إنهاء حياته بيديه، أن يَختم هذا الوجود وتلك الرحلة المأساوية ببسالة على طريقة “هارا كيري” حيث يُنهي مقاتل الساموراي حياته بيديه، تجنّبًا للموت على يد العدوّ، لكن ڤارچا استخدم مُسدّسًا عوضًا عن السيف. حتّى هذا القرار ليس حُرًا تمامًا؛ فقد قادته إليه كل الظروف السابقة عليه، كل ما تورّط به وحقيقة أنّه أصبح في قبضة أعدائه وسيموت بأكثر الطرق ساديةً على أيديهم. لكنّ الموت بذاته لم يعد قضيّته، إنّما أنْ يكون هذا الموت نهايةً تليقُ برجل شجاع.. وقد كانت كذلك!
الشيء نفسه ينطبق على مايك، الذي تشكّلت بينه وبين ناتشو علاقة أبٍ وابن. قد نتساءل: ما الذي يفعله هذا العجوز؟ لماذا ما زال مُستمرًا وهو الذي لم يترك أحدًا في عالم ألباكركي إلّا وقتله وكأنّ فعل القتل بالنسبة له كتناول الفتسق إلى جانب البيرة؟! ما الذي يُجبره على التورُّط مع شخصٍ خطيرٍ مثل فرينچ وتحمّل تبعات العمل معه وقد كان بإمكانه أن يرتاح ويحيا بسلام في خريف عمره أو أن يعمل باستقلالية ويعيش على مهمّاتٍ خفيفة ومدرّة للمال هُنا وهُناك. لكن السلام لم يكن يومًا خيارًا لمايك -كما يقول ماچنيتو في فيلم رجال إكس: الدرجة الأولى (2011)-! ثم مجدّدًا: لم تكن إرادة مايك حُرّة، كل فعلٍ قام به دفعته إليه مجموعة ظروف من الماضي حينَ كان شرطيًا أو بسبب مقتل ابنه الشرطي، أو ربما ظرفٌ واحد: وجود حفيدته الوحيدة، وعن هذا الظرف تولّدت غاية عُليا وهدفٌ سامٍ، باتَ مايك يفعل كل شيء من أجله: حمايتها وتأمين مستقبلها.
بين ناتشو ڤارچا وعبد الله بن الزبير
في النهاية، سأقفُ عند نهاية الرجل الشجاع أو للدقّة ما بعد هذه النهاية، حينَ يجرّ التوأم سالامانكا الكرسي المتحرّك لعمّهما هِكتور باتجاه جثّة ڤارچا -المفارقة أن هِكتور نفسه غدا جثّة حيّة- ليُطلق النار صوبها بشكلٍ هستيري، كنوعٍ من التعويض عن حرمانه من الظفر بلذّة التنكيل بصاحب الجثّة حيًا. تُذكِّر هذه النهاية بإحدى قصص التاريخ الإسلامي، حيث كان هناك رجل شجاع آخر هو عبد الله بن الزبير في مواجهة الحجاج بن يوسف الثقفي ومن خلفه سلطة الحُكم الأموي ودعايته السياسية وأسلحته الفتّاكة. وبحسب ما يَرويه المؤرّخ المصري الراحل أحمد زكي صفوَت، في كتابه “جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة”، فإنّ ابن الزبير وفي آخرِ ساعات قتاله ضد الأمويين، خافَ أن يقتلوه ثم يُمثّلوا به -وفعلًا فعلوا ذلك!-، فردّت عليه أمّه أسماء بنت أبي بكر: “يا بُني إنّ الشاة لا يَضرُّها سَلخُها بعد ذَبحِها!”.
تجنّبًا للسقوط في فِخاخ المثاليات وشِراك الأفكار الرومانسية، لن نقول إن عبد الله بن الزبير قد “انتصر بموته” ولا ناتشو ڤارچا أيضًا. لكن في حالة الأخير، ثمّة خسارة بالضرورة للآخر/العدو، لآل سالامانكا، ممثّلة في عدم تذوّق طعم الانتقام لكبيرهم هِكتور، في حرمانهم من إيذاء خصمهم والتنكيل به وقد كانوا يسعون إلى ذلك ويقومون به باحترافية وبكل سعادة! وفي تاريخٍ بديل (Alternative history) هناك نسخةٌ من ابن الزبير، ولن نكون حالمين فنُبالغ ونقول إنّها انتصرت، لكنها قَضَت نَحبَهَا على يدها وبإرادتها اختارت نهايتها ببسالة على طريقة يوكيو ميشيما، حينَ أدركت أن البديل الوحيد هو السقوط في يد الأعداء وجعلهم سعداء. أما التمثيل والسلخ بعد الذبح وكل ما يأتي بعد النهاية، فليس أمرًا ذا شأن.
-
لعبة الحبّار: جزيرة الديستوبيا غير المتعارضة مع قارة الواقع


في كتابه “المُصطنَع والاصطناع”، يرى الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي جان بودريار أنّ الغرض من “ديزني لاند” هو إخفاء حقيقة أنّ البلد “الواقعي” كل أميركا “الواقعية” هي ديزني لاند، كما تخفي السجون حقيقة أنّ الاجتماعي بكامله، وفي كليّة وجوده التافه هو المسجون. من هذه الزاوية البودرياريّة يمكن قول شيءٍ مشابه عن “لعبة الحبّار”؛ أنّ هذه اللعبة المُميتة، تُخفي -ربما بشكلٍ غير واعٍ- حقيقة أنّ العالم كلّه وليس كوريا الجنوبيّة فقط، لعبة خاضعة لقوانين داروينية اجتماعية، يتصارع فيها البشر من أجل البقاء في ظروفٍ غير إنسانيّة من صناعة الإنسان، أو حتّى في الكوارث التي تصنعها الطبيعة أو “خالق الإنسان”، أو حين يلعبون من أجل الربح بإرادتهم أو هكذا يبدو ظاهريًا، لكنّها إرادة الظروف التي تُكرههم على اللعب ويُخفي خالق/خالقو تلك الظروف حقيقة ذلك، معلنين أنّه “لا إكراه في اللعب”، ليخرج في النهاية رابح واحد، حافَظ على بقائِه لأنّه “الأصلَح”. لكن هل كان الباقي في لعبة الحبّار “الأصلَح” حقًا؟
عن العنف اليومي ضد الآخر والذات
يَغصّ المسلسل الذي كتبه وأخرجه الكوري الجنوبي هوانچ دونچ هيوك وتعرضه شبكة نتفليكس، بالجثث ويغرق بالدماء وتسوده لغة موحّدة يتحدّثها العالم على اختلاف ألسنته: العنف. ومع ذلك لا يبدو كل هذا الكوكتيل الوحشي صادمًا بعنف؛ ليس فقط لأنّنا رأينا درجاتٍ أعلى من الوحشيّة في أعمالٍ سينمائية وتلفزيونية سابقة، بل لأنّ هذا العنف يُمارَس على البشر في الحروب والاستعمارات المباشرة وغير المباشرة والديكتاتوريات و”الإرهاب” وحروب العصابات، ونمارس شكلًا من أشكاله في حياتنا اليومية، في الشركات مثلًا!
صحيح أنّ النيران لا تُطلق على الموظّفين في الشركات ولا يُعاقبون على تأخيرهم وتقصيرهم بالقتل ولا يقوم الموظّفون بتصفية بعضهم جسديًا، لكنّ “عنفاً رمزيًا” يُمارَس عليهم من خلال فرض نظام للمراقبة والمعاقبة واستباحة وقتهم وانتهاك حقّهم في حياةٍ أُخرى غير حياة العمل، في سبيل المصلحة العُليا “الإنتاجية” أو من أجل حفنة أوهام مثل “تحقيق الذات”، أو حين يلعب زملاء العمل ألعابًا تأخذ شكلًا مُخفّفًا من الداروينية الاجتماعية، فيقومون بتصفية بعضهم مهنيًا -بوسائل غير مهنية إطلاقًا- من أجل الحصول على “الترقية” أو زيادة الراتب أو للوصول إلى “جائزة كبرى” في النهاية أو ببساطة تجنّبًا للطرد (الإقصاء).
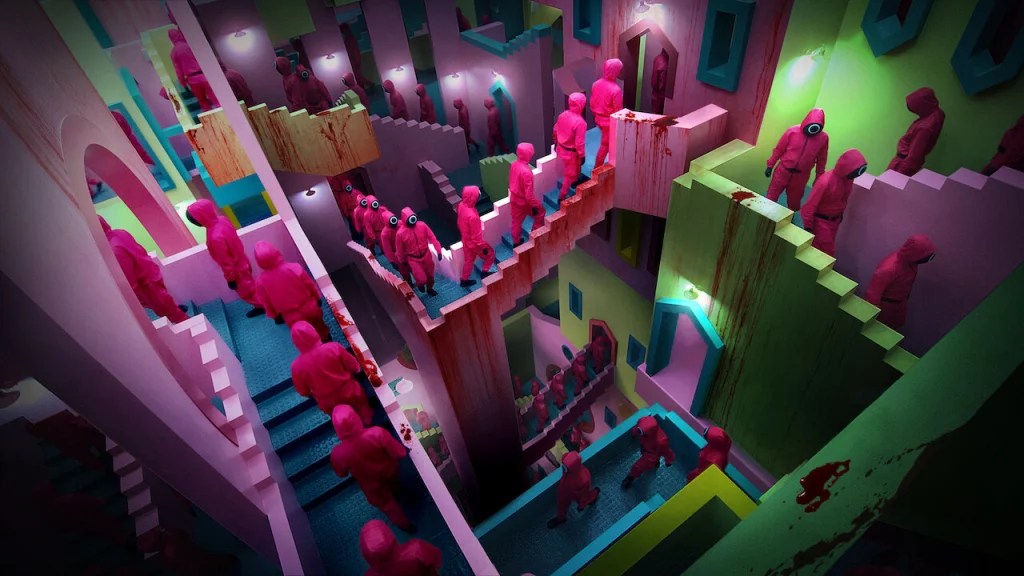
ولا يُمارَس هذا العنف في الواقع ضدّ الآخر فحسب، بل أيضًا ضدّ الذات؛ على صورة امتهانٍ لها لغاية الوصول إلى جائزة/جوائز كُبرى تأتي على شكل أرقامٍ كبيرة في خانة الإعجابات والمتابعات والمشاهدات ثم في خانة الرصيد البنكي وفي خانة “الأنا” المتخضّمة. هل أبالغ هُنا؟ حسنًا، فكّر جيدًا، أليس الرقص والقفز والقيام بكثيرٍ من الأشياء اللامعقولة أو التي يُفترض أن تقوم بها في سياقاتٍ محدّدة وأمام أشخاصٍ معيّنين، وتسليع الجسد و”فيتشيَّته” ووضعه في واجهة العرض الإنترنتية لغايات الفُرجة والشراء -كما يحدث في انستچرام وتيك توك مثلًا لا حصرًا- فيه نوعٌ من امتهان النفس وإذلال الذات من أجل الوصول لهذه الجائزة/الجوائز الكبرى؟ صحيحٌ أنّ ممارسي هذا الامتهان ضد الذات لا يسفكون دمهم ولا يبترون أعضاءهم أو يطلقون النار على أنفسهم، لكن الفكرة في أنّ المرء يمكن أن لا يعرف حدودًا لامتهان نفسه وإذلالها من أجل الحصول على جائزة، وأنّه مستعدٌ لسلوك طريق مُهين -لكن مُختصر- إلى بوابات فردوس الثروة، كما فعل متنافسو “لعبة الحبّار”.ب
براءة الصغار تتدنّس بقذارة الكبار
ومع ذلك، وبالرغم من أنّ العنف موجودٌ في الواقع، بل باتَ اليوم هو الواقع ذاته، ولأنّنا -كما أسلفت- سبق لنا رؤية أشكال مشابهة وأكثر جنونًا من هذا العنف في أفلام يبدو “لعبة الحبّار” متأثّرًا بها. بالرغم من هذا كلّه، ثمّة رعبٌ يجثم على الصدور، ليس فقط لأنّ القتل هُنا يتميّز بالسهولة والسيولة، بل لأنّه يحدث في سياق ألعاب أطفال، حيث تتدنّس براءة الصغار بقذارة الكبار وتتلوّث بالدماء الممتزجة بالأسى لعبةٌ يلعبها الأطفال في حاراتهم -مثل الكرات الزجاجية أو الچلول- عندما يقتل الفائز فيها شخصًا عزيزًا عليه أو يضطّر لغدر شخصٍ كان حليفًا له ليحافظ على بقائه ويتقدّم خطوة في مسيره نحو نقطة النهاية حيث تنتظره الجائزة الكبرى.
وطريقة التصفية هذه لا تُثير الهلع فحسب، بل تبعث على التشاؤم والاكتئاب والإحباط؛ إذ تؤكّد أنّه لا مكان للصغار ولا قيمة للبراءة في هذه الشركة الكونيّة أو السوق الضخمة التي نعيش بها وإن لم نستطع مقاومة هذا “الشر السائل” المتربّص بالجميع، فعلينا أن نصير جزءًا منه ونلعب لعبته ونحنُ مصابون بـ“العمى الأخلاقي” بحسب تعبير عالم الاجتماع البولندي زيچمونت باومان.

قلعة الحصن مكتظّة بالجثّث وغارقة بالدم
على سيرة الطفولة، تُذكّر ألعاب هذا المسلسل ببرنامج المسابقات الياباني “قلعة الحصن” (Takeshi’s Castle) الذي أنتِج عام 1986 وكان يُعرَض على المحطّات الأرضيّة العربيّة في تسعينيّات القرن الماضي. في الحصن ثمّة فريقان: مدافعون ومُهاجمون وهذا الفريق الأخير هُو بطلنا الذي يقتحم الحصن المنيع ويلعب ألعابًا يُواجه فيها فريق المدافعين، ويتم إقصاء قسم كبير من أعضائه، لتصل منهم مجموعة حافظت على بقائها إلى المعركة النهائية ضد المدافعين، وإن فازوا فسيربحون مليون ين ياباني. في مسابقات “لعبة الحبّار” المتسابقون هم المدافعون والمُهاجمون؛ يُدافع كل واحدٍ منهم عن حياته ويُهاجِم الآخر لإقصائه من اللعبة. أما الفريق المسيطر على حصن ألعاب الحبّار -أي الجزيرة- فلا يُدافع أو يُهاجِم، بل يُبرمِج كل شيء؛ يُبرمِج جنوده/حرسه -سأسمّيهم “الستورم تروبرز الورديين”- على تنفيذ الأوامر، ويُبرمِج ألعابه والنزاعات بين المتسابقين ونفسياتهم وعقولهم ليقوموا بأفعالٍ محدّدة في محاولتهم تجنّب الموت.
في “الحصن” نعرف خصم أبطالنا جيّدًا، ونفهم أنّه يدافع عن الحصن ضد المهاجمين ونميّز جيّدًا بين الطرفين المتنافسين، وفي النهاية تنشب معركةٌ بينهما على الطريقة التقليدية، ببساطة ثمّة وضوحٌ وصلابة في منافسات الحصن. أما في “الحبّار” الأمر مختلف! حتّى بعد تعرّفنا على “صانِع/خالق اللعبة” ومهندس هذا العالم الديستوبي الوحشي، لا يزال الأمر مفتقدًا إلى الوضوح وغارقًا في سيولة الشر، ولا يبدو الصانع هو الشخص الذي وراء كل شيء، فالأمر تجاوزه وأصبح من يملك زمام الأمور ويتحكّم في اللعبة هي إرادة غامضة تُبرمِج وتراقِب وتُعاقِب وتتلاعب في كل شيء وتملك آلات قتلٍ مبرمجة لتنفيذ الأوامر بدون تفكير وبتجرّد من أيّ عاطفة. وهي إرادة عمياء أخلاقيًا؛ إذ لا ترحم كل من لا يتلزم في لعبتها أو يخرج عن نصّها أو يفسد عدالة داروينيّتها الاجتماعية. أليس في هذه الجزيرة ولعبتها والإرادة الغامضة التي تقف وراءها محاكاة للدولة الحديثة أو نموذج مصغّر عنها؟!

مُتعة السادي وفوضويّة السُلطوي
في الحلقة التي تظهر فيها الشخصيات المهمّة، نظنّ بأنّ جزءًا من هذا الغموض الذي يكتنف صانعي اللعبة سينجلي، لكن طبقة غُبار الغموض والإبهام يتضاعف سُمكُها! لا نعرف شيئًا عن هذا النخبة التي ترتدي أقنعةً على أشكال حيوانات وتعطي انطباعًا بأنّ أعضاءها ينتمون لنوع من الطائفة الطقوسية أو الجماعة السريّة. وجه أحدهم يسقط عنه القناع، لنرى خلفه عجوزًا أبيضًا سمينًا مؤخّرته مترهّلة وفقط. ولا يبدو أنّها نخبة متعدّدة عرقيًا وقوميًا، وغالبًا كلّهم من أصحاب البشرة البيضاء كما تُخبر لهجاتهم ولكناتهم. ربّما هم رؤساء دول، أو من أيقونات “الرأسمالية الملساء الناعمة” أو “الشيوعيين الليبراليين” كما يسمّيهم سلاڤوي جيجيك، من أمثال “المحسن الأكبر في تاريخ البشرية” -الوصف لجيجيك أيضًا- بيل غيتس!
أو ربّما أعضاء هذه النخبة، هُم مجرّد أثرياء، يستثمرون في آلام ومآسي الآخرين أو يتّخذونها وسيلةً للتسلية ولا ضرر في جني بعض الأرباح بالمقامرة على الفائز في هذه المسرحية المأساوية -بالنسبة لكلّ الذين ماتوا وسيموتون فيها- والممتعة بالنسبة لهم؛ فكما يرى الناقد والمنظّر البريطاني تيري إيچلتون في كتابه “الإرهاب المقدّس”، فإنّ مشاهدي المسرحية يشعرون بأنّهم غير مُهدَّدين، ممّا يُتيح لهم أن يجنوا المتعة عبر استمداد الحياة من سقوط الآخرين، فيُشبعون دافع تدميرهم الذاتي من خلال الآخر البديل بالانغماس في متعةٍ ساديةٍ معيّنة بالتفرّج على آلام الآخرين.
يُحيلنا هؤلاء الأشخاص المهمّون الذين يدخّنون السيجار الكوبي ويشربون السكوتش في فردوسهم الأرضي المصطنع على الجزيرة، إلى “سالو” الإيطالي بيير باولو بازوليني؛ إذ يُذكّرون بالفاشيين الأربعة (الدوق، الرئيس، الأسقف، القاضي). صحيح أن فاشيي “سالو” لم يكتفوا بالتفرّج على آلام الآخرين، بل تسبّبوا بها على نحوٍ مُريع ومقزِّز، إلّا أنّهم يتشاركون في صفاتٍ كثيرة؛ مثلًا: الحديث عن الشعر والفلسفة أثناء انغماسهم في مُتَعِهِم السادية، أو التفرّج على سقوط الآخرين من خلال مناظير المسرح.

أيًا كانت حقيقة هذه النخبة وهويّة أعضائها، ليس بالأمر المهم، فلن يذهب تأثير الإحباط الذي تُسبّبه حقيقة أنّ هذه الشخصيات هي الوحيدة الحُرّة في هذا العالم “الحُر”، حيث تُفسِدُ وتٌعربِد وتمارِس إرهابها دون أن يستطيع أحد إيقافها! فلا قوّة -حتى الآن- قادرة على الوقوف والصمود في وجه “فوضوية السلطة”، وقد يبدو هذا المصطلح الأخير متناقضًا، لكنّ “لا شيء فوضوي مثل السلطة، فالسلطة تفعل ما تشتهي” كما يقول بازوليني نفسه، وكما جاء على لسان الدوق في “سالو”: “نحنُ الفاشيون، الفوضويون الوحيدون الحقيقيون، والفوضويّة الوحيدة الحقّة هي فوضويّة السُلطة!”. ربما الأمل الوحيد في كارثة تقضي على الجميع ولا يستطيع هؤلاء المُتنفّذون أن يهربوا منها ولو كانوا في بروجٍ مشيّدة، أو في تدخلٍ إلهي؛ فالله في أحيانه الملهمة هو الذي يقضي على هذا الرعب، كما يقول بودريار بتصرّف.
قائد أم واجهة؟
حتّى الحلقة الثامنة لا نعرف شيئًا عن هويّة “القائد”، الذي يمتلك كاريزما قويّة تكفي لأن نعتقد بأنّه وراء هذه اللعبة ومهندسها الأول وصانع هذه الجزيرة الديستوبية. لكن يتضح في هذه الحلقة أنّ الأمر ليس كذلك! يتحوّل من قائدٍ له الأمر كلّه إلى واجهةٍ لهذه الدولة التي تقبع داخل دولة -أو هذه الشركة التي تقع داخل شركة (الدولة نفسها) داخل شركة (العالم نفسه)- ويبدو وسيطًا بين صانع اللعبة الأوّل والشخصيات المتنفّذة ومُلبّيًا لرغباتهم. أو يمكن النظر إليه كقائدٍ لكن ليس لكي شيء، بل فقط لأجهزة الدولة القمعية والأيديولوجية -حسب توصيف الفيلسوف الفرنسي لويس ألتوسير-؛ فهو من جهة مسؤولٌ عن احتكار القوّة والعنف لهذه الجزيرة (الدولة)، ومن جهة هو المسؤول عن الأجهزة التي تنتج ثقافة الطبقة المُهيمِنَة وتنشرها بين اللاعبين (الطبقة المُهيمَن عليها).

ألا يذكّر القائد بشخصية الشرير “دكتور دوم” (Doctor Doom) في قصص مارڤل المصوّرة؟ هذا الالتباس في حقيقة دور القائد، يدفع إلى التساؤل: هل قادة العالم فعلًا قادة حقيقيون؟ أم مجرّد رجالٍ يُوضعون في الواجهة والقادة الحقيقيون مثل “صانع اللعبة” لا نعرف شيئًا عنهم ويُفضّلون أن يبقوا في الخفاء، ليكتبوا ويُخرجوا الكوابيس من خلف الكواليس؟!
حتى الموت له علامة تجارية

“الجهاز الإعلاني للموت” والمسوّق لعلامته التجارية في أوّل حلقة يظهر شخصٌ ثم يختفي ليعود في نهاية الحلقة الأخيرة، إنّه ذلك الشاب حسن المظهر وصاحب الابتسامة الجميلة/ المسؤول عن تجنيد اللاعبين أو رجل التسويق الخاص باللعبة الذي يصطاد بصنّارة شهوة الثروة والخلاص من الديون والانعتاق من الفقر المُحتاجين، ليأخذهم -برضاهم بعد وقوعهم في شباك الإغواء- إلى الجزيرة حيث سيكونون أسماكًا تُلتهَم وتَلتهِم بعضها. هذا الرجل الذي يتمتّع بطلاوة اللسان وحسن البيان ويمارس على اللاعبين سحرَ الإقناع هو بمثابة “الجهاز الإعلاني للموت” والمسوّق لعلامته التجارية؛ ففي ملكوت رأس المال كل شيءٍ يحظى بعلامة تجارية ويتم تسليعه أو تحويله لمساحة إعلانية، حتّى الموت نفسه. إنّ هذا الشاب الذي يُمكن اعتباره رمزًا لقسم الموارد البشرية في الشركات، هو ملاك الموت الخاص برأس المال الذي يخنق مرتديًا قفازاتٍ ناعمة ويحصد الأرواح بمنجلِه مع ابتسامة. وحتّى الأشياء التي تُقدّم للاعبين مثل وجبات الطعام والشراب التي توزّع بكمياتٍ شحيحة وبجودةٍ رديئة وتنشب من أجلها صراعات لمحدوديّتها كما في السجون تمامًا، تأتي بعلامة تجارية، بشعار لعبة الحبار: الدائرة والمثلّث والمربّع.. أو أزرار البلاي ستيشن!
اللعبة الأخيرة (456 ضد 1): رهانٌ على فساد الطبيعة البشرية
وأخيرًا يتجلّى الخالق على هيئة رجلٍ عجوز، كان موجودًا منذ البدء بين اللاعبين، وكان الأوّل ورقمه 1! سيناريو يعيد إلى الأذهان الجزء الأوّل والأجمل من سلسلة أفلام Saw، حيث كان صانع الألعاب موجودًا طيلة الوقت على هيئة جثّة رجلٍ ميّت. الإله كان ميّتًا ثم قام في Saw ليصطفي أحد رابحي اللعبة الذي رأى أنّه الأصلَح ليُكمل من بعده ألعابه، ولا نعرف تمامًا أنّه جعله في أرض ألعابه خليفةً إلّا بعد سبعة أجزاء. وصانع ألعاب الحبّار، في اللحظات الأخيرة التي سبقت تحوّله إلى إلهٍ ميّت، يلعب مع الرابح في اللعبة سيونچ چي هون أو اللاعب رقم 456، لعبةً أخيرة: رهانٌ على فساد الطبيعة البشرية! الخالق العجوز معادٍ للإنسانية، كارهٌ للبشر ومؤمنٌ بأنّ الفساد متأصّلٌ فيهم والشر جزء لا يتجزّأ من طبيعتهم، حيث يذكّرنا مقته للبشر برفض الشيطان لخلق الله للإنسان وبردّ الملائكة على الله حينَ قرّر أن يجعل في الأرض خليفة! أما سيونچ چي هون أبسط من ذلك، ليس فيلسوفًا ولا حكيمًا ولا عارفًا، لكنّه لم يفقد “الإيمان” حتى بعد كل ما مرّ فيه، فيُراهن على أنّ هناك فُسحة من الأمل وأنّ فساد البشر ليسَ حتميًا وأنّ هناك عالماً آخرًا ممكنًا ومستقبلًا أفضل، ويكسب رهانه ولا يشهد العجوز خسارته.. إذ يُصبح إلهًا ميتًا!

هل بقيَ الأصلَح في النهاية؟
لقد نجى چي هون وربح اللعبة وكسب الجائزة الكبرى، وبناءً على ذلك كان هو “الأصلَح”، لكن هل كان كذلك حقًا؟ ألم تتدخّل “يدٌ إلهيّة” منذ البدء لاستدراجه للعودة إلى اللعبة؟ أم يكن الحظّ في كثيرٍ من المرّات حليفه؟ ألا يتناقض العمل الجماعي في اللعبة الأولى -حينَ ساعده المهاجر الباكستاني علي- وفي لعبة شدّ الحبل الذي نظّمتها هذه اليد الإلهية -العجوز صانع اللعبة- مع أساليب “الأصلَح” للحفاظ على بقائه؟
ربما بمعايير السوق ومنافسته ومزاحمته وتسليعه وترقيمه، لم يكن “456” هو الأصلَح أبدًا، لكنّه بمعايير لا يأبه بها رأس المال مثل التعاضد والتكافل والإحساس بالآخرين والتعاطف معهم، كان الأصلَح حقًا وكانت هذه الصفات مهمّة لكي يبقى چي هون على قيد الحياة ويبقى فيه شيءٌ من الإنسان في عالمٍ يحتضر فيه الإنساني والاجتماعي لصالح الآلاتي والأداتي. أو ربمّا الأمر مقرّرٌ ومكتوبٌ منذ البدء، والعجوز هو “الرب” الذي قرّر كل شيء سلفًا في لوحه المحفوظ فاختار واصطفى هذا “الابن المُخلَص”، لكنّه فعل ذلك بسبب هذه الصفات تحديدًا!

هامش:
عنوان المقالة في الأصل هو جملة لجان بودريار من كتابه “المصطنع والاصطناع” وقد تمّ التصرّف بها بشكلٍ طفيف، والجملة الأصلية: “جزيرة الطوبى المتعارضة مع قارة الواقع”.
– مصادر:
• المصطنع والاصطناع – جان بودريار، ترجمة جوزيف عبد الله، المنظّمة العربية للترجمة.
• الشر السائل – زيچمونت باومان وليونيداس دونسكيس، ترجمة حجاج أبو جبر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر.
• العنف: تأملات في وجوهه الستّة – سلاڤوي جيجيك، ترجمة فاضل جتكر، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
• الإرهاب المقدّس- تيري إيچلتون، ترجمة أسامة إسبر، خطوط وظلال للنشر والتوزيع.
• الأيديولوجيا والأجهزة الأيديولوجية للدولة – لويس ألتوسير، ترجمة عايدة لطفي.– أفلام يبدو المسلسل متأثّرًا بها:
• Saw (2004)
• Death Race 2000 (1975)
• Salo, or the 120 Days of Sodom (1975)
• THX 1138 (1971)
• Soylent Green (1973)
• The Hunger Games (2012)
• Equilibrium (2002)
• The Island (2005)
-
اشترك
مشترك
ألديك حساب ووردبريس.كوم؟ تسجيل الدخول الآن.