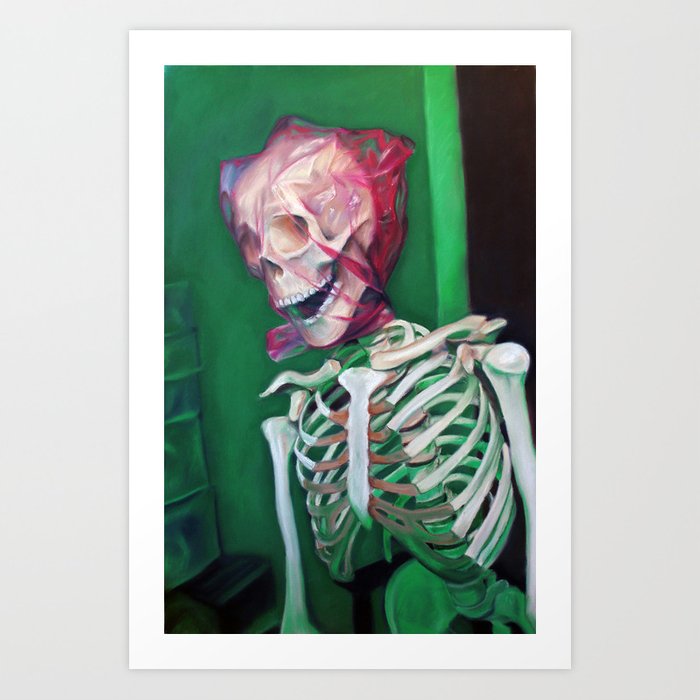
استقيظتُ وأنا أتنفَّس بمعاناةِ من تدحرجَت على صدرِه صخرة سيزيڤ شخصيًا. فَتحتُ تحقيقًا عاجلًا: المُتّهم الأوّل كان القلب؛ لأنّ أمراضه متوافِرة بأسواق جينات عائلتي بكثرة ممّا يسمح بتصديرها لجينات العائلات الأخرى، يُضاف إلى ذلك أنَّ قلبي أسودٌ متفحّمٌ من شدّة إدمان الحقد الطبقيّ ومَقْت الجنس البشريّ والاحتقار الذاتيّ. ثم قُلت: لا.. لا، غالبًا المتورّط الحقيقي في كل هذا، هو جهازي التنفّسي وربما بسبب التخبُّط المُزمِن في الأولويات عندي، صرتُ أتنفّس من الفتحات الخطأ! أو لعلّ المشتبه به الذي أبحثُ عنه هو القلق، صديقي القديم ليس سواه؛ إذ يبدو أنَّ ميوله الساديّة تعاظَمَت بالتزامن مع الديستوبيا الجميلة التي نعيش فيها بأمنٍ وطمأنينة، ورخاءٍ أو خراءٍ أو ارتخاءٍ -لا أستطيع التحديد!- فأخذَ يتلذّذ بتعذيب ما تبقّى من أعصابٍ مُنهَكَة وأنفاسٍ متعَبَة.
وليطمئنّ قلبي نسبيًا، بادرتُ إلى التواصل مع أحد جيراني ويعملُ طبيبًا، لكي أشرح له الحالة فيُشخّصها ويعطيني علاجًا أو يقولَ لي: “ستموت وتستريح”.. لكنّي ألغيتُ المبادرة حينَ نظرتُ حولي وضحكتُ متهكّمًا على ذاكرتي الضعيفة؛ إذ نسيت أنّي أعيش في قبر، فاستلقيتُ على بطني واسترخيت وأخذتُ نَفَسَ حريّة عميق في قبري! ولأنّي كنت قدوةً لجيراني في المقبرة الكبيرة ونموذجًا للجار المقبور المثاليّ، أخذوا جميعًا بتقليدي وتنفّس الحريّة بعمق داخل قبورهم.